كوميديا السيد حافظ
بين سخرية اللاوعي والانتقاد الاجتماعي
دراسة بقلم:
أحمد محمد الشريف
(نشرت هذه الدراسة في مجلة المسرح- عدد نوفمبر 2024)
لطالما كانت الكوميديا وسيلة قوية للتعبير عن الذات والمجتمع، فهي لا تقتصر على إضحاك الجمهور بل تتعدى ذلك لتصل إلى أعماق الوجدان وتثير التفكير. وقد استطاع العديد من الكتاب المسرحيين استغلال هذه القوة للتعبير عن آرائهم وانتقاداتهم بطريقة مبتكرة ومؤثرة. ومن بين هؤلاء الكتاب برز "السيد حافظ" الذي استطاع أن يحفر لنفسه مكانة خاصة في عالم الكوميديا العربية. فبعد تجربة ناجحة في المسرح التجريبي، اتجه حافظ إلى الكوميديا، مستغلاً أدواتها للتعبير عن هموم ومشكلات المجتمع المصري بطريقة ساخرة ومباشرة, فمن خلال الضحك والسخرية، تمكن الكاتب من إيصال رسائله النقدية والاجتماعية إلى الجمهور بطريقة أكثر فعالية. فالكوميديا في مسرحيات "السيد حافظ" ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي أداة للتفكير والتأمل.
إن دخول "السيد حافظ" عالم الكوميديا في المسرح لم يكن جديدا عليه. فقد كتب كوميديته الأولى "حكاية الفلاح عبد المطيع" بعد فترة البدايات مباشرة في مرحلة النضوج الفني والفكري, متخذا لونا من الكتابة يقف في جزيرة وسطية بين الكوميديا السوداء وبين الاستلهام من التراث وبين التجريب في الشكل المسرحي. ووضع كل هذا في النهاية في بوتقة المسرح السياسي وبمعنى أصح إن مسرحية "حكاية الفلاح عبد المطيع" تنتمي إلى المسرح التحريضي. وقد صنع فيها "السيد حافظ" الكوميديا من المفارقة المأساوية التي تحدث للمواطن الفقير المغلوب على أمره نتيجة ظلم الحاكم وبالتالي تنتمي الكوميديا هنا إلى الكوميديا السوداء. وهي عادة ليس الغرض منها الإضحاك وإنما تعتمد على السخرية والتهكم سواء من الذات أو من الوضع القائم أو من أحداث جارية أو من سلطة أعلى وذلك بغرض الانتقاد وتصحيح الوضع والوصول إلى مرتبة أو درجة أعلى لتحقيق العدل أو ضبط سلوك الشخصية المستهدفة أو تحقيق التوازن النفسي للشخص المتهكم بالتنفيس عن الكبت والقهر الذي يواجهه حتى لو لم يؤدي إلى نتيجة إيجابية فعلية.
وسوف نستعرض هنا بعض السمات والملامح العامة للمسرحيات الكوميدية لدى "السيد حافظ" من حيث أولا انتمائها للكوميديا السوداء, وتناول الشخصيات ثانيا, ثم اللغة الحوارية المستخدمة, وأخيرا توظيف التراث والأحداث التاريخية.
انتهج "السيد حافظ" النهج المأسوي في الكوميديا في عدة أعمال بداية بـ "حكاية الفلاح عبد المطيع" مرورا بمسرحيات "وسام من الرئيس", و"ملك الزبالة", و"حرب الملوخية" وغيرهم. والكوميديا السوداء هيّ نوع من الكوميديا والهجاء، مواضيعها غالبا هي مواضيع محرم الخوض فيها، ويتم تناولها بشكل فكاهي أو ساخر مع الجدية في الموضوع. ومواضيع الكوميديا السوداء تتضمن مواضيع الموت, والانتحار, والحرب, والإرهاب, والعنف, والجريمة, والمخدرات, والخيانة الزوجية, والجنون, والعنصرية, والقهر المجتمعي, وبطش الحكام, والديكتاتورية، إضافة إلى الجنس وما شابه. فكلها مواضيع جادة قاتمة، ويعتمد كتاب السيناريو على أن يجعلوا هناك كوميديا في الموضوع ولكن من خلال الألم، بمعني أنها تعتمد على الشيء الذي يؤلمك وتدفعك للضحك، لذلك فهي كوميديا ليست بالسهلة وتحتاج إلى خبرة كبيرة في الكتابة وثقافة عالية ووعي تام بقضايا الوطن والقضايا الجادة الشائكة إضافة إلى التمتع بروح التهكم والسخرية.
ففي مسرحية "حكاية الفلاح عبد المطيع" تناول "السيد حافظ" فكرة القهر والظلم وديكتاتورية الحاكم التي تكبل الشعب من خلال مفارقة ساخرة لعبد المطيع بطل المسرحية الذي يتم القبض عليه وسجنه ولأنه يرتدي اللون الأبيض دون أن يدرك أن الحاكم قنصوة الغوري قد أصدر فرمانا بمنع ارتداء أي شخص اللون الأبيض لأنه يعاني من مرض في عينيه ونصحه الأطباء بعدم رؤية اللون الأبيض حتى يشفى. فهنا يوضح الكاتب تسخير الحاكم الظالم كل مقدرات الوطن وإخضاع حياة كل المواطنين من أجل مصلحته الخاصة. وذلك من خلال مفارقة ساخرة تحدث لشخصية تتسم بالنقاء والطيبة وحتى تحدث تلك المفارقة كان لابد من إلصاق شيء من السذاجة لصنع الموقف الكوميدي. ثم يتكرر الموقف مرة أخرى حين تشفى عين السلطان ويحرم على المواطنين ارتداء اللون الأسود لكن عبد المطيع قد ارتداه مع عدم علمه بالفرمان ويقبض عليه مرة أخرى. فالمعنى يؤكد على تلاعب الحاكم بحياة المواطنين كما يشاء وممارسة التسلط دون مراعاة لظروفهم وأحوالهم. والكوميديا هنا قد نبعت من رحم الجدية بغرض النقد وتصحيح الأوضاع مع الإسقاط على العصر الحالي من خلال السخرية والتهكم التي وصلت إلى أقصاها عندما علم السلطان بحكاية عبد المطيع فيقرر تعيينه قاضي القضاة لكن عبد المطيع يرفض قائلا إنه يريد أن يكون من العراة ويضحكون بينما هو يبكى.
يذكر الناقد "عبد الله هاشم" أن "السيد حافظ" يقدم لنا شخصية عادية تمثل أغلبية - مقهورة مطيعة وموقفاً كوميديا من الدرجة الأولى ينطبق عليه ما ذكرناه سلفاً عن رسالة الكوميديا، ويتساءل هاشم هل لابد للكاتب الثوري الملتزم أن يقدم لنا شخصياته ثورية رافضه للواقع التي تعيشه وتموت في سبيل مبادئها؟! ويرى أن الفن هو الذى يحرك فينا كمشاهدين وقراء السؤال. وقد نجح "السيد حافظ" في إلقاء هذا السؤال، وعلينا نحن البحث عن إجابة وهى رسالة المسرح الجديد، والسيد يقدم شخصية عبد المطيع بكل سلبياتها وقهرها ولؤمها حتى يستطيع أن يدرك لنا أن نجيب أو نشاركه في سؤاله عن عبد المطيع ولماذا هو مطيع وعلينا نحن أن نشاركه في البحث عن إجابة.
تستمد كوميديا "السيد حافظ" روح السخرية من الأجزاء المأساوية، فتتعامل مع الجوانب السلبية للحياة بروح الفكاهة الصادمة وغير المتوقعة. وقد استطاعت الكوميديا التعبير عن الواقع الاجتماعي ، نقدا أو كشفا وفضحا له. وهي تتميز عادةً بالجرأة والفكاهة، وتركز بعض على كوميديا الموقف. وعن العوامل الدرامية المؤدية للكوميديا الساخرة في مسرحيات "السيد حافظ" يوضح د. كمال الدين عيد في حديثه عن مسرحية "ملك الزبالة" أن دراما "السيد حافظ" مليئة بعناصر المسرح الطبيعي من صراع، وقمامة، ورائحة فاسدة عفنة، طبعاً الى جانب العناصر الدرامية الأخرى، ويلاحظ سخرية "السيد حافظ" من الطبقة الحاكمة التي تمثل العسكر، شهبندر التجار، الأعيان، والأمراء، ولاحظ التسلسل الذى يلجأ اليه الكاتب. فهو ينبئ عن انحيازه الى جانب الغلابة وزبالي المسرحية. والجميل أن هذه السخرية هي مكمن الكوميديا. وهى على الصورة تصبح كوميديا نظيفة تماماً. نابعة من صراع كامن، ومستمر ومتصل بين طرفي النزاع الدرامي فى النص المسرحي الجميل.
أما د. مصطفى رمضاني فيتحدث عن الجروتسيك في مؤلفات "السيد حافظ" قائلا " أن من أبرز ما يميز كتابات "السيد حافظ" المسرحية، ولا سيما المتأخرة منها، حضور الغروتيسك، أو ما نسميه بالكوميديا السوداء. وأنه استعان بالنكتة والشيطنة والشطارية للتعبير عن المأساة في إطار يجعل البكاء ضحكا، والضحك بكاء. أولا يقول المثل الشعبي : "إن كثرة الهم تضحك"؟.
كذلك فعل "السيد حافظ" في كوميدياته السوداء. وهي كوميديات ذات وظيفة مزدوجة: بناء الوعي، وإمتاع الروح. فهي من جهة تساهم في بناء الوعي بقضايانا ومشاكلنا المأساوية. ومن جهة ثانية تمتعنا بما توفره الصياغة من مرح وخفة وترويح يجعل المتلقي يواجه المأساة بتفاؤل. ويوضح رمضاني أنه يعالج موضوعات تعكس قيما إنسانية كبرى مثل الحرية، والديمقراطية، والعدالة، وحرية التعبير وما إلى ذلك؛ فيتوسل بالسخرية والكوميك الصادم، وتتحول الشخصيات والأحداث مجرد أقنعة تخفي وراءها فظاعة الواقع وهشاشته".
فإذا كانت الكوميديا السوداء لدى "السيد حافظ" قد انتقدت في المقام الأول الأوضاع المجتمعية وعلى الأخص السياسية فنحن هنا أمام مسرح سياسي بالدرجة الأولى وهذا ما اعتاد على كتابته "السيد حافظ", بل إنه لم يترك نصا أيا كان لونه إلا وقد تناوله بمنظور سياسي حتى نصوص مسرح الطفل, فهو كاتب سياسي بالدرجة الأولى ومسرحه دائما مسرح سياسي. وهذا بالطبع لابد ان ينطبع على شخصياته الدرامية لاسيما شخصية البطل الذي يختلف في كل مسرحية عن الأخرى من حيث أبعاده النفسية والاجتماعية والفيزيقية, إلا أنه غالبا ما يتمتع بالروح الثورية ومن هنا نجد أن ابطال "السيد حافظ" في أغلب مسرحياته تجمعهم سمات موحدة بغض النظر عن اختلاف الأبعاد الثلاث الأساسية, سواء اكانت تلك الروح الثورية ذات فعل إيجابي أو سلبي, فقد يكون البطل ثوريا فاعلا إيجابيا يتجه دائما نحو المبادرة بالفعل ويحاول التغيير بقدر المستطاع ويتسم بالحيوية الفاعلة, في حين أنه أحيانا أخرى يكون سلبيا رغم الرفض والاعتراض بداخله إلا أنه عاجز عن الفعل وإحداث التغيير إما لنقص ما في شخصيته أو نتيجة للإحباط الذي يتملكه والنظرة التشاؤمية تجاه النتائج المرجوة من التغيير الذي لن يحدث أبدا من وجهة نظرة. وعلى هذا استخدم "السيد حافظ" تلك الروح الثورية في شخوصه لابتكار المواقف الكوميدية بإظهار التناقض بين الفعل والقول او بين الفعل ورد الفعل المواجه مما يبرز المفارقة المضحكة المنشودة.
يشير الدكتور كمال الدين عيد إلى أن شخصية 'فاضل' في مسرحية "وسام من الرئيس" للسيد حافظ هي تجسيد حي للفضيلة الضائعة في عالم مليء بالتناقضات. يستخدم "السيد حافظ" الحوار الساخر والمفارقات الدرامية لبناء شخصية فاضل، وكشف عن الصراعات الداخلية التي يعيشها الإنسان. وبذلك، يقدم "السيد حافظ" لنا شخصية معقدة ومتعددة الأبعاد، تعكس رؤيته الفنية للحياة والمجتمع.
يصف عبد الغني داود "فاضل" بأنه شخصية مرنة ومتعددة الأوجه، تجمع بين الكوميديا السوداء والمضحكة. فهو يتجاوز النمطية وتخلص من الأدوار النمطية التي تُحددها المظاهر الجسدية، ويستخدم الفكاهة كوسيلة للاحتجاج على واقع قاس وهو نموذجً للشخصية الكوميدية المعقدة التي تجمع بين الارتجال والتحليل الاجتماعي.
إن فاضل هو نموذج للإنسان البسيط الذي يحلم بحياة أفضل, وأنه شخصية تتناقض بين روح الدعابة وعذاب داخلي عميق. فهو يسعى للحق والفضيلة في عالم يهمشه، لكنه يواجه خيبات متتالية تحاصر حلمه.
وأحيانا تتسم الشخصيات بالمبالغة في أبعادها لإبراز الجانب الكوميدي, فقد تكون الشخصيات هزلية أو كاريكاتورية بمعنى تسليط الضوء وإبراز بعض الصفات الجسدية أو الكلامية أو السمات الشخصية بالمبالغة فيها لنقدها وتبيان مساوئها للمتلقي أو تشريحها بما يثير الضحك فيتولد بالتالي شعور لدى المتفرج برفض تلك السمة مع السخرية منها وإثارة ضحكاته معها. ومثال ذلك شخصيات مسرحية الغجرية والسنكوح, حيث يمتاز "السيد حافظ" بتقديم شخصياته بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، إذ يفضل الكاتب إخفاء هوية بعضهم خلف ألقاب أو أرقام، بعض شخصياته لم يعطها أسماء بل قدم وصفا لها مثل (أم دقروم- هريسة- الضابط- العجوز – المخبر – الناظر- المذيع المصري – المذيع الأمريكي- شاكوش ......) أو أرقام مثل (شخص 1 – شخص 2) مما يخلق جوًا من الغموض والترقب. هذه الشخصيات التي تعيش في عالم من العبث واللامعقول، تلعب أدوارًا بارزة في كشف تناقضات المجتمع." يشكل اختيار الأسماء والألقاب لدى "السيد حافظ" عنصرًا هامًا في بناء عالمه المسرحي. فأسماء مثل "زفة" و"حندوقة" تحمل دلالات رمزية تعكس حالة المجتمع، وتساهم في خلق جو من السخرية اللاذعة.
بعد أن تحدثنا عن الأفكار والمضامين في المسرحيات الكوميدية للسيد حافظ علينا أن نتحدث عن اللغة فيها باعتبار أن اللغة من أهم مفردات العرض المسرحي, فهي قاعدة الحوار تعتبر هي الكاشف الرئيس عن الأحداث والشخصيات المتضمنة في النص المسرحي, فعن طريق لغة الحوار نتعرف على المعلومات وعلى الدراما وعلى البيئة المحيطة وعلى تكوين كل شخصية. فهي كاشفة لأبعاد الشخصية وانتماءاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية, فنجد لكل شخصية أسلوب خاص بها وصياغة خاصة للجملة وإيقاع لفظي خاص بها. وعندما يلجأ المؤلف إلى الكوميديا تتخذ اللغة إضافة إلى ما سبق خواص أخرى إضافية لصنع حالة الهزل أو الكوميديا المطلوبة من خلال السخرية والألفاظ التهكمية واستخدام التعبيرات العكسية التي تؤدي لمعاني غير حقيقية أو ليس لها علاقة بالرد اللغوي الطبيعي لجملة الحوار المنطوقة أو إنها تتسم بالمبالغة سواء بالتفخيم أو التصغير أو اختفاء المعنى أو إنها تدل على الجهل أو عدم الفهم أو الغباء, وغير ذلك الكثير من الأساليب اللفظية المصاحبة لروح الفكاهة.
وقد اعتمد "السيد حافظ" في بناء اللغة في مسرحياته الكوميدية على الجمل القصيرة الموجزة, التي تحمل معاني التهكم والسخرية, وتميل أحيانا إلى الجناس أو الطباق في الألفاظ وكثيرا ما تميل إلى التورية. وهي لغة شعبية دارجة. أحيانا يكتبها بالعامية الدارجة وأحيانا أخرى بالفصحى السهلة التي قد تتضمن أحيانا جرسا موسيقيا يجذب الأذن. كما أنه يتضح فيها تأثر "السيد حافظ" أيضا بلغته الشعرية التي يحرص عليها في كتاباته للمسرح التجريبي. ولم تخل لغته من العبثية اللفظية التي تهدف إلى التعبير عن المعنى والوصول إليه من خلال مصطلحات وألفاظ وتعبيرات محررة تبدو في ظاهرها غير مفهومة لكنها تتضمن عمقا في المعنى إذا تم جمعها وخلطها من خلال الموقف والهدف الذي يرمي إليه, لا نقول لغة فلسفية ولكنها قد تحمل جدلا سفسطائيا يقود المتلقي إلى المضمون المراد توصيله.
في هذا الصدد يتحدث د. كمال الدين عيد عن مسرحية وسام من الرئيس قائلا " هذه المواقف الجديدة والطارئة على مناهج المسرح العربي كتابة وإخراجاً (فالسيد حافظ درامي ومخرج أيضاً) تبحث عن لغة جديدة أيضاً ، لغة متفردة لا تتصل بأشكال وأجروميات اللغة القديمة فى المسرح ، ولا تنتهج نفس مناهجها ، كما لا تنتمى إلى أي فرع من فروعها اللغوية، لغة اللا شيء، وتعتمد الهُراء والسفاسف والجدليات. لا للفهم ، ولكن لإثبات حالة (عدم الفهم وفقدان الاتصال) الأمر الذى يخلق كوميديا الموقف عند "السيد حافظ"، ويرفع إلى سطح الدراما البلادة والبلاهة".
إن اللغة المستخدمة في النصوص الكوميدية, تلعب دورا رئيسا في توصيل الموضوع للمتلقي من خلال أداة تفاعلية مختلفة الغرض منها الإضحاك الذي لا يكون هنا عند "السيد حافظ" هدفا في حد ذاته لكنه وسيلة ساخرة للنقد والتهكم لتصحيح الوضع المرفوض كما ذكرنا من قبل.
وبالنظر إلى أهمية اللغة العامية، وكيف أنها أداة قوية لكشف الحقيقة الاجتماعية والسياسية. فاللغة العامية تحمل إيقاعًا قويًا وتأثيرًا عميقًا، وتكشف عن أعماق نفسية الشعب ومعاناته. كما تؤكد على أن اختيار الكاتب للألفاظ والعبارات العامية له دلالات فنية واستهزائية, نجد أن اللغة العامية في مسرحية "ملك الزبالة" تعد أكثر من مجرد وسيلة للتعبير، فهي لغة ثورية تكشف عن عمق جراح المجتمع. من خلال اختيار الكاتب المتعمد للغة العامية، يتحول النص المسرحي إلى مرآة عاكسة تعكس واقعًا قاسياً ومليئًا بالتناقضات. فالإيقاع القوي والحمل الدلالي العميق للألفاظ العامية يكشفان عن وعي الشعب بمعاناته ورفضه للاستغلال والاستبداد. إن هذه اللغة النمطية، كما تصفها الدكتورة سميرة أوبلهي، ليست مجرد مجموعة من الكلمات، بل هي لوحة فنية معقدة تحمل في طياتها حمولة سياسية واجتماعية عميقة. إن اختيار الكاتب لألفاظ وعبارات تحمل في طياتها جماليات الاستهزاء يعكس قدرته على تحويل الألم والمعاناة إلى فن، مما يجعل النص أكثر قوة وأثرًا.
وعلى سبيل المثال أيضا في مسرحية "عاشق القاهرة" يختار الحاكم بأمر الله أن يتحدث بلغة الشعب في دكان فتحي، مما يدل على إتقانه فن التواصل. فباستخدامه للعامية، يقترب من قلوب الناس ويبني جسور الثقة بينه وبينهم. وهنا يرى محمد المحرواي أن اللغة هي أداة مهمة لبناء الشخصيات في تلك المسرحية فهي تعكس ثقافة الشخصيات ومكانتها الاجتماعية، وتساهم في خلق أجواء واقعية.
عن أهمية اللغة في أعمال "السيد حافظ" الكوميدية يشير الدكتور مصطفى رمضاني إلى أن اللغة العامية هي اللغة الأنسب للتعبير عن النكتة والمرح والسخرية، وأنها تفقد الكثير من تأثيرها إذا تم ترجمتها أو تقديمها في سياق لغوي آخر. ويرى أن اللغة العامية هي العمود الفقري لمسرحيات "السيد حافظ" الكوميدية. فمن خلال اختيار الكلمات والعبارات العامية بدقة، يستطيع الكاتب أن يخلق شخصيات كوميدية نمطية وأن يعبر عن أفكاره بشكل ساخر ومباشر. إن اللغة العامية، في هذا السياق، ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي أداة فنية تستخدم لخلق جو من المرح والسخرية، مما يجعل مسرحيات حافظ تجربة فنية فريدة:
نموذج:
شهاب : يا بني تعالى أدبحك وما توجعش قلبي.. فين أيام الفراخ لما الواحد يجري وراه ويمسكها... أنت ح تعمل زي الفراخ.
الراجل الميت : حرام عليكم أنا عندي عيال.
شهاب : يا بني أنت كنت ح تموت وبعدين تتحاسب.. دلوقت ح ندبحك وتدخل الجنة.
أبو زيد : كيف تقول هذا الكلام يا راجل .. حرام عليك.
شهاب : ما هو لما يندبح.. كل واحد ياخد طبق ملوخية باللحمة يقول الله.. الله يرحمه.. كان طعمه لذيد
الرجل الميت : لا .. أنا عايز أعيش.. مش أخدت ثمن المدفن من عيالي حلال عليك.
شهاب : يا بني أنت رزق بعته ربنا.
بينما تثبت مسرحية "حكاية الفلاح عبد المطيع" أن الكوميديا لا تقتصر على اللغة العامية، بل يمكن للفصحى أن تخلق تجربة كوميدية عميقة ومؤثرة. فالحوارات الفصحى في المسرحية تحمل في طياتها دلالات متعددة المستويات، وتنتهي المسرحية بلقطة عبثية تلخص المعنى الكلي للمسرحية. وبذلك، تُظهر المسرحية أن اختيار اللغة هو قرار فني يهدف إلى تعزيز الفكرة الأساسية للمسرحية وتوصيلها للجمهور بأقوى شكل ممكن.
نموذج:
الضوء في منتصف المسرح.. عبد المطيع أمام كرسي العرش عاريا، والوزير والمستشارين
السلطان : (يضحك) لقد أعجبتني قصتك، عندما سمعت بها قررت تعيينك يا عبد المطيع قاضي القضاة. (يصفق رجال الحاشية)
عبد المطيع : لا يا سيدي.. أنا لا أريد أن أكون قاضي القضاة.. أنا أريد أن أكون من العراة. يضحكون بينما هو يبكي).
وتوجد نقطة أخرى هامة لا يجب إغفالها في النصوص الكوميدية للسيد حافظ وهي استخدامه وتوظيفه للتراث الشعبي في نسج دراما تلك المسرحيات, حيث أنه استغل بذكاء الحكايات الشعبية والأحداث التاريخية التي يمكن أن تمس الوجدان الشعبي وصاغها بأسلوبه الدرامي ومزج بها التفاصيل التي يصنعها ككاتب, ناسجا أبعاد الملهاة الشعبية من خلال حكايات تجذب أذهان وأسماع المتلقي مثل حكاية الفلاح عبد المطيع حيث أن شخصيته هي شخصية إنسان عادي فقير من أفراد الشعب ينتمي إلى الغلابة مما يشعر المتلقي أنه ينتمي غليه فيتعاطف معه في محنه وفي الظلم الذي وقع عليه, مما يعمل على سهولة إثارة الضحك للمتلقي من باب أن الشخص يضحك على مأساته بطريقة أن شر البلية ما يضحك, وقمة الملهاة تنبع من قمة المأساة, فوقوع الظلم على عبد المطيع من قبل السلطان يجعل منه بطلا شعبيا مغلوبا على أمره ينشد فيه المتلقي نفسه لرفع الظلم عن نفسه دون أن يظهر هو في الصورة الدرامية كي ينتصر في المتخيل الدرامي دون أن يصيبه هو أذى مثل عبد المطيع.
ويرى د. السعيد الورقي أن "السيد حافظ" قد اتجه إلى بعض أساطير الهزيمة التي تطرح العديد من صور التعفن والامتلاك في التاريخ المصري، ليشكل منها إطار الحدث الدرامي، وذلك في محاولة منه لإعادة تشكيل العالم وصياغته بعد أن أصابته الفوضى، وبعد أن أختل نظامه.
فعلى سبيل المثال لما ذكره د. الورقي نجد في مسرحية مثل (حرب الملوخية) والتي استمد "السيد حافظ" أحداثها من التاريخ المصري في عهد حكم المستنصر حيث انتشرت المجاعة وساءت الأحوال ووصلت لدرجة انتشار أكل الكلاب والقطط بل وأحيانا قتل الآدميين وأكل لحومهم, وقد شهد هذا العهد شدة الظلم والقهر للشعب وسيطرة كبار التجار على مقدرات الشعب وعلى قرارات السلطة الحاكمة فكانوا يعملون على تجويع الناس وعلى احتكار السلع وتخزينها على سبيل الطمع لرفع أسعارها وتفشي الغلاء كي تزداد ثرواتهم على حساب الشعب المغلوب على أمره. وعنها يقول د. كمال الدين عيد في تحليله للنص المسرحي "فأنا أري أن كوميديا تاريخية مصطلح جديد على المسرح المصري والعربي ، كان يجب على المسئولين عن المسرح احتضان هذا التيار والاحتفاء به. إذن لخلف المسرح المصري تيارا تاريخيا كوميديا جادا، وساخرا، كان يمكن ان يمتد ليقف في وجه عبثيات المسارح التجارية".
ويظهر "السيد حافظ" في مسرحياته مثل "ملك الزبالة" و"قراقوش والأراجوز", و"الحاكم بأمر الله عاشق القاهرة", قدرة فائقة على إعادة قراءة التراث المصري وتوظيفه في إطار كوميدي معاصر. فمن خلال الربط بين الحكايات التاريخية والشخصيات الشعبية، يخلق "السيد حافظ" أعمالاً مسرحية تجمع بين الأصالة والحداثة، وتلبي ذوق الجمهور المعاصر حيث يستمد "السيد حافظ" في مسرحياته، مثل "حرب الملوخية"، إلهامًا من الميموس اليوناني القديم، حيث يعالج قضايا المجتمع بمنظور كوميدي ساخر. هذه العودة إلى الجذور التاريخية، إلى جانب قدرته على إعادة قراءة التراث وتوظيفه في إطار معاصر، تجعل مسرحياته أعمالاً فنية ذات قيمة عالية.
الخلاصة:
"تتميز مسرحيات "السيد حافظ" الكوميدية بطابعها الفريد الذي يجمع بين الكوميديا السوداء والسخرية اللاذعة والانتقاد الاجتماعي. يستلهم حافظ في كتاباته روح الميموس اليوناني، حيث يعالج قضايا المجتمع بمنظور هزلي ساخر. وتتمثل أهم سمات مسرحياته في:
• الكوميديا السوداء: حيث يمزج بين المأساة والكوميديا، مستخدمًا السخرية لفضح الظلم والقهر.
• الشخصيات : يتميز بأبطال يعكسون الصراع الداخلي للإنسان البسيط أمام قوى الظلم والاستبداد، كما يستخدم شخصيات كاريكاتيرية لتجسيد الصفات السلبية في المجتمع.
• اللغة: تعتمد مسرحياته على لغة حوارية بسيطة وواضحة، غنية بالعامية والتعبيرات الشعبية، مما يجعلها قريبة من الجمهور. كما يستخدم السخرية والتهكم واللغة المزدوجة المعنى.
• التراث: يستغل التراث الشعبي والأحداث التاريخية ليصنع حكايات كوميدية تعكس واقع المجتمع المصري.
• السياسة : تحمل مسرحياته طابعاً سياسياً واضحاً، حيث ينتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية بطريقة ساخرة.
بفضل هذه العناصر، تمكن "السيد حافظ" من خلق عالم مسرحي فريد يجمع بين الفكاهة والوعي الاجتماعي، مما يجعله أحد أهم الكتاب المسرحيين في مصر والعالم العربي.
المصادر والمراجع:
- السيد حافظ, مسرحيات: (الغجرية والسنكوح, خطفوني ولاد الإيه, عاشق القاهرة.. حلاوة زمان), مدونة أعمال الكاتب السيد حافظ موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت (https://sdhafez.blogspot.com/).
- السيد حافظ, مسرحية حكاية الفلاح عبد المطيع, المجلس الأعلى للثقافة, سلسلة إبداعات التفرغ, القاهرة, 2004.
- السيد حافظ, مسرحية حرب الملوخية, العربي للنشر والتوزيع, القاهرة, ۱۹۹۷.
- السيد حافظ, مسرحية قراقوش والأراجوز, العربي للنشر والتوزيع, القاهرة, ۱۹۹۷.
- السيد حافظ, مسرحية ملك الزبالة, العربي للنشر والتوزيع, القاهرة, ۱۹۹۷.
- السید حافظ ، وسام من الرئیس ( مسرحیة كومیدیة )، العربي للنشر والتوزیع ، ۱۹۹۷.
- السعيد الورقي , حكاية الفلاح عبد المطيع للسيد حافظ ومسرح التضامن والمشاركة, مسرحية حكاية الفلاح عبد المطيع, المجلس الأعلى للثقافة, سلسلة إبداعات التفرغ, القاهرة, 2004.
- سعاد درير, رؤية لمقاربة النص المسرحي وسام من الرئيس, مدونة أعمال الكاتب السيد حافظ موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت (https://sdhafez.blogspot.com/), 2017.
- سميرة أوبلهي , ملك الزبالة كوميديا سياسية في ثوب فنى متميز, كتاب "إشكالية الحداثة والرؤي النقدية فى المسرح التجريب" –ج2, جمع نجاة صادق, "رؤيا", القاهرة, 2018.
- عبد الغني داود، وسام من الرئيس وألوان الطیف الملھوي، إشكالية الحداثة والرؤى النقدية في مسرح السید حافظ، جمع نجاة صادق، " رؤيا", القاهرة،2018.
- عبد الله هاشم, حكاية الفلاح عبد المطيع, كوميديا "السيد حافظ" الباكية, مقال, مجلة الشراع اللبنانية, 30/1/1984.
- كمال الدين عيد, مسرحية جمالية الكتابة المسرحية والسردية عند السيد حافظ, دراسة عن وسام من الرئيس, "رؤيا", القاهرة, 2020.
- محمد المحراوي , "قراءة في مسرحية عاشق القاهرة", المسرح التجريبي بين المراوغة واضطراب المعرفة, جمع نجاة صادق, "رؤيا", القاهرة, 2018.
- مصطفى رمضاني, الجروتسيك في كوميديات "السيد حافظ", كتاب "السيد حافظ" في عيون نقاد المغرب,(رؤيا), جمع نجاة صادق, القاهرة, 2018.


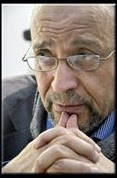





 1:26 م
1:26 م
 sayedhafez
sayedhafez






























