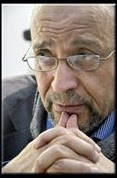جريدة الراية (قطر) فى 18/5/1983
هل يستطيع الكاتب أن يهرب من جذوره؟!
السيد حافظ
أوزوريس وحكاية الفلاح عبد المطيع
بقلم : فيصل السعد - الكويت
رفض الواقع مسالة تصعب ممارستها وبخاصة عند الذين لا يملكون البديل للواقع
المرفوض.
فهؤلاء ليس أمامهم غير الهروب لأمن أجل البحث عن بديل من
أجل التناسى، التسكع افغماء الواعى، الالتفات إلى وراء للتأكد من متابعة واقعهم
لهم.
ومسألة الهروب
هذه هى فى الحقيقة عملية ترسيخ للواقع، وتجذير لأيامه.
ولذلك نجد حديث
الهاربين لا يحتوى إلا على صفحات أراد هذا الإنسان أو ذاك الهروب منها، وتأكد بعد
بدايته فى الهروب من استحالة التخلى عنها لأنها تعنيه كياناً، وإنساناً، وأبناً
شرعياً لها، ونتيجة طبيعية لسلوكياتها.
ترى هل لهذه
الصفحات الكالحة، المرة، المجرحة، القاتلة من ايجابية؟
دعونى أتجرأ
وأقول نعم.
إذ أن الصراع
الذى يستحدث فى ذهن الهارب مع ذاته بين ندمه على الهروب لافتقاره للبديل وبين
تبرير هروب أمام ذاته والمجتمع بكونه واقعاً ألغى الخطوات التى كان ينتمى إليها
هذا الكاتب أو ذلك. وهذا الصراع هو الحصيلة الأفضل والمنبع المستمر لنتائج الكاتب
الشاعر، المسرحى، الموسيقى، هو الذهنية الخصبة التى على استعداد مستمر لأن تورق.
السيد
حافظ،مثقف مصرى، كاتب مسرحى، صحفى ناجح، صرخ من اجل الآخرين، غنى لهم، بكى لأجلهم،
رفضه الآخرون، وقد تأكد من هذا الرفض حين استمر فى مسيرته والتفت إلى وراء فلم يجد
إلا الريح. وفى تلك اللحظة تأكد أن كل شئ باطل وقبض الريح حمل أمتعته وجاء إلى
الكويت رافضاً لواقع كاد أن يمزق حتى حروفه. فى بداية هجرته لم يكن يفكر إلا
بالابتعاد عن دياره المحاصرة ذهنياً، وبعد أن استقر بدأ يفكر بكيفية ترجمة هوامشه
الفكرية إلى مسرحيات من شانها أن تساهم فى تذكير الخطى المتناسية وتضطر أصحابها
إلى الالتفات إلى صوتها المنسى.
فكتب العديد من
المسرحيات والمسلسلات التليفزيونية وله تحت الطبع مسرحات : الجراد ، مهمة رسمية،
القطار المسافر إلى القاهرة على رصيف رقم 3، المزامير، زمن الواحدة بين دقيقة
وساعة.
إضافة إلى
دراسات: المسرح المصرى وقضاياه، المسرح التجريبى ضرورة لماذا؟ علامات فى المسرح
المصرى.
إضافة إلى
رواية تحمل اسم : مذكرات شاب فى العشرين.
صدر له قبل
أيام - حكاية الفلاح عبد المطيع - ويضم هذا الكتاب ثلاث مسرحيات تؤكد عناوينها قلق
الكاتب، خوفه من الناس ومن ذاته، فالمسرحية الأولى تحمل اسم : "ممنوع أن
تضحك.. ممنوع أن تبكى" أو حكاية الفلاح عبد المطيع - أما الثانية فاسمها :
علمونا أن نموت وتعلمنا أن نحيا.. أما الأخيرة فاسمها : "الخلاص" أو
" يا زمن الكلمة الخوف.. الكلمة الموت.. يا زمن الأوباش".
وكان قلق حافظ
وحزنه محسوساً عند الكاتب" فقد كتب عنه فى مصر ، المغرب، العراق، الكويت ودول
عربية أخرى، وتناولت موضوعات الكاتب مسرحياته المطبوعة سابقاً، عالمه، تطلعاته..
و.. يأسه.
1-
حكاية الفلاح عبد المطيع أو ممنوع أن تضحك ممنوع أن تبكى :
عبد المطيع : يا نفسية.. يا نفيسة.. الماء الساخن والملح.
نفيسه : ليس عندى حطب.
عبد المطيع : لماذا لم تخبرينى فى الصباح؟
نفيسه : لأنى كنت مشغولة.
عبد المطيع : فى أى شئ مشغولة يا امرأة؟
نفيسة : مشغولة مع أولادك.
عبد المطيع : لماذا لم تأخذى مع الجيران؟
نفيسة : لن أذهب إلى فاطمة ولن أحدثها ولن أذهب إلى
السوق لأنه ليس عندى شئ لأقايضه ولا عندى نقود.
عبد المطيع : نقود .. نقود.. نقود.. ليحرق الله النقود
واليوم الذى ظهرت فيه النقود.
نفيسه : المال يا سيدى هو لغة العصر.
عبد المطيع : العصر الذى يقيم فيه الرجل بالمال هو عصر
مختل.
نفيسه : هذا هراء كلام ساذج وسخيف لا يقبله أى رجل عاقل.
الإنسان الذى يتحدث عنه السيد حافظ لا لون له. ولكنه اصطبغ بلون مفروض عليه
وترك له الخيار بالسير فى دروب هذا اللون أو المراوحة فى مكان واحد.. هكذا أمر
السلطان.. والفلاح عبد المطيع صديق حميم للفقراء المؤرق المؤلم.. وقد اصطبغت
ملابسه بلون كالح، تجمعت فوقها أوساخ الحياة.
مرض السلطان
وأعلن رئيس الشرطة ضرورة ارتداء السواد. وعبد المطيع لم يسمع بهذا الخبر.. تفاجأ
عندما شاهد مجموعة فى المقهى يرتدون السواد.
قاده الشرطى
إلى رئيس الشرطة فى حوار طويل لم يفهم نهايته ما يراوده ولم يعرف أن السلطان مريض
وعليه أن يلبس ثوباً أسود لا يملكه:
رئيس الشرطة :
قف يا أبله لا تتحرك.. وبصوت خشن وغاضب؟
عبد المطيع :
إنه صديقى ويشير لرئيس الشرطة.. معجب بثوبى الممزق.. اعتقد بإنه اقتيد إلى مكتب
رئيس الشرطة ليريه ملابسه المغرية.. ولذلك ظن أن رئيس الشرطة أعجب بملابسه. وقد
أهدته إلى هذا الاعتقاد سذاجته فهو لا يعرف غير أخبار الزرع وموعد الحصاد.
ولذلك لم يكن
يتحدث بخوف فهو لم يطرأ على باله بان يجب أن يحزن على السلطان علانية، إذ إنه لم
يجرأ أن يضع اسمه بموازاة الذين يخصهم السلطان بالحزن :
رئيس الشرطة :
كفى مزاحاً يا رجل.
عبد المطيع :
لا ترفع صوتك هكذا أمام الشرطة.. إنهم يسكنون بالقرب منى.. لا داعى للغضب.. خذ
الملابس لك ولن أخبر السلطان.
رئيس الشرطة :
أنت ترفض الاستجابة والخضوع والمثول لأوامر السلطان.
عبد المطيع :
الشعير فى السوق شحيح.. والحمار جائع.
رئيس الشرطة :
رموز وغموض وكلمة السر التى بحثنا عنها يحكم على عبد المطيع بخمسين جلده كل صباح
وكل مساء ولمدة أسبوع وحين سأله أحدهم لماذا قال :
عبد المطيع :
لأن السلطان ورئيس الشرطة يريدان ثوباً ويتشاجران من أجله.
يشفى السلطان
من مرضه بعد أسبوع من جلد عبد المطيع فيأمر الناس بأن يرتدوا ملابس بيضاء فرحاً
بشفاء السلطان.
وكذلك لم يسمع
عبد المطيع فيجلد لمدة أسبوع أخر واعتقد أن النزاع القائم بين رئيس الشرطة
والسلطان على ملابسه لازال مستمراً.
ترى من هو
السلطان ومن هو عبد المطيع؟ قد يفهمها البعض أن السلطان هو الزمن وعبد المطيع
الإنسان.. وقد يكون الحياة وعبد المطيع المسير، وقد يكون القدر، وعبد المطيع
الملتقى. ولكن تظل هذه الاعتقادات كلها صحيحة.
***
2-
علمونا أن نموت وتعلمنا أن نحيا :
الفكر المسيطر
على ذهن الكاتب، أو الشاعر، أو المسرحى، له الأولوية دائماً فى الانفساح على
الورق، قد يلبس ألف لباس، ويحمل ألف لون، ولكن تظل النكهة الفاضحة هى السياقة إلى
ذهن القارئ.
هذا العمل
يعتمد على سجينين يتصوران ما يريدان. ويضم العمل اشارتين كتبت الإشارة الأولى
باللغة الفصحى ربما لأنها كانت مجرد تخيلات لسجينين عزلا عن العالم :
السجين 2 : هذه
المديه يلعب بها الأطفال.. لابد أن تحمل مسدساً وليس مديه كهذه.
"ينام ينظر إلى المستوى الثانى الذى يزداد ضوءاً.. تظهر امرأة فى خريف العمر
ترتدى فستاناً أنيقاً.. غريباً فى الشكل:
المرأة : اترك
هذه المدينة تعال إلى جوارى.. دعك عن اللعب بالمديه.
سجين 1 : إننى
أفضل الجلوس هنا.. إن الحجرة مثل السجن.
المرأة : حقاً
إن الغرفة بلا هواء نقى.. وبلا دفء.. وبلا شمس.. لكنها ليس سجناً.
بينما نجد
الكاتب فى الإشارة الثانية للمسرحية والتى كتبها وبشكل متعمد باللهجة الدارجة
المصرية وذلك - كما اعتقد - ليضع فاصلاً بين حالات الخيال والتصور، وحالات اليقظة.
فى هذه الإشارة
لم يستطع أن يتخيل ما يريد كما فى الإشارة الأولى لأنهما - هو وزميله - كانا
يعيشان لحظتهما الواعية وبالتالى فلا مجال للتخيلات :
سجين 2 : أنا
سرقت الفلوس من المحل وقتلته فعلاً.. سرقت مأمور الضرائب.
سجين 1 : أنت
قتلت الخوف من الفقر.. حطمت الأغلال اللى فيك.
سجين 2 : لكن
أنت ذكى.
سجين 1 : أنا
أصيل.
سجين 2 : لا
أنت بتشد الحاجات جوايا.
سجين 1 : احنا
بنزرع مع بعضنا حاجة.. بنزرع بذرة.
سجين 2 : احنا
سجين 1: لا..
احنا .. احنا..
سجين 2 : وهو
يهرب منه.. أنت عايز منى ايه.
من خلال هذا
الحوار الجيد ندرك أن هناك هوه ذهنية كبيرة بين السجينين وربما كان أحدهما سياسياً
والآخر بتهمة عادية أو ربما ما كانا فى السجن بل جمعهما مكان واحد ربما شارع، زمن،
عمل، مقهى، وهكذا...
ولكن هناك
ملاحظة لابد منها وهى إنه كان على الكاتب أن يظهر ملامح السيناريو فى هذه الأسطر
القليلة.
سجين 1 : احنا
بنزرع مع بعضينا حاجة.. بنزرع بذرة.
سجين 2 : كان
عليه أن يسأل : "انتو" بدل احنا. لأن هذا البسيط لا يفكر أبداً بإنه هو
المقصود بكلمة احنا.
وهنا لابد من
القول بأن السجين الأول إشارة لصاحبه، وأعطى نفس الإشارة لنفسه ليقول وهو فاتحاً
عينيه بقوة :
سجين 1 : لا..
احنا.. احنا.
تظل هذه المسرحية..
أكبر من أن تحدد بزمن أو مكان.. إذ أن من الممكن تكرار الزمن، ومن الممكن أن يأخذ
أى مكان دور السجين.
***
3-
الخلاص :
هذه المسرحية
تتكون من ثلاثة حدود ولا تختلف فى جذور مضمونها عن السابقتين إلا أنها أخذت شكلاً
آخر دفعنا إلى الحديث عنه.
فهى مسرحية شعرية،
كتبت بالشعر الشعبى المصرى. وهناك فارق لابد من ذكره بين الشعر الشعبى الذى عرفت
مصر بقوته وأصالته وبين الشعر المسرحى الشعبى الذى نجد فيه أحياناً الانتقال من
وزن شعرى إلى آخر.. أحياناً الأتيان بمقاطع نثرية وذلك لضرورة إتقان الدور.. يعنى
يظل هناك ثمة فارق بين الاثنين ولكن السيد حافظ حاول فى مسرحيته الشعرية أن يمزج بين مساحة الشعر الشعبى ومساحة الشعر المسرحى
الشعبى إذ إنه بقى فى إطار النفس الشعرى الحقيقى بحيث أن من الممكن أن تجمع مقاطع
هذه المسرحية فى ديوان شعرى مطبوع.
هذا كل ما يمكن
- واعتقد أفضل ما يمكن - أن يقال عن هذه المسرحية فهى تطرح فكراً مشابهاً لما طرحه
الكاتب فى المسرحيتين السابقتين ولكن بألوان أخرى اشتركت فيها المجموعة، وسلام،
والأم غالية، والرجال الثلاثة.. الخ. حاول الممثلون أن يتكلموا عن الخديوى والوضع
الذى كان سائداً آنذاك والأوضاع المشابهة بعده.
ولكن يبقى
الأسلوب الشعرى هو الملفت للنظر أكثر.
المجموعة :
وهات شالك غطى
ايدينا
فى الدنيا برد
يا روحى عليا
يا حبيبى يا
حبيبى أنت عريسى
يا هوى يا هوى
يا مسيسى
لاخد قميصك
وأغطى إيدك يا
حبيبى
يا هوى مش حا
تغزلنى
قميص حبيبى
مغزلنى
يا عروسة يا
عروسة
يا جمالك
ليلة الحنة يا
عروسة
يا جمالك
ليلة الحنة يا
عروسة
يا جمالك
قلبك اخضر يا
عروسة
يا جمالك
خاتمة تعريفية
السيد حافظ هو
من مؤسسى المسرح التجريبى فى الإسكندرية وقد مثلت له مسرحيات عديدة منها : حدث كما
حدث ولكن لم يحدث شيئاًن الطبول الخرساء فى الأودية الزرقاء، كبرياء التفاهة فى
بلاد اللا معنى... ومسرحيات أخرى كلها مثلت بين عامى 1973- 1975. وكان السيد حافظ
قد مارس الإخراج فقد أخرج معظم مسرحياته إضافة إلى مسرحية الزوجة - لمحمود دياب -
والجيل - ليوجين أونيل - وهناك سهرة للمقاومة أعدها الشاعر محمود درويش بالاشتراك
مع الشاعر سميح القاسم. وأعمال أخرى عديدة قام الكاتب بإخراجها فى تلك الأعوام.
كما أن أعماله كانت تظهر على المسرح تحت اسم "أوزوريس" الذى كان يعنى
آنذاك، السيد حافظ.