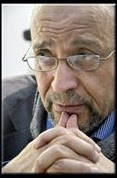مسرح السيد
حافظ
بين التجريب
والتأسيس
بقلم الكاتب
والمخرج المغربى الكبير
عبد الكريم
برشيد
مدخل للتساؤل...
الكاتب فى
المسح. ودوره؟ هل يحاكى العالم - كما هو العالم - أم يعيد خلقه وإنشاءه من جديد؟
شئ مؤكد أن
الوجود ليس كما ساكناً وثابتاً، وإنما هو التغيير؟ هل يحاكى المخلوقات أم مبدأ
الخلق؟ هل يستنسخ الزمن والمكان والناس والعلاقات والمؤسسات - كما هى أم يعيد
خلقها من جديد؟
نعرف أن العالم
- كموضوع فى المسرح - شئ لا وجود له إلا من خلال ذات المبدع. نحن دائماً أمام موقف
ما، موقف المبدع بالضرورة. هذا الموقف يتولد عن رؤية غير محايدة بالتأكيد تجديد
الأدوات التعبيرية، وبذلك يولد المسرح التجريبى ولادة شرعية لأنه يأتى موصولاً
بالرؤية وموضوعها وأدواتها، إن التجريب - كتعبير فنى فكرى - هو بالأساس محاكاة
للتغير الواقعى - اجتماعاً ونفسياً وسياسياً وفكرياً، ومن هنا يكون للتجريب الغربى
معنى، لأنه ثورة تسير بمحاذاة ثورات أخرى، ثورات يمكن حصرها فى الثورة السياسة
والصناعية والدينية والفكرية. أما بالنسبة للمسرح العربى فماذا يمكن أن نقول عنه؟
هل نقول بأن التجديد حاصل فى المجتمع والفكر والساسة، وبالتالى يمكن أن يكون له
امتداده الطبيعى إلى المسرح والى سائر الآداب والفنون الأخرى، هذا هو السؤال الذى
سنحاول الإجابة عنه، وذلك من خلال دراسة مسرح السيد حافظ، وهو مسرح تجريبى بالأساس.
- التجريب بين
تجديد العالم وتجديد الرؤية والتعبير :
إن الحديث عن
التجريب فى المسرح العربى يمكن أن يؤدى بنا إلى الحقيقة التالية، وهى أن التجريب
الفنى والفكرى بابه موصود لأنه حوار غير موصول بين المبدع والواقع. إنه رؤية
مغايرة وأدوات وأدوات فنية جديدة لواقع لا يريد أن يكون جديداً أو مغايراً. فعلى
مستوى الخلق الفنى سنجد أن التجريب ينسى أو يتناسى الجمهور - بكل ما يحمله هذا
الجمهور من ترسبات الماضى واحباطات الحاضر - ومن هنا، يبقى الإبداع، رغم التجديد -
تأليفاً وإخراجاً وتمثيلاً وتقنيات - ولكن الجانب الآخر فى الحوار، هل تجددت
رؤيته؟ هل تغيرت أدواته ومفاهيمه للحياة والمسرح؟ من هنا تجدنا مضطرين لن نرسم بعض
التساؤلات/ بالمفاتيح وذلك حتى ندخل المجال الحقيقى للتجريب.
1- هل يمكن للتواصل أن يكون حقيقياً بين إبداع تجريبى متقدم
وجمهور مسرحى متخلف؟
2- كيف نسعى إلى خلق خطابات فكرية وفنية مغايرة ثم تعمل على
إيصالها إلى الآخر، فى الوقت الذى لا وجود فيه لهذا الآخر المغاير، إن الكتابة
الجديدة تتطلب بالضرورة قراءة جديدة.
3- التجريب بالأساس ضرورة، فالواقع عندما يزداد تركيباً
وتعقيداً فإنه يصبح فى حاجة إلى أدوات مركبة ومعقدة أيضاً، وذلك حتى يستوعب
التقنية الموضوع والمضمون معاً، وتكون أقرب إلى التعقيد الذهنى والنفسى للجمهور.
فهل وصل الواقع العربى إلى مرحلة دقيقة مركبة ومعقدة حتى نبحث له عن لغات نية
وتقنية تكون أكثر تعقيداً وأكثر دقة؟
4- الإبداع الحقيقى يقف دائماً فى مواجهة السلطة، هذه
السلطة التى لها أكثر من وجه وأكثر من قناع، وإن أخطر سلطتين يواجهها الإبداع
العربى هما سلطة الدولة وسلطة الجمهور، فالدولة تفرض مغازاتها والدوران فى
أفلاكها، أما السلطة الثانية فتعبر عن ذاتها مسرحياً من خلال الشباك الغاشم الذى
يرضى عن العادى والمبتذل والمفهوم والساقط ويعادى الجديد والحقيقى والغريب والموحى.
إن الإبداع فى المجتمع العربى مطالب بأن يكون تابعاً للسلطة.. فى جميع
تجلياتها - عوض أن يكون سابقاً لها، أى أن يكون ساكناً ثابتاً متخلفاً معادياً
للتجريب وللاجتهاد، قانعاً باجترار المفاهيم القديمة.
إن الإبداع الحق يقوم أساساً على الحرية، حرية المبدع فى الخلق. وحرية
الجمهور فى التجمع والتجمهر والفهم. وهذا ما ليس له وجود مع وجود السلطة فى
تجلياتها المستبدة والمتسلطة. يقول أبوللينر عن الكاتب المسرحى :
(من العدل أن يجعل الجموع والأشياء الجامدة تتكلم إذا
راق له.
وأن يغفل الزمان
وكذا المكان
إن عالمه هو مسرحيته
وفى داخلها هو الإله الخلق
الذى يرتب كما يشاء
الأصوات والإيماءات والحركات والكتل والألوان).
وهذا ما سنجده فى مسرح السيد حافظ، هذا المسرح الذى هو عالم آخر، له أزمانه
المغايرة وأشخاصه وطقسه والذى هو عالم سحرى يختلط فيه الواقعى بالحلمى والتاريخى
بالاسطورى والمحسوس بالمجرد والمشخص بالمعنوى. هذا العالم له بنية الخاصة، سواء فى
التركيب الذهنى والنفسى للشخصيات أو فى اللغة والحدث والمواقف، وهذا ما سوف نراه
فى هذه الدراسة..
- السيد حافظ : لسان حال النكسة..
من يكون السيد حافظ؟ من هنا أبدأ؟
إنه مؤلف ومخرج مصرى من جيل النكسة، أى من جيل العنف والغضب والشهور
بالإحباط، ومن هنا كان القلق ميزته الأساسية فى الكتابة. و هو قلق وجودى واجتماعى
معاً، لأنه يتردد بين رفض الشرط الإنسانى ككل ورفض الواقع المصرى، وهو واقع تاريخى
ساقته عوامل عديدة ذاتية وموضوعية - إلى عنق الزجاجة، وبذلك كانت النكسة. يقدمه
لنا (محمد يوسف) كالتالى. (ينتمى السيد حافظ إلى رعيل من جيلنا، شارك فى المظاهرات
الطلابية التى انفجرت فى مدينة الإسكندرية عام 1968 أى بعد مرور عام الهزيمة
الفاجعة فى عام 1976. وكان واحداً من هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا يتحدون الحكومة
والنظام، ويطالبون بمحاكمة الجنرالات والضباط الكبار الذين انشغلوا بالكرة
والأندية الرياضية عن الاستعداد العسكرى). هذا الغضب على الواقع التاريخى - بكل
مظاهره ومكوناته المختلفة - ولكنه يمتد ليصل إلى الكتابة عند السيد حافظ، هذه
الكتابة التى تكفر بالقوالب البالية فتحطم كل شئ، اللغة والشخصيات والحوار وكل
المفاهيم العتيقة، فالتجريب لديه ضرورة، لأنه متولد عن حاجة داخلية للتغيير، تغيير
الرؤية وموضوع الرؤية وأدوات الرؤية، وذلك من أجل ايجاد فن جديد لعالم جديد، عالم
يفقز على قبح الحاضر المحمل بالهزيمة والمرسوم بكل عوامل النكسة.
يقول السيد حافظ فى استجواب صحفى (جيلنا من الكتاب الذى لم يظهر إلى الآن..
جيل رائع ملئ بأشياء خفية مضيئة مكتوب عليها ممنوع الاقتراب من هيئة المسرح
والثقافة الجماهيرية مرتع للفوارغ من كل شئ فى الأقلام) هذا الغضب ناتج من إحساس
باطنى بالغبن. فالمؤلف - من جهة - لا ينتمى لجيل الستينات - الذى كانت هيئة المسرح
والثقافة الجماهيرية مفتوحة فى وجهه. ثم إنه - من جهة أخرى - ينتمى جغرافياً إلى
مدينة الإسكندرية، هذا الانتماء الذى يعنى إبعاده عن المركز، أى القاهرة، التى هى
السلطة الوحيدة والكلية، إنها الكل، وخارجها لا وجود إلا للفراغ. ومن هنا جاءت
ثورته على الاستبداد السياسى موازية لثورته وغضبه على الاستبداد الجغرافى. ففى
مسرحية (حدث كما حدث ولكن لم يحدث أى حدث) نقرأ هذا الإهداء :
(إلى جيلنا الرائع فى غلاف التكوين.. إلى أدباء
الأقاليم)
إنه الحصار إذن حصار جيل كتبت عليه الهزيمة وفرض عليه أن يتحمل وحده
تبعاتها، وهو أيضاً حصار أقاليم ليس لها من ذهب سوى أنها تقع خارج القاهرة. أى
بعيداً عن مصدر السلطة السياسية والثقافية والفنية..) يقول إبراهيم عبد المجيد عن
المؤلف :
(وهو يعيش بالإسكندرية بعيداً عن القاهرة. والبعد عن
القاهرة كثيراً ما يكون غنيمة ولكنه فى مجتمعنا - وخاصة فى مجال الأدب - مصيبة.
فالكتاب والفنانون جميعاً مدعوون لهجرة الأقاليم والمدن من أجل هذا المرض الخطير
المسمى "بالمركزية" مركزية مادية وروحية أيضاً) وبهذا كان لتمرد السيد
حافظ أبعاداً متعددة، فهو تمرد على السلطة وعلى تمركزها فى مدينة واحدة، وفى شخص
واحد، وفى جمهور واحد له بُعد نفسى وذهنى وذوقى واحد، لأجل هذا كان دخوله المسرح
التجريبى دخولاً شرعياً، لنه دخول يهدف إلى تحطيم أوثان وهدم الوثنية، هذه الوثنية
الملائكية التى تتجلى فى عبادة المدينة / الصنم والشخص الوثن. إن التجريب مرادف
التغيير، فهو يظهر دائماً فى المراحل الانتقالية. ففى فرنسا ظهر مسرح العبث بعد
الحرب العالمية الثانية، جاء كفراً بكل القيم فى العلم والتقدم والتفاهم والتعايش،
أما فى العالم العربى فقد جاء التجريب مباشرة بعد النكسة، نكسة العرب فى 1967، جاء
فى الزمن الصعب ارتجالاً لواقع مغاير وفكر مغاير وفن مغاير، جاء كفراً بعد إيمان،
لحد السذاجة وتمرداً بعد خنوع، وحركة بعد سكون، وبحثاً بعد انتظار وصراخاً حاداً
بعد صمت طويل لقد كتب السيد حافظ مسرحيات لا تمت للمسرح فى شئ، وصور واقعاً عربياً
متعدد الأبعاد والزوايا. فبدأ هذا الواقع غريباً، وبدت مسرحياته أكثر غربة.
فالشخصيات قد تكون رموزاً وقد تكون أصواتاً وقد تكون حيوانات بشرية. وتبدأ الغرابة
لديه فى أسماء مسرحياته:
1- حدث كما حدث ولكن لم يحدث أى حدث.
2- الطبول الخرساء فى الأدوية الزرقاء.
3- قرية المفروض فى مدينة الرفض ترفض رفض الأشياء.
4- الحانة الشاحبة تنتظر الطفل العجوز الغاضب.
5- هم كما هم ولكن ليس هم الزعاليك.
6- كبرياء التفاهة فى بلاد اللا معنى.
7- ست رجال فى معتقل - ب شمال حيفا.
8- حكاية مدينة الزعفران
9- حبيبتى أميرة السينما.
هذه الأسماء هل
لها معنى؟ أكيد لها معنى، ولكن يبقى بعد هذا، هل يصل إلى القارئ المتفرج هذا
المعنى؟ مرة أخرى نتساءل. أى قارئ وأى متفرج نعنى؟ شئ مؤكد إنهما الكتابة الغاضبة
الرافضة تتجه أساساً إلى جيل غاضب رافض. وإن تفجير الكتابة التقليدية جزء من تفجير
هذا العالم، وذلك لإعادة بنائه بصيغة أخرى مغايرة.
فلو تأملنا
جيداً أسماء مسرحياته فماذا سنجد؟ سنجد أنها تتركب من المفردات التالية : الكبرياء
- التفاهة - اللامعنى - الخرساء - الرفض - الشاحبة - تنتظر - الطفل العجوز -
الغاضب معتقل - هذه الكلمات القليلة تختصر كل رؤية المؤلف للعالم، وهى رؤية
مأساوية، كما تختصر شعوره القائم على الغضب وعلى رفض التفاهة واللامعنى من اجل
تجاوز الانتظار والشيخوخة والعجز والاعتقال. يقول على شلش عن المؤلف :
(إنه شاب جرئ جداً، وطموح جداً، حطم بطموحه وجرأته
قواعد المسرح من أرسطو إلى بريخت).
عن الطليعة فى
منظورها العربى..
أعمال السيد
حافظ المسرحية تحدق فى الناس والأشياء بعينين : العين الأولى عربية، وهى مفتوحة
على الـ "نحن" وعلى "الآن" والـ "هنا" أما الثانية
فهى عين غربية مفتوحة على المسرح الأوروبى كتجارب جريئة وجديدة ومدهشة. هذا
الازدواج فى الرؤية والتعبير عنها هو ما حرر مسرحه من التبعية للمسرح التجريبى
الغربى. إنه لم يسقط فى اللا معقول لأنه أكتفى بمحاورة الشكل العبثى من غير أن
يغوص فى مضمونه الفكرى، وهو مضمون وجودى محض، مضمون قائم على نظرة عدسية ترتكز على
النفى، نفى المعنى ونفى الحوار واللقاء ووحدة الهوية وإمكانية أن يحدث شئ جديد له
معنى، فلا شئ إلا الخواء، ولا وجود إلا لشخصيات بلا عمق ولا ملامح، شخصيات خاوية تقول
أى كلام وتتصرف أى تصرف، لا تختلف عن غيرها ولا يختلف غيرها عنها. هذا المسرح
العبثى ليس هو مسرح السيد حافظ بالتأكيد، لأنه - حتى فى هلوساته المحمومة
وتحليقاته - فهو لا يفقد الصلة بالأرض التى يقف عليها، ولا ينسى المكان والزمان
والناس والقضايا. إنه يبتعد - شكلياً - ليقترب مضمونياً. فقد نجد أن مسرحياته
بعيدة عن جزيئات الواقع، ولكنها قريبة من روح هذا الواقع. قريبة من لحد الانصهار
فيه.
عندما نقرأ -
كتبه الأولى نجد أن السيد حافظ عضو سابق فى جماعة المسرح الطليعى، الشئ الذى
يجعلنا نتوقف قليلاً لنتساءل : الطليعة - كمصطلح فنى - ماذا تعنى؟ يقول بيرناردورت
(كل طليعة هى أولاً انقطاع عن باقى الجيش، وهى كذلك رفض للنظام والسلوم المشترك).
فالأساس هو الانقطاع، الانقطاع عن الماضى والحاضر وعن كل المكونات التى صنعت هذا
الحاضر بكل سلبياته المختلفة. الانقطاع عن شروط الهزيمة، وهى شروط لها وجود فى
الإنسان وفى الرؤية المتخلفة للوجود وفى الفكر والمؤسسات والعلاقات والسلوك وفى
اللغة والفنون والآداب والأخلاق.. ويبقى أن نتساءل عن الطليعة، هل هناك فرق بين
مفهومها - فى الغرب ومفهومها لدى السيد حافظ وجماعته؟ أكيد هناك أكثر من فرق لأن
الانهزام العربى هو انهزام عسكرى سياسى حضارى تاريخى اجتماعى، انهزام يمكن تفسيره
وتعليله لأنه نتيجة حتمية لشروط موضوعية، أما الانهزام الغربى فهو انهزام وجودى
ميتافيزيقى، انهزام الإنسان أمام صمت الكون وانغلاقه وعبثه، ومن هنا فلا مجال
للتفسير والتغيير، فلا شئ حقيقى إلا العبث والخواء والعدم، هذا العبث الذى اتخذه
الإنسان الغربى (موقفاً وجدانياً من الحياة. قبل أن يكون موقفاً فكرياً من الوجود)
هذا العبث - فى بعديه الوجدانى والفكرى - هل نجد له صدى فى مسرح السيد حافظ، هناك
إشارة إلى العبث جاءت فى مسرحيته (الطبول الخرساء فى الأودية الزرقاء) ولكن ذلك لا
يكفى، لأن المضمون لا يعرف أن العبث ليس مذهباً حديثاً، وأن أوديب قمة العبث وأن
الأساطير والتراث تأكيداً والتغريب فى عدة وجوه ومراحل) هذا إقرار بأن العبث قديم
جداً، وأن له جذوره فى الماضى البعيد وامتداد فى الحاضر وما بعده، ويبقى أن العبث
- كإحساس باطنى أو كمفهوم أخلاقى - شئ والعبث كمذهب فكرى متكامل شئ أخر ويبقى
أيضاً أن العبث الغربى هو نوع من الترف الفكرى والحضارى، إنه القفز على القضايا
الاجتماعية والسياسية لمعانقة القضايا الميتافيزيقية المجردة، إنه تساؤلات ما
ورائية تتخطى الخبز والكرامة والعمل والحرية والعدالة الاجتماعية والاعتقال
والاستغلال والاضطهاد والقهر النفسى والجسدى والغربة والمنفى والتمرد للبحث عن
معنى الوجود.
عبثية السيد
حافظ يمكن ردها إلى أصولها الحقيقية لأنها مرتبطة بالوضع الاجتماعى المحدد،
مكانياً وزمانياً وليس مطلقة، إنها الكشف عن اللامنطق واللامعقول فى المجتمع، أى
فى العلاقات والمؤسسات وبهذا كان تمرده ثورياً، لأنه كفعل - يمكن أن يثمر التغيير
يغير الإنسان / المدينة / الدولة / الأمة..
عن البطل
المسرحى والأقنعة :
عندما نسأل، عن
أى شئ يبحث أبطال السيد حافظ فإن الجواب يأتينا كالتالى، إنهم يبحثون عن الممكن
وليس عن المحال،يبحثون عن مدينة يغيب فيها (ممارسة القهر على المواطن. وطمس كيانه
ومسخه بتمريره على أجهزة القهر والعجز والتخلف)
وإذ كان هؤلاء
الأبطال يقفون بين حدى الإيجاب والسلب فإننا نجد على رأسهم شخصية أبى ذر الغفارى،
ذلك (الصحابى الجليل الممسك بسيف الحق القابض على الجمر) إنه رمز التمرد عنده، وهو
تمرد اجتماعى سياسى يقرن الفعل النظرى بالفعل العملى ويزاوج بين كلمة الحق والسيف
الذى يحمى الحق وينصره، هذا البطل الملتحم بالناس وبقضاياهم اليومية يعيش النفى
والغربة، وذلك شئ طبيعى ما دام لحمه يحمل فكراً مغايراً وأخلاقاً مغايرة وتصورات
حقيقية للعلاقة بين المواطن والمواطن، وبين الرعية والراعى. ولأنه يرفض الواقع
المزيف فقد كتب عليه أن يعيش غربته النفسية والاجتماعية والفكرية.
- (وتموت غريباً فى أرض الله الواسعة
وتموت غريباً
بين خلق الله الجائعة
وتموت بعيداً
ولم تحسم القضايا
بين أغنياء
البلاد والفقراء العرايا)
تتكرر كلمة
الموت ثلاث مرات، وتتكرر (غريباً) مرتين وتبقى الكلمات الأخرى هى أرض الله الواسعة
وخلق الله الجائعة والفقراء العرايا وأغنياء البلاد مما يؤكد - نية التمرد لديه،
وذلك لنه فى حقيقته تمرد على التفاوت الطبقى الفاحش. (وبين قصور السلاطين والأمراء
بيوت الفقراء.
بلا طعام
والموائد تمتد
فى حدائق القصور الغناء.
بأطيب الطعام
وأنت هنا..
تشرب رملاً وتأكل رملاً هنا..) كما أنه تمرد على السلطة القائمة على القمع وعلى
التجسس على أنفاس الناس.
(بين كل رجل ورجل رجل من الشرطة السرية وبين صوتك
وصوت الناس التضليل والضلال المبين) وإذا كان اللا معقول يؤكدون على غياب المعنى
فى الوجود فإن السيد حافظ يشير إلى وجود المعنى ووجود الحق والحقيقة، ولكن هناك من
لا يريدهما فيعمد إلى التضليل والتجهيل حتى يغيب الوعى ويسود الجهل وتبقى الدنيا
كما هى الدنيا ساكنة من غير تقدم، وجامدة من غير تغير ولا تحول. هذا هو القناع
الأول للبطل فى مسرح السيد حافظ، أما القناع الثانى فيمثله (سيزيف) وسيزيف والواقع
هو رمز العبث الوجودى، إنه لا يحقق هدفاً معيناً ولا يصل عند حد ما. هذا البطل
العبثى يتسرب إلى مسرح السيد حافظ فنجده فى المسرحية التى تحمل اسم (سيزيف القرن
العشرين) ونتساءل. لماذا سيزيف بالذات؟ ولعل السؤال الأكثر أهمية هو كيف قرأ -
المؤلف الجديد الأسطورة القديمة؟ هل استنسخها - كما هى أم أنه أعاد كتابتها من
جديد؟ لا شك أن السيد حافظ لم يقدر التملص التام من جاذبية الفكر الأدبى الغربى،
خصوصاً وأنه كان يعيش مرحلته الإبداعية الأولى. ومع ذلك يمكن أن نقول بأن سيزيف
الجديد جاء وهو يحمل على ظهره هموم الإنسان العربى. فهو لا يعانى من أزمة وجودية
تتحدد فى حضور السؤال وغياب الجواب وفى البحث عن معنى للوجود وغياب هذا المعنى.
سيزيف عند السيد حافظ يزاوج بينا لهمين الوجودى والميتافيزيقى والهم الاجتماعى
المادى حيث نتلمس (مقالب السلطة والبيروقراطية) أن التمرد على العبث الوجودى هو فى
جوهره عبث لأنه (ثورة) على اللا متغير، إنه العبث الذى يواجه العبث فلا يثمر شيئاً
غير العبث. أما مسرحية السيد حافظ فتختفى (بالإنسان المتمرد على المواصفات
الاجتماعية والحضارية) أى أنها تتجاوز المطلق إلى ما هو نسبى، وتركز على الاجتماعى
المحسوس عوض أن تغوص فى الميتافيزيقا وفى المجردات الذهنية.
أما القناع
الثالث للبطل فهو الذى يمثله الفلاح عبد المطيع، وهو رجل بسيط، يعانى الفقر
والتسلط مطالبه محدودة ومتواضعة، ولكنه مع ذاك يجد نفسه محاصراً بين سلطتين
ظالمتين، سلطة الزوجة فى البيت وسلطة الحكم خارج البيت. وهو بينهما يعانى الكبت الاجتماعى
والسياسى. يفرح من غير فرح ويحزن من غير حزن، ويتزوج من غير حب ويفعل من غير
اقتناع. إنه يعيش داخل آلة جهنمية تسمى المجتمع، وهذا المجتمع قائم على اللامنطق.
فلا شئ فيه معقول، ولا شئ له ما يبرره. وهو مطالب بأن يسمع أوامر الحكم وان يطبقها
حرفياً. من غير أن يسأل عن معناها ومعزاها. حسبه أن يطيع فى البيت وخارج البيت،
حتى يكون أهلاً للاسم الذى يحمله، عبد المطيع. هذا البطل هو الحلقة الثالثة فى
مسرح السيد حافظ، وهو شخصية واقعية حقيقية بسيطة. وهو يختلف بالتأكيد عن (سيزيف)
المتمرد الوجود وعن أبى ذر الغفارى - الثائر الطوباوى.
ملامح الكتابة
/ الضد عند السيد حافظ :
إن الكتابة
الدرامية لدى السيد حافظ تتمرد على كل الأصول التقليدية. إنها الكتابة / الضد التى
تقف داخل وخارج الفن المسرحى. فهى كتابة تؤمن بالمسرح - كمظاهرة شعبية وإبداع فنى
وفكرى - ولكنها تكفر بقواعده البالية، وهى قواعد مستهلكة وقوانين جائرة ومستبدة.
وماذا يمكن أن يكون موقف كاتب مل الاستبداد سوى أن يرفض كل القيود - داخل وخارج
الفن المسرحى؟ وكذلك كان. فـ (عندما نشر مسرحيته الأولى عام 1970 "كبرياء
التفاهة فى بلاد اللا معنى" أثارت أثناء مناقشتها فى جمعية الأدباء بالقاهرة
جدلاً لا حد لغلوائه وعدم تعقله.. أطلق البعض يرجمها بدون هواده وبغير رحمة. لأن
هذا البعض صدمته غرابتها لما هو مألوف لديه) هذا الهدم هو فى جوهره هدم للصيغة
الغربية للمسرح، هذه الصيغة التى تريد أن تكون المسرح كله فى كل مكان وزمان وعند
كل الشعوب، ولكن أهذا ممكن؟ أهو ضرورى أن يكتب كاتب عربى من مصر - يعيش فى النص
الثانى من القرن العشرين - أن يكتب كما كتب موليير وراسين (كورناى) فى القرن
السابع عشر؟ إن إحساس الكاتب بأنه يحمل مضامين مغايره ألزمه بأن يبحث لها عن أشكال
مسرحية مغايره. وفى انتظار أن يعثر عليها فلابد أن يبدأ من حيث يجب البدء، أى من
هدم المسرح فى شكله التقليدى، وذلك ما فعل. قد يكون هذا الهدم فوضوياً فى البداية
لأنه لم يعطى البديل الفكرى والفنى، ولكنه هدم ضرورى، أولاً لتحطيم قدسية الأوثان
المسرحية، وثانياً لتوكيد الشعور بالحاجة إلى مسرح آخر. بعد هذا نسأل : ما هى
ملامح الكتابة التجريبية عند السيد حافظ:
يمكن أن نقول
بأن كل مسرحية لديه لها بناؤها الدرامى الخاص، فهو فى كل إبداع جديد يجرب شكلاً
جديداً. هذا البناء بأى شئ يمكن أن ننعته سوى أنه لا أرسطى، بمعنى أنه لا يلتزم
بقواعد أرسطو، سواء من حيث التمييز بين التراجيديا والكوميديا، أو من حيث الوحدات
الثلاث أو الحدث وتطوره التصاعدى وتأزمه وانفراجه، أو طبيعة الشخصيات ومفهوم
التراجيديا. فالحدث فى مسرحه موجود، ولكنه حدث ممهور بالغرابة. وهو غالباً ما يكون
ساكناً قائماً على الانتظار والترقب والترصد وإذا تحرك هذا الحدث فإنه لا يتحرك فى
خط مستقيم يصعد إلى أعلى. فقد يبدأ من الخلف أو قد يعود إلى الخلف بشكل سينمائى
(فلاش باك) هذا الحدث يبدأ متأزماً. ربما لأن الانفراج نوع من التفاؤل الكاذب،
وعليه فلا مجال للتمويه على النفس والكذب على الجمهور والقراء.
أما المكان فى
مسرح السيد حافظ فهو مكان مسرحى خاص، مكان مرتبط بالمسرحية كعالم جديد وكون جديد،
وبذلك فلا مجال للبحث عنه فى خرائط العالم. إنه المكان خارج الجغرافية. أما الزمن
فهو متحرر من الساعة ومن عقاربها، إنه الزمن الحلمى والاسطورى. وقد يحدث أن يكون
للمسرحية تاريخ محدد، ولكن هذا التاريخ يظل غائباً كوقائع - لها ارتباط بمكان محدد
وزمن محدد وأشخاص معينين - لأنه روح قبل كل شئ، وإحساس وظلال نفسية وفكرية. فالزمن
فى مسرحية (حدث كما حدث ولكن لم يحدث أى حدث) يدور (أثناء الحرب العالمية الثانية،
والمكان، مخبأ عام فى أحد أحياء الإسكندرية) أما فى مسرحية (الحانة الشاحبة العين
تنتظر الطفل العجوز الغاضب) فإن المؤلف يحصر الزمن (بعد أحداث خمسة يونيو - الفترة
الأخيرة من القرن العشرين الفترة التى
تبدأ فيها الشمس فى الاستغراق والظلام يزحف).
أما المكان فى
المسرحية فهو (جزيرة السمان - فى صحراء رام الله - فى خطوط المواجهة "السويس
والإسماعيلية" فى داخل الأرض المحتلة - فى بقاع آخر "من المجتمع")
وبرغم هذا التحديد فإن السيد حافظ لا يمهمه أن يقدم صورة واقعية وطبيعية للمكان
والزمان، لأن الأساس لديه هو ألا يكون الديكور واقعياً وذلك حتى لا يسجن ذهن المتفرج داخل بؤرة واحدة
ضيقة (الديكور رمزى - تجريدى - يستخدم أشياء بسيطة فى ديكور هذه المسرحية)
وتدور
المسرحيات الأخرى فى إطار مكانى / زمانى غريب. فمسرحية (ظهور واختفاء أبو ذر
الغفارى) تقع أحداثها (فى دولة "فردوس الشورى" (الفردوس الأخضر سابقاً)
أى أنها دولة ليس لها موقع جغرافى على خريطة العالم، لأنها دولة تقع على حدود
اللازمان واللاماكن، بمعنى أنها دولة "معنوية" تظهر فى عصور التخلف
والعجز والقهر والهزيمة) قد لا يكون لهذه الدولة وجود على خريطة العالم، ولكنها
بالتأكيد لها وجود فى الذهنية العربية، لأن الأسماء قد تتغير، ولكن المسميات تبقى
كما هى حاضرة موجودة وقائمة، فالمهم إذن ليس الدولة ولكن ما يقع داخل الدولة من
أحداث وممارسات. وإذا كانت التسمية غريبة فإن الأحداث والمواقف والشخصيات غريبة
منا جداً. فالمؤلف يترك للمتفرج حق القراءة الحرة القائمة على الإسقاط، إسقاط مكانه
على مكان المسرحية وإسقاط زمانه على زمانها الخاص وبهذا يصبح الواقع مرآة للمسرحية
والمسرحية مرآة للواقع، وتكون العلاقة بينهما جدلية). ومن أمثلة الأمكنة الفنطازية
مدينة الزعفران فى مسرحية (حكاية مدينة الزعفران) هذه "المدينة" ليست
مدينة واحدة بقدر ما هى مدن متعددة ودول كثيرة تتمدد على الخريطة - السرية للعالم
العربى والعالم الثالث حيث (تبرز صورة الحاكم الفرد المتسلطة الذى يمارس علناً
الاستئثار بقوت الشعب وثروته وامكاناته بالظلم والإرهاب والقمع ومحاولاته الدائمة
للتمسك بمنصبه وسلطته ضد كل القوانين والتشريعات والأعراف ورغم كل النكبات
والهزائم ومظاهر التخلف والفساد والخراب) كل هذا يؤكد الحقيقة التالية : وهى أن
السيد حافظ - فى تجريبيته - لم يفقد ارتباطه بالأرض التى يقف عليها. ويكتوى بحرها
وبردها وتخلفها وانهزامها وعذباتها.
الشعر بين
اللفظ والصورة :
أما من حيث
اللغة فهناك هذا التداخل بين النثر والشعر و"البناء الشعرى" عند السيد
حافظ لا يقوم على موسيقى اللفظ بقدر ما يقوم على الصورة الفكرية التى تنبعث من
البناء اللغوى. الشعر هنا شعر المضمون لا شعر اللفظ. وهو نوع من اللغة يبعث فى
النفس ذلك الحنين وتلك الوحشية إلى المثل العليا فى الوطنية وفى الأخلاق وفى
الدين، وفى التنظيم التى تبعثها الصور التراثية الشعبية من ملاحم وحواديت ومواويل وأشعار). فالمؤلف يستنطق الصور
التراثية.
هذه الصور التى
هى الشعر الحى المحرك أنه "الحواديت" فى أغرابها وأجوائها وعجائبيتها،
إنه المواويل فى جرسها وأنفاسها وآلامها وتأوهاتها، إنه الملاحم التى تتداخل فيها
الصورة والكلمة والمنفعة بالحيوية والحركة. فالسيد حافظ يفهم الكتابة الدرامية على
أنها (كل واحد لا يتجزأ. فلا شعر ولا نثر، لأنهما معاً يكونان لحظتين متداخلتين من
الوجود. فى البدء يختلفان، ولكنهما فى الأخير تنتهيان إلى شئ واحد. فى العمق لا
وجود إلا للشعر، أما فى السطح فهما يختلفان بالتأكيد/ وما بعد الاختلاف غير
الائتلاف، وما وراء الكثافة غير الشفافية. وما نهاية العلم إلا الشعر. وما خلف
الشعر إلا الحكم وهناك - عند نقطة معينة - تكف الأشياء أن تناقش بعضها البعض. لأن
الشعور بالوجود يصبح لحظتها مرادفاً للعلم بالوجود وذلك هو الشعر/ العلم والعلم/
الشعر) فالسيد حافظ فى تجربته الوجودية كثيراً ما يعمل إلى هذه النقطة التى ينتقى
فيها التناقض بين الأشياء. فيتحول النثر إلى شعر والشعر إلى علم والعلم إلى حكمة.
أى إدراك الأشياء من خلال العقل والقلب. ولعل هذا ما يفسر هذه الحرارة الموجودة فى
مسرحه وهى حرارة تنم عن التحام الذات بالموضوع وانصهاره فيه فهو يكتب عن عالم
ينهار، من غير أن ينسى أو يتناسى أنه جزء من هذا العالم الذى ينهار وبذلك فهو يكتب
بعنف وغضب وحزن، إنه يصرخ بصوت عال، ويفكر بصوت مرتفع. حتى أنه فى بعض الأحيان
تختفى الشخصيات كلها ولا تجد أمامك إلا المؤلف الممتلئ غضباً وسخطاً وشاعرية. إن
المهم لديه هو أن يكتب، وعلى حسب كثافة الحالات وتنوعها تتغير كتاباته، فتكون
نثراً أو شعراً أو كل هذا داخل العمل المسرحى الواحد. ففى مسرحية (علمونا أن نموت
فتعلمنا أن نحيا) نجد أن الإشارة الأولى - الفصل الأول - بالفصحى أما بالإشارة
الثانية فهى بالعامية. وفى مسرحية (الحانة الشاحبة تنتظر الطفل العجوز الغاضب) نجد
أن مجموعة الرجال تتحدث العامية، أما مجموعة النساء فتتحدث العربية الفصحى وقد يحدث
أن تتحرر اللغة من حدودها فتصبح حديثاً مسرحياً فيه شئ من الفصحى وشئ من الحديث
اليومى. فى الفصحى المؤلف رسم الحقيقى والتاريخى والنظرى. أما العامية فترسم لديه
اليومى والواقعى والحسى انطلاقاً من الأمثال الشعبية والحكايات والحكم والتعابير
السائرة وألعاب الأطفال اللفظية من مثل:
(سلام : شوف يا بنى .. حادى بادى (يشير إليه والى
نفسه) كرومب زبادى. بنت العسكر.. راجت تسكر.. مين سكرها.. قمح السكر..)
يبقى أن نشير -
فى ختام هذا البحث إلى أن التجريب فى مسرح السيد حافظ هو مجرد مرحلة، ويمكن أن
نعتبر مسرحية (حكاية الفلاح عبد المطيع) بداية مرحلة مسرحية جديدة، وهى مرحلة
التأسيس التى تأتى عادة بعد فوضى الهدم والتجريب. ففى هذه المسرحية يعود السيد
حافظ إلى التراث العربى وإلى الوجدان
الشعبى وذلك منأ جل صياغة لغة مسرحية، لغة تملك القدرة على التعبير عن الهم
العربى وعن فكره وروحه. هذه المرحلة تحتاج بالتأكيد إلى دراسة منفصلة، وذلك ما سوف
نحاوله مستقبلاً.
عبد الكريم
برشيد - المغرب
الدار البيضاء
فى أكتوبر - 1984
مجلة أدب ونقد
- القاهرة - العدد العاشر - يناير 1985