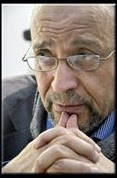خصوصيات التجريب و مظاهره في مسرح السيد حافظ
دراسة بقلم الهوارى بن يونس
الفصل الأول : التيمات الأساسية في مسرح السيد حافظ و علاقتها بالتجريب
قبل أن نباشر البحث في الموضوعات التي عالجها مسرح السيد حافظ سنتوقف قليلا عند هم الإشكاليات في مسرحنا العربي ظاهرة التجريب . فهي الإشكالية التي شغلت بال المسرحيين العرب و لا زالت تشغلهم . فمن خلالها تبرز الصورة التي ال إليها مسرحنا العربي . و الأشواط التي قطعها في رحلتة التجريبية .
تجيز لنا الدخول إلى عوالم غير مكتشفة " تأخذ بعين الاعتبار عناصر تكوينها و اختلافها عن وطاه السؤال الغربي .
و لتحقيق هذا المطلب العسير . ترد ضرورة تحرير كل إبداعاتنا العربية من الضغوط النفسية لظلال الغرب .و تمكينها من تخطي الكائن سعيا نحو الممكن . ليخرج المسرح العربي من " حجري رحا أخذت تطحن فية بلا هوادة " . لهذا الاعتبار . تظهر عملية التجريب . فهو ضرورة معرفية و فنية يساعد على تحقيق مجموعة من المقترحات الممكنة . لأنة يتضمن سمة التحرر من الجاهز و المألوف . فالتجريب فعل يعني المغايرة و التجدد . و يعتمد في ذلك على الافتراضات و الاقتراحات الممكنة .
و بمقتضى ذلك . يصبح للتجريب فعالية أبداعية هامة . تتزاح عن تكرار النموذج السابق . و ترتقي بالذوق العام للجمهور العربي من خلال ابتكار أساليب جديدة تكون قادرة على توفير الأبعاد الفكرية المتوخاة . و تحقيق المتعة الفنية المطلوبة تمشيا مع التطورات العالمية المنجزة في حقل الإبداع المسرحي العالمي . و من ثم يكتسي التجريب طابعا ديناميا تظهر فعليتة في سياق ثراء دلالاتة الفنية و الجمالية . و مدى انفتاحة على العالم الخارجي . فالتجريب رؤيا تجديدية تختبر الوسائل التعبيرية المسرحية . وتطوع مجموعة من المكتسبات التقنية المبتكرة قصد الحصول على الأدوات و الآليات المطلوبة في استيعاب الواقع و تغيرة . لذا فان أهم خاصية تتميز بها هذة الظاهرة التي توفرها مجموعة من الوسائط . كونة يتعايش فيها الأدبي و غير الأدبي ضمن تعدد قنوات الخطاب المسرحي . فالتجريب كما هو معروف لا يقف عند حدود النص الذي لا يعد إلا جزءا من مكونات العرض المسرحي . و إنما يتبلور أكثر في هذة المكونات . فالمخرج هو الذي يستغل بشكل أكثر إمكانية التجريب . لأنة هو الذي يضيف إلى النص كل ما يجعلة حيا فوق الركح عن طريق تلك المكونات التي يمثل كل جزء منها نصا دالا و معبرا .
و في هذا الصدد يقدم " بانريس بافيس " تعريفا للمسرح التجريبي مفدة أنة " مسرح يسخر كا الأشكال التعبيرية الجديدة قبل البحث . وذلك في علاقتها بعمل الممثل . و من ثم . فان التجريب يضع تلك المكونات في العمل المسرحي موضع التساؤل " كما إن مهمة تقضي الاستفادة مما يراة مناسبا من المدارس أو الاتجاهات و غيرها مما يندرج ضمن فعل التجريب عامة . بحثا عن أقصى درجات التواصل مع الجمهور .
وهذا ما يقتضي من عمل المجيين . الاسترشاد بمنارات أكثر توهجا في مجال البحث التجريبي . بقصد اكتشاف وسائل حديثة و ميكانزمات متطورة تعي صيرورة الحركة الثقافية . و لا تقف عند حدود هضم النظريات السابقة . و من ثم فان علاقة التجريب بحرية الإبداع تجعلةفعلا متخلصا من القيود ؛ لأنة يتجاوز ثوابها قصد بناء المغاير . لذا فان التجريب مغامرة تتميز بطابع مشاكس و مستفز باستمرار .
بيد إن هذة المهمة لا تنشا من الفراغ . فالعمل التجريبي الحقيقي لة أصولة . و ليس مجرد طفرة مندفعة . ولا يمكن لهذا العمل إن يتحقق آلا في ضوء ما انجزة الآخرون فعلا فبي الحقل نفسه . ذلك أنة كي تتقدم فلا بد أولا من النظر إلى الوراء .
فالتجريب إذا يسعى إلى تطوير تجربة شابه أو تجاوزها برؤية مختلفة . و لكن ذلك يقتضي من المبدع المجب إن يستوعب الأبدع الكائن قبل الثورة علية . ذلك بان حركة التجريب لا تخضع للزمن الثابت . و إنما تتغير باستمرار لتنخرط ضمن ورشة كبيرة من المفاهيم و الأدوات .
و إذا كان التجريب في المسرح الغربي يلتقي في كثير من مفاهيمة و اهدافة . فان هناك خصائص يتميز بها عن غيرة من المسارح الأخرى ز فما هي هذة المميزات في ضوء التراكمات المنتجة حتى الآن ؟ و ما هي علاقة التجريب في المسرح الغربي بالمسرح العربي ؟ و بصيغة أكثر وضوحا . ماهي عناصر الإتلاف و الاختلاف بين المسرح الغربي و المسرح الغربي ؟
قبل أن تجيب عن هذة الأسئلة . فلا بد آن نتوقف عن أهم المحطات التي شكلت مراحل تطورة . ز ماذا حقق فيها من تجارب لا شيما في القرن العشرين ؟
من المعروف إن إرهاصات التجريب الغربي لم تظهر في المسرح الغربي إلا مع نهاية القرن 19مع رائد المسرح الطليعي " الفريد جاري " واضع بذورالدراما الطليعية من خلال عملة المتميز " اوبوملكا Uburoi ".
وقد جسدت هذة المسرحية ثورة حقيقية على الدراما التقليدية و علىا لنزعة الواقعية السائدة . فسدت كثيرا من الفراغ الذي تركتة المدرسة السريالية . و قد استطاع " الفريد جاري " ان يبتكر أسلوبا جديدا في التشخيص . و اذ اقترح أسلوب الأقنعة في التشخيص بدل التمثيل المباشر المألوف . و تسللت إلي الأداء أجواء فنتازية امتزجت فيها السخرية المرحة بالحوارات الداخلية . لا سيما و إن النص يتحدث عن سخرية تلميذ بأستاذة . فكانت هذة التجربة نقلة كبرى مهدت لميلاد المسرح الطليعي . وهو مسرح كان المؤلف الروسي " تشيخوف " قد بشربة من خلال أعمالة الخالدة .
واهم ما ميز مسرحيات " تشيكوف " تجسيدها لقضايا المجتمع الروسي و معاناتة قبيل الثورة البلشفية . كما استطاع أن يمزج في مسرحياتة بين النزع الواقعية و التعبير الرمزي بعد ما أمدها بخيط رفيع جسد من خلا لة جو الاغتراب و القلق الذي تعيشة شخصياتة . و يمكن إن نشير في هذا الصددالى مسرحياتة نحو : " الشقيقات الثلاث – النورس – بستان الكرز – الخال فانيا و غيرها " . و قد شكلت هذة الأعمال مصدر إغراء للمخرجين . لا سيما الروس منهم . و على رأسهم " ستانسلاسفكي و مييرهولد " .
غير أن التجريب في المسرح الغربي لم يبلغ انطلاقة الحقيقية ألا مع نهاية الحربين الكونيتين بما خلفتة من أثار نفسية مدمرة . و امتعاض شديد . و هي أمور أفضت إلى الإحساس ببشاعة العالم ووحشية قاتمة الإنسان الأوربي عندما " نصبت هويتة الجديدة في قالب غريب و مرعب بدفعة بلا رحمة في نفق التقدم الآلي المعقلن . لقد بدا مؤخرا اكتشاف تكويم الجثث و الفظائع التي تمزق هذا الإنسان في اعماقة الخفية . ( و بهذا اقترنت ) " ولادة المسرح الأوربي مرتبطة عفويا بنشأة التحديث الأوربي . حيث تمزق الإنسان بين رحمة القديم و قالبة الجديد " .
ولم تكن تلك الرغبة وليدة تشتت الواقع الأوربي . بل كانت هناك طموحات فنية تتوخى هدم السابق من المسارح الكلاسية بدءا بالمسرح الإغريقي . و مرورا بالمسرح الديني في العصور الوسطي . و نمط المسرحيات البطولية التي عهد بها العصر الاليزابيثي . و الدراما العاطفية في القرن 18 . وصولا إلى الميلودراما في القرن 19 .
و من الذين قوضوا مبادئ هذة المسارح . نذكر رواد مسرح العبث من أمثال " صمويل بيكت " ( 1906 – 1989 ) و " يوجين يونسكو " ( 1912 – 1994 ) . و كان للفرنسي انتونان ارتو . صاحب نظرية مسرح القسوة الدور الكبير في تقويض النظرية الارسطية للمسرح . فقد عاد بالدراما إلى الأصول الشرقية القديمة " الباليني بخاصة " . ولم تتوقف رحلتة عند حدود الايديولوجيا . اذ استطاع إن يكون " ثوريا حقا . مثل كل المبدعين الكبار و لكن ثورتة ليست أحادية البعد و لا ثابتة و لا مؤدلجة " .
لقد فسح " ارتو " المجال إمام قدرات الجسد كي يفجر طاقاتة . و يخرج عن سلطة اللغة المنطوقة ضمن فاعلية " القسوة في تطويع قدرات الجسد الحقيقية بغرض الوصول إلى الصدق الفني . و بهذا يصبح الجسد . عند ارسطو . بديلا عن الفراغ . فهو إلى جانب المكونات السيوغرافية الديكور . الاكسسوارات . الإضاءة و غيرها " يؤدي مجموعة من الوظائف الدلالية و يساهم في خلق فضاء يعوض العلبة الإيطالية .
ولا يفوتنا إن نشير إلى جهود الرواد الآخرين . خصوصا فيما يتعلق بجانب الإخراج و قضايا التمثيل . و الإعداد الفني بعامة . و منهم رائد الثورة على القاعة الإيطالية الألماني ماكس رينهاردت ( 1873 – 1943 ) . و الروسيين مييرهولد ( 1874 – 1940 ) و ستانسلافكي ( 1863 – 1938 ) و يرجع الفضل لهذا الأخير في ابتكار أساليب جديدة في فن التمثيل . إلى جانب البوني ( جرو تفسكي ) صاحب نظرية " المسرح الفقير " ويعد " بريخت " أهم مبدع خالف المسرح الارسطي و المسرح الكلاسي عامة . فالية يرجع الفضل في فتح الباب واسعا إمام التجريب المسرحي . ذلك بان المسرح الملحمي لازال يشكل مصدر إغراء لمجموعة من الإبداعات المسرحية . و حقلا مفضلا لها بفضل اسهاماتة النظرية و التطبيقية في مجال المسرح بعامة .
بعد هذة الإشارة السريعة إلى أهم محطات التجريب الغربي نتساءل :
ما هي عناصر الائتلاف بين هذا التجريب في المسرح الغربي و بينة في المسرح العربي ؟
مما لاشك فية . إن التجريب الغربي يتميز بريبرتوار يجمع عصورا مختلفة . و هذا ما يفسر غايتة المتجهة صوب " الكفر بالمسرح التقليدي . و المسرح السائد . و هو كفر يتعداة المسرح الفن . ليشمل كل الكفر التقليدي بكل ما فية من المفاهيم و القيم الماضوية العتيقة " ذلك بان المسرح الغربي خلف رصيدا ابداعيا مهما على امتداد زمني طويل . كما افرز سيلا من الاتجاهات الفنية . و المدارس المسرحية . و هي صفات تخول للمسرح الغربي جواز الهدم بغية تأسيس المغاير .
و مع ذلك . فأنة بالرغم من خصوبة الحقول الإبداعية و تطور الجهاز ألمفاهيمي التنظيري في الريبورتوار المسرحي الغربي . لازال جل رواد المسرح الحديث متشبثين بأصول الفرجة القديمة و قد استلهم " ارتو " مصادر فرجتة من الأصول الشرقية القديمة المنحدرة من جزر بالي . فهي في راية تمثل المنابع الصافية للفرجة . و لا سيما و أن الأساليب الجديدة لوثتها اصابع المدينة الغريبة الحديثة . و هذا ما يشفع لنا القول بان : التجريب لا ينشا من فراغ . ذلك بان التجريب لا يلغي القديم . و أنما يتجاوزة . في حين أن قاعدة المسرح العربي تختلف في كونة يدشن " بداية طريق البحث عن صيغة عربية في المسرح " .
و من هذا المنطلق . فان التجريب في المسرح العربي يتقضي تجاوز النماذج المهيأة سلفا . و امتطاء أساليب ملائمة تتغرس في التربة المحلية من جهة . و تمنح من روافد طليعية تغتني حقل الممارسة بثمار جديدة تستجيب للذوق العام العربي من جهة أخرى . فالتجريب هو استمرار في البحث عن تقنيات جديدة . و استنباط مناهج ملائمة و جادة . و ابتداع صياغة جمالية تتناسب مع مشكلات العصر .
ومن ثم فهو . في جوهرة . رؤية أبداعية شاملة تنظر في مختلف عناصر الفرجة . بدءا بالنص باعتبارة بنية خطابية تتناسق أو تتقاطع فيها مستويات تلك البنية ضمن فضاء متعدد . و مرورا بالرؤية في مكونات الإخراج و السينوغرافيا باعتبارها تكملة للنص . أو إعادة خلق لة قصد اكتشاف علامات جديدة تختفي وراء ستار النص . و صولا إلى زعزعة عملية التلقي قصد ارتقاء بالذوق العام المسرحي العربي . لا سيما و إن المسرح العربي اليوم . كما يقول الدكتور علي الراعي . " أضحي جزءا من الوجدان العربي . و نمت لة عضلات . و طال لسانة . و ان تنقشع عنة هذة الغمامة من عدم الثقة و الرغبة في المحاكمة . و إصدار الأحكام التي تعوق تدفق الأعمال المخلصة و الجادة من أقلام الكتاب الجادين "
و يجدر التذكير بان عملية التجريب المسرحي في الوطن العربي قد انتلقت مع الرواد . و إن كانت الانطلاقة الرصينة لم تتبلور بوضوح إلا مع الدكتور " رشاد رشدي " . فقد استطاع هذا المبدع أن يقدم عملا متميزا في نهاية الخمسينات بشرت مسرحيتة المثيرة " اتفرج يا سلام " التي استلهم فيها شكل " خيال الظل الشعبي " و عبر من خلا لة على نضامين فكريب معاصرة . و بذلك استطاع أن يطوع هذا القالب الفني لمعاجلة قضايا سياسية و اجتماعية و فنية . و كانة يؤكد أن الإشكال الشعبية العربية الإسلامية تتضمن عناصر المسرحة على غرار إشكال الغريبة المعروفة .
و إلى جانب شكل خيال الظل الشعبي استعان " رشاد رشدي " بمجموعة من الظواهر الفنية المستمدة من البيئة الشعبية المحلية . كالأغاني و المواويل الشعبية و الأذكار الدينية و جعله تخدم قالبة الفني لتشكل كلها بناء فنية متماسكة . و لكنة . و في نفس الوقت . استفاد من تقنيات المسرح الحديث : كتقنية المسرح داخل المسرح . و الارتجال في تنفيذ الأدوار و قيام الممثل الواحد بمجموعة من الأدوار و غيرها . . .
و حتى يعطي يعطي بعدا ايجابيا للتجريب . عمد الدكتور رشاد رشدي إلى كسر الجدار الرابع بغرض رفع الإيهام . و خلق تواصل مباشر مع الجمهور . و قد تعددت سمات التجريب في عملة هذا . من خلال انفتاح الفضاء المسرحي على عدة مستويات روحية . كما تحددة هذة الإشارات المسرحية في مقدمة النص :
" ميدان من ميادين القاهرة في عصر المماليك في الجانب الأيسر . قهوة الشعراء و فوقها بيت سعيد صاحب القهوة. إلى جانب القهوة محكمة و فوقها بيت قاضي القضاة الشيخ عثمان حمزة . و في الجانب الأخر . بيت أبو المعافي . و أخوة سيد . و إلى جانية دكان الحلاق عبد ألعال . و قد ساعد تعدد الأمكنة على إضفاء جو شاعري للفضاء المسرحي . و اثرائة بمجموعة من الدلالات قصد تكثيف الأبعاد الفنية و الفكرية للمسرحية .
و من حيث اللغة . اعتمد رشاد رشدي على لغة و واضحة و بسيطة . اذ زواج بين اللغة الفصحى و العامية المصرية المطراوحةبين الشعر و النثر في تناسق ذكي بين الشكل و المضمون مستمد من عصر المماليك . الذي سادت فية . من سجع و جناس و طباق و مقابلة . . كذلك فان الشكل الفني للمسرحية مستمد من مسرح خيال الظل . مما يحتم فنيا و دراميا استفاة من الغنائية التي يتميز به المسرح " .
فقد استلهم رشاد رشدي خيال الظل من منطلق حدائي و استطاع أن يبعث لنا صيغة مسرحية ضاربة في عمق التاريخ العربي و الإسلامي . و قريبة من الوجدان الشعبي . حيث وظف خيال الظل في رؤية جديدة لا تتوقف عند حدود محاكاة الواقع . و إنما تتجاوز ذلك لتعيد تشكشلة فنية ضمن مسوغات التجريب التجديدية .
و من هذا المنطلق . اقترن " خيال الظل " بوظيفة جديدة . و إذا يصبح بمثابة الكورس في هذة المسرحية : غير أنة لا يوظفة المؤلف باعتبارة معلقا . آو متدخلا في الإحداث . و أنما يوظفة باعتبارة مكونا سينو غرافيا يقوم بمهمة الإنارة و ضبط حركات الممثلين .
كما وظف شخصية سعيد " صاحب خيال الظل " من منطلق تجريبي . فهو يقوم إلى جانب الجوقة بالتدخل في الإحداث . و المساهمة في بلورتها . كما نجد في هذا المثال :
سعيد : بقى في البلد السلطانية
أحوال الناس الاجتماعية دايما زفت و اطران
دا شيء كلة عرفينة
و عارفين كمان أن
اللي يقولة السلطان
أو خدامينة
يبقى كانة قران
أنزلة الرحمن
فلمل الدادبان
قال علي ابن النعمان
أنة مجنون . . .
أو كما جاء على لسان الجوقة :
- الجوقة : ( لحن جماعي مخاطبين المتفرجين على المسرح )
ألف تحيو و ألف سلام
بص و شوف الفرق بين الاثنين
ظلم و ضلال
من نرر و جمال
و مين اللي عمل الفرق دة
مين اللي حقق كل دة
انتم
و إحنا
و أحنا
و انتم
المصريين
و يبدو لنا أن الحوارات تسللت إليها لغة شعرية بالسجع . و تكرار فيها فيها مقاطع شعرية تتالف في نفس التركيب في مناسبات كثيرة و هذا الأمر يؤثر سالباعلى تماسك البناء الدرامي ,و مع ذلك فان هذة الحوارات لم تسقط في الغنائية التي كانت سمة اغلب النصوص العربية العربية خلال تلك الفترة , لأنها تجسد لنل مجموعه من الاحدلث و المواقف بكثير من الدرامية , و فضلا عن ذلك , فهي لا تتورط في الأسلوب التحريضي المباشر الذي يغلب على كثير من إعمالنا المسرحية العربية .
و يمكن القول : أن رشاد رشدي استطاع إن يستلهم شكل خيال الظل و يعيد صياغتة فنيا ليسلط من خلا لة اضواؤة على إحداث العصر المملوكي , و هي إحداث أو مواقف لا يخلوا منها عصرنا الراهن . و بذلك طوع مجموعة من الأساليب الفنية القديمة لصالح التجريب , كما مسرح عدة إشكال احتفالية ( كالرقص و الغناء ) في أسلوب حكائي يستوعب قضايا العصر , و يلبي الذوق العام للجمهور العربي .
و قد بشرت هذة الخطوة التجريبية في المسرح العربي بميلاد محاولات عدة شكلت الإرهاصات الجادة للتجريب , سنجد لثارها و أضح في الستينات مع يوسف إدريس و توفيق الحكيم و علي الراعي و محمود دياب و غيرهم ممن كانوا يبحثون عن قالب ملائم يؤسس مسرحا عربيا قائم الذات , و يتوحد مع الجماهير العريضة في الوطن العربي .
بيد أن هذة المحاولات سواء على مستوى الأبدع أم الكتابات التنظيرية بقيت " متعثرة حينا و خجولة حينا آخر , حتى كانت هزيمة 1967 التي ابانت عن إفلاس الهياكل السائدة في المجتمع العربي . و بذلك صار التفكير جادا أكثر في خلق هوية متميزة للمسرح العربي "
و بموازاة لتنامي البعث التحرري الفكر النهوضي العربي , تواصلت اسهمات المبدعين العرب على الرغم من أنها لم تستطع حتى الآن إن تشك مذهبا خاصا يجمع ستات الاجتهادات المسرحية العربية نتيجة اختلاف الحقول الفنية و المرجعيات مختلفة المشارب .
على أن هذا الفعل التحرري لم يمنع من تبلور النضج الفني الذي يتجاوز حدود مجاراة النمزج الغربي , و ابتكار أشكال بكر تتلام مع الذوق العام , بل و تساهم في ترقية هذا الذوق . و في الوقت نفسة تستجيب لمتطلبات الواقع و تحولاتة . و بمعنى أخر فان صفة التجديد تبقى واردة , لان كل تجريب يسعى إلى تأسيس المغاير و الإبحار في محيط المغامرة , دونما تقيد بضوبط محدودة , و تعاليم سلطوية في سياق الوعي بمهمة التجريب المنوطو ب " محاولات التحلق فوق الواقع , وصولا إلى تحقيق حلم التطور الفني الذي هو في الوقت نفسة ليس منفصلا عن حلم الإنسان الذي يهدف الوصول لحالة أفضل "
فمن آفاق التجريب إدراك الارتقاء بالفن نحو الأفضل استجابة المبدع نفسة , و لتطلعات مجتمعة من جهة ثانية في سبيل البحث عن شكل و معنى جديدين يكونان أكثر ملائمة , و أكثر تعبيرا عن قالبنا و روحنا , و أكثر كشفا عن تيمات حياة الشعب في غالبيتة العظمى و مفارقة هذة الحياة و تخديمها التخديم الفني الصحيح . تتضافر . بمقتضاة . هذة المسوغات في تقديم الحيوية المطلوبة , و الحركية المتدفقة في الخلق و الابتكار ليظل هذا العامل " متحركا ما لم تتوقف عملية التجريب نفسها " .
لكن مهمة مثل هذة تتطلب الإلمام بحصاد تجارب إنسانية تتفاعل فيها مختلف التراكمات الثقافية , و الخبرات الإنسانية , لان هذا الأمر يوفر للفنان ثراء معرفيا و فنيا .
فانفتاحة على العالم الخارجي , و واطلاعة على مكونات التراث العالمية المضيئة يعد مطلبا ضروريا باعتبارة " إن قيام أي عمل تجريبي في ثقافة محلية معزولة و مختلفة غير قادرة على الاحتكاك و التداخل مع الثقافات الأخرى مسالة غير ممكنة على الإطلاق . . و من هنا فان خصوصية التجريب تتمثل في كونة عملا إنسانيا خلاقا " .
بيد إن حتمية السجال الثقافي بين التجريب في المسرح الغربي و التجريب في المسرح العربي افرزت سمة ولع المسرحيين العرب ببعض المدارس الغربية , و انبهارهم بالاتجاهات الأجنبية دون مراعاة الخصوصية المحلية للذوق العربي العام . و بهذا من شانة إن يرسخ فكرة المركزية الغربية المغلوطة . " و لكي نجرب لابد إن نفعل مثل بيتر بروك أو شانيا او بريخت , أي إن التجريب مرادف للانسلاخ عن الذات , و إن تقفز على ما هو مضموني و روحي , و تعانق مع ما هو شكلاني محض "
و لقد كان لهذا الموقف اثار سلبية على استنباط الأبعاد الحقيقية للتجريب الذي ظن فية البعض أنها حركة توازي العبث أو إلا معقول و الغرابة الذاهبة في صوت الإبهام . و قد ساهمت هذة الفكرة في قص جناح الإبداعات العربية حادت بها إلى الميوعة الفنية .
و هي القاعدة التي تنطبق على مهرجان دولي من حجم ملتقي القاهرة السنوي للمسرح التجريبي الذي يغرق اغراقا كبيرةا في الجانب الاستعراضي , لا سيما و أن هذا الجانب يعد مقياسا كبيرا للظفر بإحدى الجوائز المخصصة في المنافسة بين العروض .
و لما كن الانفتاح على الاتجاهات العالمية لا يخلو من أهمية تتجلى نتائجها خاصة في حقل المواهب , فأنة من جهة أخرى ينطوي على سلبيات قد تؤدي بأغلب المبدعين المسرحيين العرب إلى الابتعاد عن الإمساك بخيط المسافة الرابطة بين الشكل و المضمون و تغريب الملتقى العربي بابتعاد عن ذوقة باستعارة تقنيات غريبة عنة . لأنة اقتباس الإشكال الغربية و إفراغها داخل وعاء واقعنا العربي , يفضي إلى نتائج عكسية تعلوفيها الكفة لصالح الشكل .
و قد تنعكس هذة المعادلة ليصبح المضمون سيدا لصالح اكبر ظاهرة طغت على سطح مسرحنا العربي , و هي التصاق التجريب بالسياسة , حتى أصبحت هذة الأخيرة . و على رأي الدكتور مصطفى رمضاني الحصان الذي يجر عربة المسرح , و ليس العكس كما ينبغي إن يكون . و مهمة المسرح العربي , آو بالاحرى مشروعة الهام يتاسس على ما يقدمة من رؤى جمالية لا تتعالى فيها المواقف السياسية و الأيديولوجيات المغرضة , ف " الناتج الذي يرفعة شعارات هو وسيلة الأعلام عليها إن تغير حاكم . . . أما الفن و الأدب . . فهما اقرب إلى الثبات و الالتصاق بالتكوين التربوي للكائن و الفرد و الجماعات " . و لنا من الامثلة ما نقيس علية هذا الدعم فإعمال العظماء من الأدباء و الفنانين لازالت تحتفظ لنفسها بصفة الخلود , إما المذاهب السياسية التي ساقتها فقد توارت مع مرور الزمن . فإبداعات " بريخت " الكثيرة لازالت مصدر اغراء لمختلف المسرحيين على اختلاف جنسياتهم , بما قدمتة من إنجازات مهمة في جانب التقنيات الفنية و السيوغرافية . في حين إن دعواتها للماركسية سرعان ما تحولت إلى خيط دخان سابح .
لهذا و بعد إن وعي المسرح العربي و جهتة , و خطورة المسالك المؤدية إليها , فانة إن الأوان لان يرسم خطاة العاكسة لجسدة المتغدي من روح بيئتة المحلية و مناخة الخاص بة . فبعد إن عرف الإنسان النوع –حسب تغير غز الدين المدني – علية إن يولى وجهة شطر الإشكال الوفيرة التي يختزنها تراثة كي يحقق مكسب الانفلات من التبعية التي تجاوزت " حدود الدهشة و الاندهاش . على المسرح الغربي في الشكل الذي بدا فية " . و هو المطلب الذي أصبح ينادي بة اغلب النظيرات العربية التي يراود حلمها تحقيق التصورات المقترحة بما يتناسب مع الجوانب التطبيقية لإعمالها .
كل ذلك كي لا يتبقى " مجرد ممارسات هلامية و غافية " اذ عليها إن تتساوق " في سياق مسرحي يراعى جدلية التفاعل بين الفن و كل العوامل التي تتحكم بالإنسان العربي و قضاياة " . و هي مهمة شاقة لا تاخذ طريقها إلى النهج الصحيح إلا باستمرار عدد كبير من الإبداعات , تنم عن بزوغ نهضة حديثة للمسرح العربي إلي أصبح بصيص نورها يبرز نسبيا . غير أن اكتمال اشعاعها يظل بعيد الآمل إذا لم تراع ذاتها .
و يبدو إن أفضل سبيل لا جتناب تكرار النماذج المسرحية الغربية يقتضي الإلمام برسالة المسرح السامية بما تقدمة من إعمال تخدم المتلقي في إطار العام بدل اللجوء إلى تكويم النظريات , و استيراد المفاهيم الغربية عن ذوقنا .
و من ثم فان الإجابة عن إشكالية التوفيق بين المحلي و العالمي في التجارب المسرحية العربية و تكيفها مع خصوصياتنا العربية و الإسلامية .
و فضلا عن ذلك . فان تعدد مستويات الخطاب المسرحي يقتضي ايجاد المعادلات المناسبة بين المستويين الفكري و الجمالي باعتبارهم يشكلان نسيجا متكاملا ضمن مكونات الخطاب النصية و الإخراجية و السينوغرافيا ككل .
و تأسيسا على ذلك , فان مقاربت إشكاليات التجريب في المسرح العربي يمكن إن نحددها في مظهرين اثنين , فالمظهر الأول , يتحدد في طبيعة العلاقة بين التجريب في المسرح الغربي , و هو تعاقد يندرج في سياق علاقة الذات لأخر , و حتمية التبادل الثقافي . و هذا الأمر يطرح إشكالية إثبات الذات , و حوافز المسرح العربي في البحث عن هويتة .
إما المظهر الثاني لهذة الاشكاية , فيقترن بإيجاد مواصفات جديدة , و صيغ ملائمة للفرجة المسرحية العربية بلغة خلق شروط مناسبة لاكتمال الفعل التجريبي في المسرح العربي .
إن التجريب في المسرح العربي يتميز بخصوصيات منفردة تكتسي خطورة بالغة , و هي تقدم إشكاليات متداخلة تقترن أولاها بالهم التأسيسي , إما الإشكاليات الأخرى , فيمكن إن نصلها بطبيعة التجريب نفسة , و بهاجس المجريين المرتبط بالبحث عن الصيغ المغايرة و المختلقة لحدود التجارب السابقة .
غير إن تداخل الخبرات الإنسانية , و تعايش ثقافاتها ضمن نسيج عالمي يسير أشكالا أكثر , قد تتشابة بموجبة الأعمال المسرحية .
و في ضوء هذا الكم الهائل من المبادرات العالمية و الإنجازات الغربية يتعدد مدارسها و مناهجها . كيف يمكن للتجريب العربي إن يؤسس فرادتة و يصبح فاعلا في الثقافة العالمية على غرار التجارب الإنسانية الأخرى دون التضحية بالخصوصية الاجتماعية و الحضارية للأمة العربية ؟
في سياق هذة المهمة الصعبة . كيف يمكن للطاقات المسرحية العربية إن تخلق مسرحا يتميز بخطاب يختلف عن قاطرة المسرح الغربي ؟
إن المسرح كحياة يتجدد و يتطور بطور المواقف الإنسانية و تغييرها . فمنذ نشاتة الأولى بين معابد اليونان , و الإنسان يحاول إن يكتشف سر جاذبيتة , و ينصت إلى صخب أبطالة و هم يتصارعون مع قوى ميتافيزيقية تكبك جماحهم . غير إن هذا الإنسان بحكم ايمانة بقدرة التجاوز رأي إن يكسر الجدران , و ينتقل إلى جوهر الصراع الذي يربطة بالحياة . و بذلك أخذت الكتابة المسرحية تكسر لحظتها الآنية لبناء و اقع أخر , و هو مبدؤها الذي لا تتعالى عنة , و لكنها تسمو بة بعد إن تستوعبة و تنتج معرفتة .
و في الوقت نفسة تحاول إن تكسر تلك اللحظة , و تعبر عنها بطريقة جمالية تعبق بالتوتر الحاد و ترفض الاجترار , كما يقول المرحوم محمد مسكين , " أن تكتب مسرحية يعني ان تعيد بناء الأشياء و الناس . إن الكتابة المسرحية هي فصل يحدث الشرخ في السيرورة المتزنة للواقع . لهذا فهي كسر للتوازن الظاهري " .
غير أن هذا الأمر يقتضي وسائل جديدة قادرة على نبذ الاعراف الفنية التقليدية السائدة التي لا يستجيب للفئات العريضة من متذوقي الفن الدرامي .
و كان الدراماتورج . السيد حافظ . ولا يزال من خلال ابداعاتة المتدفقة واحدا من هؤلاء الذين جسدوا التوجة الصحيح القائم على استكمال المقومات التعبيرية الدرامية , في افق تاسيس كتابات واعية منذ الستينات .
الا إن هذة اليقظة لم تتبلور بشكل واضح , لا سيما في ظل ألازمة السائدة للمسرح المصري الذي سادتة نظرة كانت تعتقد إن المسرح " مجرد دار عرض للتسلية و الترفية , و انتاجة لا يعدو ان يكون ساعة من سلع الريح تدخل تحت اسم تجارة الضحك و التسلية و التجميل و كسب الغفلة و التحجر و الجمود " .
فوسط ضباب كثيف من الأعمال السائدة آنذاك , ازدهار المسرح التجاري و كاد ان يحجب المحاولات التي انبعثت في فجر سادة ظلام تلك الفترة . و قد لعبت الدولة دورا سلبيا ساهم في انحسار المسرح الجاد بسبب الحمالات المعادية لكتاب المسرح , و الممارسة الرقابية للنصوص المسرحية . كما ساهمت الهياكل التنظيمية لمؤسسات المسرح في انحدار المستوى الثقافي . و بذلك ساهمة سياسة التهميش في " انحسار المسرح الجاد . و انطفاء الجذور الثقافية الإنتاج المسرحي عموما " .
و تتصالح أوضاع أخرى لترسيخ الوضع في المسرح المصري , على وجة الخصوص , و المسرح العربي عموما . الا و هو فساد الذوق العام الفني للجمهور المقابل على هذة الإعمال التجارية . و مما يزكى هذا التدني الملحوظ ان الجمهور يظل سلبيا و بعيدا عن المشاركة في الخلق و الإبداع . فضلا عن ذلك . لم تتحرك حركة التأليف المسرحي في الساحة المصرية اهدافها المنوطة بها . فقد فش ثلة من المؤلفين من أمثال محمد عناني و سمير سرحان و عبد العزيز حمودة و فوزي فهمي و علي سالم و غيرهم في بلورة وعي فني واضح , و نضج جمالي يستجيب للدراما المعاصرة , و يفي لمتطلبات الواقع الجديد , و أنما سقطت إبداعاتهم في فخ الإسقاط السياسي و الاستعراض التراثي المباشر في غالب الاحيان . و يبدو ان هناك عوامل متعددة لخصت ب " أوزوريس إلى ان يخرج من قاع النيل كي يعانق ايزيس " التي يقول عنها السيد حافظ " فعشيقتي ايزيس تهبني في كل رحلة سرا من أسرار الحقيقة , تهبني رفضا منقوعا في شريان الوعي "
فقد كانت ايزيس – أو مصر – هي التي امدتة بخصوبة الفن , و الهمتة ينابيع التجريب الصافية التي كدرها احتقار المتطفلين . و في هذا يضيف السيد حافظ : " جيلنا من الكتاب الذي لم يظهر إلى الآن , جيل رائع ملئ بأشياء خفية مكتوب عليها ممنوع الاقتراب من هيئة المسرح و الثقافة الجماهيرية , لان الهيئة احتكار للمفلسين فكريا . و الثقافة الجماهيرية مرتع للفوارغ من كل شيء في الاقلام " .
تسلل هذا الفتى الاسكندراني إذن بين أحشاء الدروب المقهورة , و فتح عينية على الكنابة و عمرة لا يتجاوز ربيعة الثاني و العشرين , فأعلن بذالك عن قرب نهاية خريف المتطفلين . و كانت الانطلاقة مع أحدى المسرحيات التي دخلت التجريب من بابة الواسع , و يكفي عنوانها المثير دلالة على ذلك " التفاهة في بلاد الا معنى " سنة 1970 .
و لم تكن هذة الباكورة لتسلم من الهجوم الشرس , بل و الرفض القاطع . فخلال الندوة التي اقامتها جمعية الدراما بالقاهرة لمناقشة هذة المسرحية انطلقت سهام النقد معلنة عن مقاطعة هذة الإعمال . و قد قام المبدع علي سالم خلالها ليعلن رفضة لمثل هذا التجريب المسرحي لأنة " تخريب في المسرح , و في عقلية الجمهور , و لن يقدم هذا العمل , انني لو حكمت لطلبات إطلاق النار على مثل هذة الإعمال التي لا تبتني الإنسان و لكنها تهدمة " .
لقد كانت تجربة تخريبية للشكل المسرحي السائد , و لكنها كانت تسعى إلى التبشير بأسلوب جديد في الكتابة . و بذالك كانت هذة المسرحية تمثل سابقة تسمو بعقل الجمهور و بذوقة من اجل بناء تصور جديد و ذوق مغاير و نمط مخالف للسائد و الجتهز من المسرح العربي . فالمسرحية تؤكد هذا الجانب التجريبي . " فشخصية المزيع " في المسرحية فقدت تواصلها مع العالم . و لم تستطع ان تعبر عن طموحاتها الفنية لاصطدامها بارض الواقع . و كانت رحلتها شبيهة بالحلم . لهذا قرر المذيع , الذي هو صوت الكاتب نفسة . أم يقف عجلاتها . و هو موقف طليعي يعكس طموحات السيد حافظ المصر على تقديم المغاير و الجديد . و هذا ليس غريبا من مبدع خرج " من خميرة ارض النيل كالصاعقة , أو كالنار على الشارع المصري و كان يلتقط أنفاس البحر , و يحمل نهر الكلام ز الرؤيا و يحمل موجات الإبداع للشارع الثقافي العربي . و قد اقتحم المسرح الطليعي حتى يكشف القناع عن الحرف العربي . و الظلام عن الاستعارة و يمحو الضباب عن الكتابة " .
و قد استطاع السيد حافظ . من خلال هذة المسرحية الشبيهة . بالكارت بوستال . كما يصفها احد النقاد ان يغرس بذورا تجريبية جديدة . و يختلس تركيبات الواقع البئيس بطريقة غير معهودة . فقد ابرز مظاهر التجريب بشكل مثير , لا سيما حين وظف أشياء جامدة لكرسي . فانيلة مثلثات . ميكروفون . . . " باعتبارها معادلات لأبطال بشريين . و هو توظيف ذكي استطاع من خلالة السيد حافظ ان يفجر اللغة بكل ما تحملة من أبعاد رمزية و ايحاءات مكثفة لتعكس بكل مرارة مفارقات " العصر الذري الحجري ( البرونزي ) في القرن الفوضوي , في ارض الا محدود الملوث " .
و لم يكن هدف المؤلف مجرد التمرد على إشكال القوالب الراكدة , بل كانت هناك عوامل أخرى ساقتها الظروف الاجتماعية و السياسية المثقلة للمجتمع المصري بخاصة , و المجتمع العربي بعامة .
و سنحاول ان نكشف عن علاقة التجريب عمدة بهذة العوامل , و كيف ساهمت في تطوير تجربتة الإبداعية في مجال المسرح