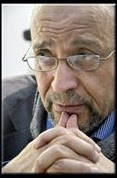مسرح الطفل الحقل الخصب لتفتح البراعم الجديدة
جريدة الرّايَة
ملحق العدد 1209
الأربعاء 16 نوفمبر 1983م
كتب فيصل السعد – الكويت
البدر والمنصور .. أكدا إمكانية تبنى مسرح الطفل العربى
ذهن الطفل عموماً حقل خصب جاهز لاستقبال كل البذور.. ولكن تظل البذور غير قابلة للنمو لأنها تشترط السقى المستمر والمدارات.. إذ أن نمو هذا البذر أو ذاك يشكل انطلاقة محسوسة عند الطفل وهذه الانطلاقة تصبح باعلانها هوية تصاحب طفلها حتى الكبر وبواسطتها تعرف الممثل ، الشاعر، الناقد، القاص، المهندس، العالم.. الخ.
وحب التسنط الذى يمارسه الطفل منذ بداية حياته هو جوع تعيشه خلايا ذهنه لمعرفة ما يدور حوله واختيار الأفضل منها.. وهذه الممارسات تكون مفروضه عليه لا يستطيع اقفال أبوابها إذ أن بدايات التحرك الذهنى تكون لا إرادية وغير متعمدة.
إذن لابد من احتضان الأطفال من أجل أن توجه أذهانهم إلى الدرب التى يعتقد هذا المحتضن أو ذاك بأنها قابلة للإبداع وأكثر خصوبة من الدروب الأخرى، وذلك عن طريق احتضان الطفل وإدخاله فى تجارب عديدة من أجل التأكد من حيله وحبه لهذه الممارسة أو تلك.
وهذا الاحتضان من شأنه أن يبعد أطفالنا عن عملية التسنط والبحث المرفقة وغير القادرة على توجيه الطفل لأنها تترك له مهمة الخيار دون أن تدله على الدروب الصحيحة والمنشطة لخلاياه الذهنية وخاصة الثقافية منها .
اطفال الخليج – للأسف – لم يرثوا عن أبائهم غير أغانى البحر، ورغم فنية هذا الميراث إلا أن الالتزام به يؤدى إلى شل الامكانات الأخرى المتوفرة والمتحفزة فى ذهن الطفل.
مؤسسة البدر الكويتية أدركت هذه الحقيقة فأنشأت "مسرح الطفل" من أجل أن ترعى وتنمى أذهان الأطفال التى تحتوى على رغبات مسرحية متحفزة لصعود خشبة المسرح لتجعل منها مستقبلاً ، أذهاناً قادرة على العطاء والمشاركة فى تنمية الروح الإيجابية لدى الطفل، والتى تشمل الأخلاق بكل ما فيها من استقامة واحترام للذات وللآخرين.
عواطف البدر تحسها حين تقف قبالتها بأنها لازالت – وبإصرار – متحدية لكل عواصف الصمت التى تجابه بها إزاء أعمالها الستة التى قدمتها. رغم أن الحقيقة تقول أن مسرح الطفل لا ينتهى دوره عند غلق الستارة بل أن أى عمل على هذا المسرح يشكل بداية تكون خطواتها الأخرى فى البيت، المدرسة، الصحافة، الإعلام، الشارع.
إلا أنه .. وللأسف مرة أخرى.. الواقع الصعب الذى يعيشه مسرح الطفل فى الخليج حوله إلى مكان لهو يستطيع أن يسرق الأطفال من أحضان امهاتهم ليمنحهم الفرصة للتبرج من أجل الزيارة أو التبضع فى الأٍواق.
مسرح الطفل درس يجب أن تشرب جرعته العائلة قبل طفلها إذ أنه يدل على التربية الجيدة، الاعتناء وطرقه، توجيه الطفل.. ولكن، لا حياة لمن تنادى.
لذلك لا يمكننا – أو لا نملك وهى الأصح – إلى الشد على يد البدر بحرارة رافعين حواجبنا استغراباً لهذا الإصرار.
السندريللا
هذه الحكاية القديمة التى تكاد تأخذ عمر الأسطورة لازالت – رغم قدمها – تمثل مادة صالحة للمسرح .
تناولها الكاتب سيد حافظ لتكون العمل السادس لمسرح الطفل وطبيعى أن إعادة صياغة أى عمل بإضافات بسيطة تمنح الكاتب شرعية إدعاء تأليف العمل.
ولكن كان من الأفضل استبدال كلمة "تأليف" بكلمة "إعداد" لأن هذه الحكايات القديمة حفظها الصغار والكبار بشكل مختلف من واحد إلى أخر، وبالتالى وعند مشاهدتهم لمسرحية السندريللا لا يمكنهم اقناع أنفسهم بأن هذا العمل من تأليف السيد حافظ ومن شأن تفكير كهذا أن يبعد المشاهد عن متابعة فنية العمل إخراجاً وتمثيلاً لأنه يكون لاهيا بالفارق الذى استحدثه الكاتب لاعطائه شرعية ادعائه.
ولكن الذى قرأ أو اطلع على اخر سندريللا كتبت سيجدها تختلف بهذا الشكل البسيط أو ذاك عما كتبه السيد حاف.
وباستثناء كلمة "تأليف" استطاع الكاتب أن يستغل حكاية سندريللا استغلال مقتدر لينتج هذا العمل الناجح.
ولا شك أن الكاتب أهلاً للكتابة المسرحية ولدى قلمه أكثر من دليل على هذه الحقيقة.
المخرج منصور المنصور
الذى يصر على قضية ما يكون متعلقاً بأمل قد يوصله إلى الدرب الذى يريد واعتقد أن إصرار البدر جاء من خلال استمرار مخرج هذا المسرح الاستاذ منصور المنصور الذى زرع البذرة الأولى ورعاها ووعد بانها ستثمر واستطاع أن يحقق ما وعد به.
المنصور شكل عالم طفل حديث النمو ولكنه منحه القدرة على العطاء وما عاد يعنى حكايات الصغار فقط.
فمن خلال المتابعة لديكور المسرح، الحوار، الحركات، الملابس، المكياج يمكن أن يفهم المشاهد بأن هناك أموراً عديدة منع الكبار من الصراخ بها ولكن المنصور استطاع أن يجاهر بها عبر حناجر الأطفال ، صيحاتهم ، رقصاتهم، ضحكاتهم.
ففى هذه المسرحية عرفنا الفقير، الغنى، السلطان، الأمير ، زوجة الأب الظالمة، طفلة الزوجة الأولى المظلومة دائماً.
ولأن المنصور يدرك أن اليد الواحدة لا يمكنها التصفيق واتمام العمل بالشكل الذى يريد لذلك فقد اختار الفنان ماجد سلطان ليكون مساعداً للمخرج وقد استطاع أن يقوم بمهمته على الوجه الأكمل.
ولأن انجاح أى مل على خشبة المسرح لا يمكن أن ينسب للمخرج فقط إذ أن الأيادى الأخرى كان لها الدور شبه الرئيسى فى العمل لذلك لا يمكننا القول بأن هذا المسرح هو مسرح البدر أو المنصور أو .. أو.. أنه مسرح الأذهان التى اتحدت لرعاية طفل هذا القرن.
الملحن طالب غالى
متابعتى لأوتار هذا الملحن اقنعتنى بأن اختياره يشكل أفضيلة عن الأخرين إذ أنه منذ أعوام تجاوزت العشرة وهو يمارس العمل فى المسرح الغنائى ، وبديهى أن المسرح الغنائى بحاجة إلى ثقافة موسيقية موسعة يكون حاملها قادراً على فرز اللغات الموسقية من حزن ، وفرح ، وقادراً أيضاً على تحريك كوامن الصغار من خلال النغم الذى يعشقون.
فى مسرحية السندريللا كان طالب غالى يتحدث بموسيقاه عبر ألحان زرعت فى أذهاننا الملامح الرئيس للغة الصغار ، لذلك استطاع أن يزرع الفرح حتى فى أذهان الكبار ، ويزرع الحزن حين يتطلب الموقف بحيث كانت موسيقاه عاملاً مساعداً على تقريب مضمون المسرحية من أذهان الجمهور ولا شك أن الذى ساعده فى الوصول إلى هذه النتيجة الجيدة هو شاعر الأغنية فلاح هاشم الذى قرأ النص أكثر من مرة قبل أن يكتب أغانيه.
إن الامكانات الموسيقية الجيدة المتوفرة فى أوتار عود الملحن غالى تشجعنا على المجاهرة بضرورة استغلالها فى انجاح الاستعراضات الغنائية سواء كان للطفل أو للمسرح بشكل عام.
الدكتور حسن خليل
طبيعى أن الألحان المتوفرة من شأنها أن تشكل البداية الاستعراضية للوحات التى يحتويها أى عمل مسرحى وقد استطاع الدكتور حسن خليل أن يشكل اللوحات الاستعراضية التى لا يمكن الصاقها بلحن أخر غير الذى طله به غالى.
ومن خلال المتابعة للوحات التى شكلها الدكتور خليل فى هذا العمل ندرك بأن حضوره أثناء البداية الأولى للإعداية جعله يعرف تماماً ما يحتاجه هذا العمل من لوحات، ولذلك فإن ماشاهدناه فى الرقص والحركة كان يمثل لغة مسرحية مكملة لحركة المخرج ووتر الملحن.
الممثلون
من أجل أن يتقن الممثل دوره لابد له من أن ينسلخ من حاضره ويستبدل دماءه بدماء عصر جديد تنثه الشخصية التى سيمثلها والاتقان الذى حققه الممثلون يؤكد بأن حوارهم كان معهم فى المدرسة، الشارع، البيت، الفراش والذى يؤكد هذه الحقيقة هو الأداء الجيد الذى أبدوه وخاصة أن معظم أشخاص المسرحية كانوا أطفالاً ، والطفل يعصب عليه الحفظ دون تلبس صفات الشخصية التى يحفظ لها كما يتصورها هو لذلك نجد اطفالنا يؤدون القصائد المدرسية أو الأناشيد بتمثيل يهدفون من وارئه الوصول إلى الشخصية المتحدثة.
ولا شك أن هناك فى المسرحية من احترف التمثيل أو أدمن معايشته مثل الممثلة القديرة أسمهان توفيق والممثل حسين المنصور وانتصار الشراح واحمد العامر وغيرهم، هؤلاء ربما يجدون سهولة فى ارتداء ملابس الدور خاصة بعد أن تكون المسرحية مقنعة بالنسبة لهم.
ولكن هناك من الصغار : سحر حسين واختها هدى وسناء طالب وسوسن محمد جواد ووليد خليفة واحمد القطان وجاسم عباس وأخرين. هؤلاء لازالوا فى بداية السلم المسرحى ورغم أنه فى البداية فقد استطاعوا انجاح هذا العمل بشكل جيد.
وأُناء الحديث عن الممثلين لا يمكن أن نمر مروراً سريعاً بل لابد أن نتوقف عند الممثلة المبدعة .. هدى حسين.. التى استطاعت أن تكون السندريللا التى عرفناها حقاً.
ولذلك أجد نفسى أملك شرعية فى توقع مستقبل فنى جيد لهذه الطفلة وكلمة "طفلة" هنا أعنى بها عمر الفن إذ أن الذى يريد أن يظل مبدعاً فى الأدب والفن عليه أن يشعر دائماً بانه لازال فى البداية.
خاتمة
الأعمال الناجحة لا يجب أن نواجهها بظهورنا بل لابد أن نلتفت لها نذكر عنها ما يجب أن يقال تؤكد جودتها إذ أن سلة النسيان فى هذا العصر كبيرة.. كبيرة فاتحة فاهاً دائماً لطى أى ورقة. فلابد من تأكيد جودة العمل من أجل ترسيخه فى الأذهان القابلة للترسيخ.
ومسرح الطفل فى الكويت يفرض علينا المؤازرة والتشجيع إذ أنه يعين حاضرنا فى نشأة الجيل القادم الذى من خلاله يمكن ترسيخ ايجابيات هذا العصر بما فيها من سلوكيات وتقاليد وعادات وأخلاق عامة فى أذهان الجيل القادم.