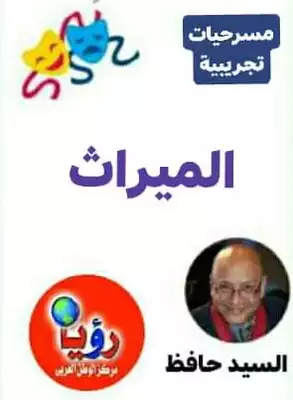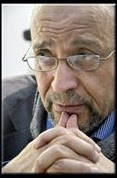مستويات اللغة وتجانسها في رواية "كل من عليها خان"
للكاتب الكبير / السيد حافظ
رؤية نقدية / محمد مخيمر
المقدمة :
حينما تشرع في قراءة رواية يكتبها السيد حافظ يجب أن تعرف أنك مقبل على تجربة جديدة وفريدة في قراءاتك الروائية، والتاريخية، والذاتية، وحتى الرومانسية، وبالتالي يجب أن تتخلى عن كل معتقداتك السابقة عن كيفية بناء الرواية التقليدية، وكيفية قراءة التاريخ، ونوعية الحب والعشق الذي اعتدت عليه، وأن تجمع كل ما لديك من ذهن وتركيز؛ كي تواصل متعة القراءة والمعرفة، فالرواية لدى السيد حافظ كما عبر عن ذلك بنفسه "الرواية هي سرد والسرد يعني التاريخ، والحكاية، والزمن الإنساني، واللغة الحية التى تملك الدهشة الشاعرية، وإذا أردت أن تكتب سردا أكتب شعرا.. .وإذا نقُص ضلع من هذه القواعد لن تكون رواية بل حكاية ضعيفة.. قد تكون الحكاية الشفاهية والحكاء الشفهي للرواية أكثر قوة وإبداعا من الحكاء الورقي..لذلك الرواية الورقية تحتاج للتحفيز والدهشة المستمرة دائما لتكون قادرة على المواجهة والصمود." ، وبالتالي فقد أدخلنا الكاتب بوعي وإدراك إلى منطقة غاية في الأهمية ألا وهي أهمية اللغة التي تملك الدهشة والقادرة في ذات الوقت على المواجهة والصمود أمام الحكاية الشفهية؛ لإنتاج حكاية أو رواية ورقية تملك نفس القدر من المتعة والإبداع.
ملخص الرواية :
تعد رواية كل من عليها خان جزءا جديدا من أجزاء المتتالية الروائية التي قدمها السيد حافظ في رواياته السابقة قهوة سادة وليالي دبي بجزئيها، والتي يكون انتقال روح سهر من جسد إلى جسد خلال الأزمان المختلفة هو بوابة العبور والجسر الذي يسير بنا عليه السيد حافظ ليحكي لنا التاريخ المسكوت عنه، ويكشف الستار عما خبأة المؤرخون. فيكون لدينا في الرواية أكثر من زمان وأكثر من مكان، فنرى الانتقال من الزمن الحاضر زمن سهر وفتحي رضوان إلى الزمن الماضي - في هذه الحلقة من المتتالية - وهو زمن المستنصر بالله وحكاية وجد ونيروزي، كذلك الانتقال من مكان الزمن المعاصر وهو دبي، إلى مكان الزمن الماضي وهو مصر، ومن أزمات الزمن الحالي من جوع وديكتاتورية وظلم وخيانة إلى أزمات الزمن الماضي من جوع وديكتاتورية وظلم وخيانة "الشدة المستنصرية". من خلال تشابك سردي معرفي روائي مسرحي درامي، تم مزجه جميها في ترابط لم يخل من متعة وجدة وحداثة وتفكيك. تنوع فيه الرواة المشاركون والعالمون، تخلل ذلك فواصل ذات مخزى وعمق ترسخ لفكرة الرواية وهي الخيانة؛ فكل من عليها خان وهان وبان.
لماذا اللغة :
إن السرد Narrative اصطلاحا هو فعل نقل الحكاية إلى المتلقي، فالمحكي خطابٌ شفوي أو مكتوب يعرض حكاية، والسرد هو الفعل الذي يُنتج هذه الحكاية . ومعنى ذلك أن الحكي يقوم على دعامتين رئيستين، الأولى : أن يحتوي ذلك الحكي على قصة تضم أحداثاً، الثانية : أن يحدد الطريقة التي تحكى بها تلك القصة، وهذه الطريقة هي السرد . فالحكاية لا تتحدد بمضمونها وحده، ولكن بمضمونها وبالطريقة التي يُقدم بها ذلك المضمون معاً . وبالتالي فإن فعل الحكي / السرد لا يتم إلا من خلال اللغة، فاللغة هي التي تعطي للفعل السردي شكله أو جنسه الأدبي وتنفخ فيه روحه التي يعيش ويخلد بها .
وهناك فارق مهم بين اللغة واللسان فكثيرا ما يحدث الخلط بينهما، فليس المقصود باللغة مجموعة الإشارات الصوتية التي يتفاهم بها مجموعة من الناس كالعربية والفرنسية والإنجليزية، فهذا هو اللسان. بينما يقصد باللغة أنها "مستوى انزياح تلك الإشارات اللسانية إلى معانٍ لا توردها المعاجم" فالعصفور لسانا هو جنسُ طيرٍ ، بينما العصفور لغة يكون حسب الانزياح في الاستعمال الحياتي أو الوظيفي أو التعبيري؛ فقد يكون أدبيا هو الحبيب، أو الوطن الحبيس، أو الحرية، أو الجمال، أو الهجرة، أو الضعف، إلى غير ذلك من انزياحات. وبالتالي فاللغة في الرواية هي الركيزة الأولى والأهم لبنائها الفني، فاللغة هي التي تصف الشخصيات وتمكنها من وصف شيء ما، واللغة هي التي تحدد وتبني غيرها من عناصر الرواية؛ مثل الزمان والمكان، واللغة هي أيضاً التي تحدد وتبني الحدث الذي يجري في المكان والزمان .
وسوف يتم تناول اللغة في رواية "كل من عليها خان" للسيد حافظ من خلال عنصرين رئيسين هما : التجانس اللغوي اللساني ، وتعدد مستويات اللغة المستخدمة.
أولا : التجانس اللغوي اللساني :
التجانس لغة هو توافق سمات الكلام من إيقاع ونبر واختيار ألفاظ لما فيها من معان وأصوات متجانسة بحيث يصبح حسن الوقع في السَّمع أو خلاّبًا للذِّهن ، وأقصد بالتجانس اللغوي أنه كان هناك تلاؤم بين اللغة المستخدمة والسياق المستخدمة فيه تلك اللغة، فكان الكاتب يستخدم اللغة المسرحية على سبيل المثال حينما كان الحدث هو قصة المستنصر بالله والمجاعة التي لحقت بمصر آنذاك، بينما كان يستخدم لغة الدراما والسيناريو حينما كان الحدث هو قصة سهر وفتحي، بينما كانت اللغة سردية وصفية روائية حينما كان الحدث على لسان الراوي الرئيس فتحي، وبالتالي كان هذا التنوع الواعي مناسبا لتنوع الأزمان والأمكنة وطبيعة الحكي، كذلك كان هناك تلاؤم بين لغة السرد ولغة الحوار وطبيعة الحدث الذي استلزم ذلك، فما كان يحتاج الوصف لم يتخذ له الحوار سبيلا، وما كان يحتاج الحوار ندر فيه الوصف وكان الحوار مؤديا للوظيفة ذاتها.
كذلك كان هناك تجانس لغوي مهم يتمثل في مناسبة الألفاظ الواردة وعددها لما يحمله النص من دلالات وأفكار، على سبيل المثال نجد أن لفظة خان وتصريفاتها مثل يخون وخيانة قد ذكروا حوالي 74 مرة وهو ما يتناسب مع رواية تعتمد الخيانة عنوانا رئيسا فالخيانة بدأت منذ أن خان قابيل هابيل وقتله مرورا بخيانة المصريين لعثمان بن عفان فكان أغلبية قاتليه من المصريين كما تقول الرواية ص 110 "و أن سيدنا عثمان بن عفان ترك المصريين شهورا على بابه حتى يقابلهم ويسمع شكواهم ضد عمرو بن العاص فضجروا فأفتى المفتي المصري الغافقي بقتل عثمان بن عفان وقتل بيدي 32 شخصا منهم 28 مصريا".، ثم خيانة التجار والحكام لمصر في فترة الشدة المستنصرية وصولا لخيانة سهر وفتحي لزوجيهما بدافع الحب والعشق.
نعم إنه الحب الذي يدفع المرء للخيانة وسب الوطن المستباح الذي تم احتلاله سبعة آلاف عاما، فعدد مرات ذكر الحب في الرواية تكرر 100 مرة ، كذلك تكرر لفظ العشق 100 مرة تقريبا، فمن يا ترى المحبوب الأكثر ذكرا هل هي سهر؟ ذكرت حوالي 200 مرة ، أم وجد؟ ذكرت حوالي 280 مرة أم إنها مصر؟ فقد تكررت حوالي 567 مرة على مدار صفحات الرواية؟ الإجابة واضحة إنها مصر الحب والجرح، العقاب والصفح، ذات الذاكرة المثقوبة، أرض اللقاء المنتظر والعودة من الغربة.
أما التجانس اللساني فأقصد به مناسبة وملاءمة اللسان المستخدم في الحوار على لسان الشخصيات. فاستخدم الكاتب عدة مستويات للسان شخوصه وهي اللسان العربي الفصيح، حينما كان يميل للسرد والوصف مثل ما كان يرد على لسان فتحي في مقالاته أو وصفه لحبيبته أو مناجاته الذاتية فهو يقول مثلا :
"وتسألني من أنت، قلت أنا السؤال والزلزال والثمار والحوار والنبراس والزمان والمكان. أنا الوحدة والتوحّد والباحث عن نور يفتح للشهوة ألف فكرة وحلم.. وأنا على جبين الإمام الحسين بن علي.. رعشة إيمان تطير بين أحرف الكلمات حنينا لرضا الرحمن.. وأنا الحيران وفي عيني خيمتان للعشق.. واحدة لك.. وأخرى لسورة الرحمن."
كذلك حين وصف الإسكندرية :
"مدن قليلة لها هذه الروعة.. تلك التي دخلت التاريخ مثل الإسكندرية.. التي أنشأها الإسكندر الأكبر وعمره كان وقتها في الخامسة والعشرين، وجعلها عاصمة مصر.. ويقال أن هوميروس كان شاعرا ومهندسا وهو الذي رسمها للإسكندر كما في الحلم الذي رآه الإسكندر..وبكى بطليموس الثاني حين نظر من قصره فوجد الناس تضحك في شم النسيم على البحر وقال لمَ لا ....كيف لا أكون سعيدا مثلهم وأخذ يبكي.."
أو الحوار السارد أو الواصف لشخص أو حدث، مثل حوار نيروزي مع أبوزيد الهلالي ودياب واصفا عمر الخيام :
"قال له في ذلك المساء: أخبرني عن أحداث شاعر بلاد فارس عمر الخيام. فرح نيروزي بأنّ العرب يسمعون عن الخيام، فمدّد ساقيه وأخذ يحكي . قال نيروزي :
- عمر الخيام هو صديق الشيخ حسن الصبّاح.
- أسألك عن عمر الخيام لا عن الشيخ حسن الصباح.
- عمر الخيام هو ابن إبراهيم النيسابوري. نجم خراسان، عبقري إيران والعراق، وأمير الفلاسفة."
أو حواره مع وجد حاكيا لها قصة الشيخ حسن الصباح :
" - احك لي ....
- سأحكي لك....أنا من الشرق ....من بلاد فارس....
.. في بلاد فارس البعيدة..... هناك قلعة غريبة إسمها ألموت .. وكلمة ألموت في اللهجة المحلية "أمثولة النسر" ... يحكى أنّ ملكاً من ملوك الديلم أطلق صقرا ، وتتّبع تحليقه إلى أن حطّ الطائر الكاسر على صخرة شاهقة العلو فقرّر الأمير بلا تردد أن يكون هذا المكان موضعاً حصيناً لبناء قلعة عليه سماها(ألموت)"
كما كان هناك اللسان العامي المصري اللهجة، في حوارات فتحي وزوجته وحواراته مع سهر وحوارات المصريين في عصر المستنصر بالله :
- نعمل إيه في نصيبنا..الناس باعت وأكلت كل الماعز والجاموس.. كلنا بناكل لحم القطط والكلاب.. كل مصر غني وفقير..بناكل القطط والكلاب نعمل إيه ؟
حاولت فجر.. أن تهدئ أم وجد قائلة :
- أنا فهّمتها ياخالتي القسمة والنصيب.
دخل في الحوار عمار الحلاق أبو وجد: كل الناس حتموت.. ماحدش حيموت قبل ميعاده.. "
كما كان هناك اللسان العامي الشامي اللهجة خاصة في الحوارات بين سهر وشهرزاد في لقاءاتهما المتكررة :
- سأحكي لك. ولكن إحكي لي الأول كيف حبيتيه ها المصري فتحي رضوان خليل..؟
- مابعرف شو أحكي...الحبّ يأتينا دون سابق إنذار.
- شو إنتِ إحكي لي اللي صار لوجد روحي الرابعة.. وشو ثورة النسوان؟"
كذلك اللسان العامي بدوي اللهجة خاصة في حوارات أبوزيد الهلالي ودياب مع المصريين.
- "أبو زيد : وين القمح.. قمح مصر؟
- سنا رة : بح.. القمح.. بح..
- دياب : إيش لون .. كيف راح القمح"
وبالتالي كان التناغم الصوتي للشخصيات موفقا مما زاد من مصداقية ما يتلقاه القارئ من وصف وسرد وحوارات على لسان الشخصيات المختلفة للرواية.
ثانيا : تعدد مستويات اللغة المستخدمة :
قام الكاتب الكبير السيد حافظ في هذه الرواية باستخدام عدة مستويات وأشكال للغة قامت بالتعبير وتبليغ الحكاية المسرودة في متن الرواية، تضافرت جميعها في إخراج هذه الحكاية المقروءة بنفس متعة الحكاية الشفاهية، فكانت اللغة الدينية واللغة السياسية ولغة المسرح ولغة الدراما ولغة التاريخ ولغة الفانتازيا ولغة الشعر ولغة القصة القصيرة ولغة السرد ولغة الحوار، حاضرة في جميع أنحاء الرواية، وفيما يلي مرور سريع على كل مستوى من هذه المستويات.
1- اللغة الدينية :
كانت اللغة الدينية حاضرة بقوة في هذه الرواية، سواء بشكل لفظي واضح أم ضمني مستتر، ولم لا والرواية تتخذ من تاريخ الدولة الفاطمية في عهد المستنصر بالله متكأ وهي الدولة الإسلامية الشيعية التي طالما اشتد صراعها مع الخلفاء السنيين، فمنذ عنوان الرواية "كل من عليها خان" نجد اللغة الدينية تطل برأسها؛ فالعنوان مخاتل يتخذ من التناص الديني قوة كبيرة وبشكل واع، ويضع القارئ من أول لحظة في مضمار الرواية، فيشعره بالانزياح في المعنى بين منطوق الآية الكريمة "كل من عليها فان" وبين منطوق العنوان. كما يشعره بحتمية المقصود من تقرير العنوان نظرا لحتمية الحكم الإلهي، فحينما استعان الكاتب بالفعل الماضي "خان" بديلا عن اسم الفاعل "فان" استبدل معه زمان الحكم من المضارعة والمستقبل "فان" إلى المضارعة والماضي "خان" .. وترك المستقبل للقارئ يحكم عليه بمعرفته ، فهل كل من سيأتي عليها سيخون؟ أم سيتغير المستقبل عن التاريخ الذي طالما تكرر.
كذلك كان حضور قصة بدء الخلق وابني آدم وأول خائن وقاتل في التاريخ ملفتا، كما كان التناص رمزيا جليا مع سنوات مصر العجاف في عهد يوسف عليه السلام وسنوات الشدة المستنصرية السبع، من خلال البرديات السبع اللاتي ذكرن بعد اجتماع ياقوتي اليهودي بتجار مصر، والتي كانت في صورة رسائل من المصريين ليوسف عليه السلام. بينما كان التناص الضمني مع الموروث الديني خاصة الرقم سبعة هو التناص الأذكى، لأنه أكسب الرواية وعيا ورمزا مقصودا من الكاتب، فلما كانت سنوات الشدة المستنصرية سبعة، كانت العناوين المقترحة سبعة، وكانت قصص جيران فتحي في الإسكندرية سبعة، وكانت المسرحيات القصيرة جدا سبعة.
2- لغة المسرح :
اعتمد الكاتب على لغة المسرح بما فيها من تقنيات وأدوات في سرده لقصة وجد ونيروزي أيام الشدة المستنصرية، وفي مسرحياته السبعة القصيرة جدا الواردة في فواصل الرواية، فكان الإرشاد المسرحي واضحا جليا في وصف دخول وخروج الشخصيات وكيفية نطق الجمل الحوارية ووصف أشكالهم وانفعالاتهم داخل المشهد داخل أقواس إرشاد مسرحي بخط ثقيل (يضحكون)، (يُخرج سيفه)، (يدخل مجموعة من الناس في مظاهرة)، كما اعتمد هذا الجزء على لغة الحوار بين الشخصيات بشكل كبير، ولغة المسرح تمتاز بعدة صفات وهي الإيقاع السريع، ووجود الحوار بين الشخصيات وهو المناسب لفن الحكي الذي تمارسه شهرزاد في سردها لحكاية الروح الرابعة "وجد" كما أنه النسق الذي يضمن أكبر نسبة تفاعل مع المتلقي والقارئ لكون المسرح يمثل وسيلة تفاعل مباشر من ناحية، ومن ناحية أخرى استخدام الحوار في توصيل أفكار الشخصيات ونوازعها الدرامية طوال العرض.
3- لغة الدراما والسيناريو :
استطاع السيد حافظ أن يوظف قدراته في كتابة السيناريو في خلق لغة تتميز بالإيقاع السريع وتستطيع أن تأخذنا معها حيث تريد وقتما تريد في انصياع كامل من القارئ، فكان يستخدم لغة السيناريو من حيث وصف المشهد مكانيا وزمانيا بشكل سريع يدخل القارئ في المشهد مباشرة دون الإيغال في وصف لا طائل منه، فمثلا نجده يقول :
"الزمان / ليلا
المكان فى الشام/ شقة كاظم"
كما أنه يقطع المشهد لينتقل لمشهد قصير آخر بوصف زماني مكاني ليرصد لنا الحالة الشعورية كاملة، كما استعان بفكرة الفواصل الإعلانية ليعلن استراحة من الرواية والسرد الروائي، فيفاجئنا بنصوص موازية في فواصله عبارة عن مقاطع غنائية أو مسرحيات وقصص قصيرة جدا أو حكايات جيران فتحي في الإسكندرية؛ فيتحد عالم الفواصل مع عالم النص الروائي وينتجان نصا واحدا مليئا بالرموز والأخيلة والثراء الوجداني والتاريخي. فكانت فواصله كذلك تتخذ من لغة التليفزيون عناوينها "فاصل ونواصل .. لا تذهب بعيدا عن الرواية" و " عدنا إلى الرواية .. اقرأ الآن"
4- لغة التاريخ :
لغة التاريخ تعد من أصعب اللغات التي يتعرض لها الكاتب الروائي لعدة أسباب، أولها لأن التاريخ واقعي الحدوث ثانيها أنه قد يكون خلافي الثبوت وفقا للمؤرخ أو المذهب الديني والفكري، وتكمن الصعوبة في كون الروائي يكتب متخيلا لهذا التاريخ من وجهة نظره، وللأحداث التي صنعت هذا التاريخ بما في ذلك من حبكات فنية ودرامية قد لا تتواجد في التاريخ الواقعي، كما أنه قد يضع نفسه والقارئ في حيرة اختيار الأكثر ثبوتا أو الشك فيه، أو عرض كلا الرأيين من خلال الشخصيات المتخيلة، فالروائي يستحضر أحداث التاريخ في إطار جدلي يقوم على استكشافه من جديد للوقوف على زواياه وبؤر توتره . وهذه الجدلية تؤسس للفكر الأيديولوجي أو السياسي للروائي؛ وقد أجاد الكاتب في خلق شخصيات عاشت وتعايشت مع هذه الأزمة، فطرح من خلالها أفكاره وشجونه، كما أجاد في اقتباس مقولات منسوبة لكتاب مثل جمال حمدان من غير تزيين بل وضعها في صورتها الفكرية كما هي :
"قمت من النوم إلى المكتبة، وفتحت الجزء الرابع من كتاب شخصية مصر.. كتب فيه جمال حمدان:
خلال أكثر من 5000 سنة لم تحدث فى مصر أو تنجح ثورة شعبية حقيقية واحدة بصفة محققة أو بصفة مؤكدة، مقابل عشرات بل مئات الانقلابات العسكرية، يمارسها الجند والعسكر دوريا كأمر يومى منذ الفرعونية وعبر المملوكية وحتى العصر الحديث ومصر المعاصرة .."
5- لغة الفانتازيا :
في خضم هذا المعترك التاريخي الوطني المأساوي استطاع السيد حافظ ان يصنع المفارقة والفانتازيا عندما ورط القارئ معه مرتين .. الأولى حينما حمله عبء اختيار العنوان المناسب من وجهة نظره لأنه شريك منذ هذه اللحظة في الرواية كما قال في بداية الكتاب "صديقي القارئ يمكنك الآن أن تختار عنوانا من السبعة وتبدأ في قراءة الرواية بالعنوان الذي اخترته أنت.. دعك من اختياري فأنت شريكي من الآن".، والثانية حينما أشركه في أحداث مسرحيته وجعل له حوارا مكتوبا ومرسوما بدقة مع حاجب الخليفة تارة ومع المستنصر بالله تارة ثانية ومع الخبازين تارة ثالثة، في حالة من كسر الإيهام المتعمد في محاولة لتوريط القارئ في الأحداث وإحالتها على الواقع الحاضر زمانا ومكانا.
القارئ إسألني أنا القارئ وأنا حرّ أعمل اللي أنا عايزه.. إلغي الرواية أو المشهد.. أنا المشاهد صاحب الرؤية الأخيرة.. ممكن تقول القارئ عاوز كده لما الجمهور يسألك .
حاجب الخليفة حقّك عليّ يا أستاذ.. المرّة الجاية ح أقول القارئ عايز كده.
القارئ خلاص.. خلاص.. إتفضل إطلع بره المسرحية.
6- اللغة الشعرية :
يرى محمد البغدادي أن اللغة الشعرية يتم فيها تحييد الحدث والشخصية والزمان والمكان وقد يصل الأمر لتهميشها جميعاً ليتسع المجال للشعرية وحدها، في نص نثري طويل مؤلف من جمل قصيرة مكثفة، توحي للوهلة الأولى بأنها لا تريد أن تقول شيئاً ولا أن تروي حكاية، بل إنها تسعى للعبث بمخيلة القارئ وبصبره، لكن هذا العبث هو نفسه ما يضمن استمرار القارئ حتى النهاية، ليكتشف أخيراً مجاهل لم يكن يعرفها، وليتذوق جماليات لم يكن يألفها . وقد أجاد السيد حافظ في استخدام اللغة الشعرية من جهة والشعر من جهة أخرى، فلطالما كانت لغته تحتوي على التصوير المبدع والخيال المتقد، كما احتوت كثيرا على إيقاعات السجع وجماليات الجناس، فيقول مثلا في فقرة بديعة صفحة 190 تكتنز بالتصوير الرائع :
"وتسألني من أنت !
أنا.. من أنا ؟ أنا لم أعقر ناقة صالح ولم أخن الوطن مرة مثل حور محب أو علي بك أبو الذهب أو ابن خلدون أو السادات. أنا لم أحمل قميص يوسف الملوث بدم كاذب للذئب ورفضت أن أغتصب مصر ليلة 5 يونيو 1967 مثلما فعل عامر وناصر ورفضت أن أغتصب مصر حين طلبني أمن الدولة لأكتب التقارير عن الأدباء.. وقميصي قُدّ من دبر.. وقلت كيف أخون الوطن مع أن الكل يخون؟ والذئب يلقى على نقطتين من دم..وأنا الذي ألقيت قميصي على وجه الوطن في مظاهرات 1972 فارتدّ الوطن بصيرا في 6 اكتوبر 1973."
ويقول صفحة 88 واصفا حبه لسهر في وصف ساحر وسجع وجناس رائعين
"حين ألقاك لا تتوضئي، وألقي بثوب الحياء على كتفي وصلي معي فأنت مسبحتي.. وخمر الجنة والعشق سجادتنا.. وأعلن للبحر والنجم والملائكة في السماء سأضمك إلى صدري وبعطرك أنجلي وأحتلي وأختلي إلى روحي، وأترك جسدي على حصاني فى الخلاء. يا سيدة البهاء لقائي بك ليس اختلاء وليس خطيئة بل هو لقاء الأرواح النبية."
ويقول معتمدا على الجناس صفحة 229 " يا فاتنتي.. أسير ولا أسير، وأنا الأسير"
ولم يكتف كاتبنا بذلك بل أورد ضمن فواصله مقاطع شعرية للعديد من الشعراء المصريين والعرب مثل الشاعر الصديق أحمد حنفي والأستاذ عذاب الركابي والشاعرة لمياء عوض وغيرهم، مما أثرى النص الروائي وأضاف لجماله جمال الشعر ورونقه ولغته.
7- لغة القصة القصيرة جدا :
لم يكتف الكاتب الكبير السيد حافظ بهذا الكم من المعارف والفنون في روايته فاستخدم القصة القصيرة جدا ذلك الفن الحديث نسبيا والذي يعتمد على التكثيف الشديد والانزياح في المعنى والرمزية والمفارقة في نص روائي طويل فقال في صفحة 227 تحت عنوان قصة قصيرة جدا : " كان الوطن يدخّن سيجارة رخيصة على المقهى حافي القدمين .. توجّهتُ إليه ..اختفى في لحظة وتبقّى مكانه حذاء ممزق مهلهل وجريدة يومية أمسكتُ بها. وجدتها بيضاء." وهذه من وجهة نظري قصة قصيرة جدا مكتملة الأركان ويمكن أن نتحدث في تأويلاتها كثيرا، وهنا لم يضعها الكاتب من باب الاستعراض ولكنها كانت ضرورية في جنسها الأدبي ومكانها؛ لخدمة البناء الروائي والمعنى المراد توصيله، ولم يكتف بذلك فكانت هناك سبع مسرحيات قصيرة جدا ضمن فواصل الرواية تعتمد أيضا على الرمزية والانزياح الدلالي الواعي.
8- لغة السرد ولغة الحوار :
وقد تم تضمينهما فيما سبق من مستويات للسرد والتناسق اللغوي واللساني؛ وبالتالي لا أحب أن أطيل في وصفهما مرة أخرى، لكن الكاتب أجاد في اختيار ما يجب كتابته سردا وصفيا وما يجب أن يكون حواريا.
سلبيات الرواية :
كأي عمل بشري ومهما بلغت درجة إجادته فالنقص يلازمه ولو بنسبة بسيطة، ولي في النهاية بعض المآخذ على الرواية، أولها أنه على الرغم من مراجعة الرواية من العديد من المدققين كما أوضح الكاتب في بداية الرواية إلا أنه كان هناك خطآن فادحان من وجهة نظري أولهما في صفحة 289 حينما بدأ المشهد الذي يروي العام السابع من الشدة المستنصرية بعبارة متكررة طوال السنوات الست السابقة " اجتمع ياقوتي التاجر اليهودي مع فتح الله شهبندر تجار العطار" بينما كان فتح الله شهبندر التجار مقتولا بالفعل قبل ذلك بحوالي اثنتي عشرة صفحة وبالتحديد صفحة 277 حينما خطفه رجال عنتر زعيم عصابة الصيادين انتقاما للثلاثة الذين قتلوا من العصابة وفي ذلك فصل معنون "يوم اغتيال فتح الله" صفحة 271، وذلك في العام السادس من الشدة المستنصرية.
ثانيهما الخلط الغريب بين شخصيات خضر وفرحان وخلفان الخبازين، وهو خلط أعتقد أنه نتج عن تغيير في أسماء الشخصيات دون مراجعة فعالة لتغييرها جميعا، فنجد أن خضر هو عريف الخبازين، وأن فرحان هو الخباز الثائر في صفحة 247، ثم نجد في صفحة 294 أن خلفان هو عريف الخبازين وخضر هو الخباز الثائر، ثم يزداد الأمر صعوبة حينما يكون الحوار بين أميمة وخضر صفحة 295 وتقول له "أمي قالت لي ما تجيش يا أميمة إلا ومعاكي فرحان". ويستمر الوضع على هذه الشاكلة المرتبكة حتى صفحة 303 ؛ وهو ما أربكني كثيرا كقارئ للرواية.
أما عن ثاني المآخذ وهو على الرغم من وجاهته إلا أنه أفقد الحكي منطقيته، فكيف لشهرزاد وهي تحكي لسهر قصة وجد في عهد المستنصر بالله أن تضع القارئ والمخرج والسيد حافظ نفسه في متن الحوار، فكسر الإيهام هنا لم يكن مناسبا لشخصية شهرزاد السارد الرئيس لهذه المنطقة في الرواية.
ثالث المآخذ من وجهة نظري هي اهتمام الكاتب دراميا ببعض الخيوط وإهماله للبعض الآخر، فلم نر بقية رواية فتحي عن ابني آدم، ولم نر الأستاذ كاظم إلا في مشهد وحيد ثم لم يتطور أمره، لم تتطور دراميا قصة سهر مع فتحي فكانا طوال الوقت في لقاءات وعذابات ضمير، دونما انكشاف لأمرهما أو رحيل وفراق، بينما على الجانب الموازي تطورت قصة وجد ونيروزي، فرأيناهما ابتعدا واقتربا وتزوجا وثارا.
الخاتمة :
كل من عليها خان عمل فوق روائي، عمل حكائي بامتياز انصهرت فيه الرواية بالسيناريو بالمسرح بالقصة بالشعر بالسيرة الذاتية، تماهى فيه الماضي مع الحاضر في بلورة لرؤية أوضح للمستقبل، نص رغم كبر حجمه إلا أنه سريع الإيقاع ومشوق، يمثل من وجهة نظري الحلقة الأقوى في متتالية السيد حافظ الروائية، استمتعت به كثيرا، وفي انتظار الحلقة القادمة والحكاية الجديدة إن شاء الله.