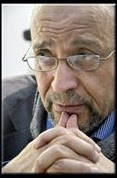تنظير نقدى لإخراج مسرحية
( قميص السعادة )
كوميديا شعبية موسيقية رومانسية
للكاتب / السيد حافظ
أ.م.د. محمد عبد المعطى محمد
*****
إن الإبداع المسرحى للطفل هو أشق أنواع الإبداع، وتكمن مشقته فى ضرورة أن يدلى كلا من الكاتب وصانع العرض المسرحى "المخرج" وكل عناصر العمل المسرحى بخيالهم وحدسهم إلى عالم الطفل، أن يرون بعينه ويفسرون العالم بمنطقه الذى يختلف تماماً عن المنطق العقلانى والتجريدى الذى يحكم نظرة الكبار، وليظهر لنا فى النهاية العالم فى جدته وأيضاً فى برائته وألفته وغرابته.
" قميص السعادة " والكوميديا الشعبية الرومانسية :
إن مسرح الطفل يقترب فى أعلى مراتبه من الكوميديا الشعبية الرومانسية. عرفنا ذلك فى مسرحيات مثل " حلم منتصف ليلة صيف " أو "العاصفة" أو قصة شتاء" عند شكسبير كما عرفناه فى مسرحية "حدوتة من حواديت العجائز" لجورج بيل و"الطائر الأزرق" لميترلنك أو فى " رسائل قاضى أشبيليه" لكاتبنا العربى الفريد فرج، وأخيراً نراه فى "قميص السعادة" للسيد حافظ، والتى تستقى مادتها من الفكلور الشعبى العربى، وقد امتزجت فيها الحواديت والنوادر الشعبية بالألعاب المألوفة والأهازيج والأغانى الموروثة وحيث طرحت رؤية شاملة للوجود، وإن استغنت عن عنصر ثبات الأشياء.. هذا العنصر الأخاذ المثير لخيال طفل ما قبل الثامنة والذى يختلط فيه الأنس والجن بالطير والحيوان وبالمردة والسحرة، وتنطق فيه الزهور والأشجار وتسيطر المعجزات والخوارق والتحولات العجيبة فى المواقف والشخصيات.. وذلك لعدم الحاجة الدرامية إليها من ناحية ولأن الموضوع يدور وبثبات حول العلاقات الإنسانية للجماعات ويتناول معانى العدل والخير والإنسانى والشر المجسد فى النفوس.. إن الفعل يدور فى محور الإمكانات التخيلية والإمكانات الثقافية والمكتسبات البيئية لطفل ما بين الثانية عشر والسادسة عشر.
ومن هنا كانت الكوميديا الرومانسية الشعبية هى أنسب الأشكال الفنية للتوجه إلى هذا النوع من الأطفال "الشبيبه" إذ أن أجواءها والأضداد فيها والعاطفة المشبوبة تمتزج فى بوتقة خياله الخصب وتحاكى منطق الأسطورة والحلم.
فى إطار هذه الرؤية يكتسب الصراع المحورى بين الخير والشر فى "قميص السعادة" مفهوماً شاملاً. ويتسع مفهوم الشر ليشمل كل القوى والنوازع التى تناهش الحياة مثل التسلط والجشع والقسوة والظلم والأنانية :
الوزير الوصولى الجشع.
القاضى المرتشى.
قائد الشرطة المستغل لسلطاته.
الطبيب المحتال المستغل.
وينبسط مفهوم الخير ليشمل كافة القيم المؤازرة للحياة والخصوبة مثل : العدل والحب والجد والوفاء:
الأمير الباحث عن السعادة.
الأميرة الرافضة لظلم الوالد الجشع.
الوصيفة والخادم المخلصان حتى النهاية.
ابن الحلاق الباحث عن الحب ويناضل للحصول عليه رغم فقره.
أفراد الشعب الذين يلتفون حول أميرهم ليستعيد سعادته، ويستعيدون العدل.
*****
و "قميص السعادة" تختار مادتها من الحكايات الشعبية، إذ أن الحكايات الشعبية – فى أصولها – تستهدف الطفل فى المقام الأول لما تحتوى عليه من عالم فانتازيا رحب. لقد أدت هذه الخصوبة – خصوصية الخيال الخصب – إلى جعل هذا المصدر الشعبى الفنى أهم مصادر الاستلهام للكتابة للطفل عموماً.
إن التراث الشعبى – فنون مرئية وأدب وموسيقى – له القدرة على ملائمة الواقع. ولفنونه القدرة على أن تغير من ذاتها وتتجدد بشكل مستمر لا يتوقف عن صيغة بعينها. إن عناصره تحتضن أهم عناصر المحاكاة وبذور المسرح.. عناصره تحتضن الأساطير والملاحم والقصص والحكايات والسير والمرائى والأغانى والحكم والأمثال وهى عناصر تتسم بخصائص العراقة والواقعية والجماعية.. "إنه الأدب الصادق الذى يخرج من الروح الشاعرة فى داخل الإنسان " كما يقول يعقوب جرم.
وإذا كان مسرح الطفل كأدب فنى ينبع من روح الفرد الشاعرة الواعية بالملتقى الصغير ذو الخيال الخصب، فإن استلهامه هذه العناصر الفنية فى التراث يدعم هذا الخيال ويكسبه صوراً إبداعية ودرامية ومسرحية لا حصر لها.
قميص السعادة وألف ليلة وليلة :
إذا حصرنا جملة المسرحيات التى تم استلهام موضوعها من حكايات ألف ليلة وليلة سنجد أنها تمثل الجانب الأعظم من المسرحيات العربية ذات الأصول الشعبية والتراثية، ويرجع هذا إلى تعدد موضوعات وثراء أفكار المصدر كما أشرنا.
وبدءً برائد المسرح العربى "مارون نقاش" (1817 – 1855) وانتماءً بالكاتب السورى سعد الله ونوس فى مسرحيته (الملك هو الملك) 1978 نجد "السيد حافظ" ومن قبله عدد كبير من كتاب الدراما يستلهم موضوعه أيضاً من هذا المنبع الخصب (ألف ليلة وليلة) ولعل أشهر كتابنا من هؤلاء الكاتب المصرى المبدع "الفريد فرج" فى مسرحيته حلاق بغداد (1964) و(على جناح التبريزى وتابعه – 1969).
ومسرحيتنا "قميص السعادة" فى تأثرها بهذا المصدر فإنما تهتم بجماليات الصورة المسرحية وسحر أثرها والتى ظهرت فى التجسيد على مسرح.. إنها تنتقل إلى أماكن ومناظر شعبية ساحرة فى تأثيرها وهى وثريه بالخيال والابداع.
والمؤلف فى انتفاءه للفعل المسرحى فى غرابته وطرافته والأمكنة اللامألوفة إنما ليترك تأثيراً قوياً غنى بالخيال والإيحاء للطفل المشاهد يفوق لغة التعبير الكلامى.. بل وينحو نحو المسرح المعاصر اليوم فى استلهامه للمادة التراثية.. هذا بجانب تميز "قميص السعادة" عندما تلجأ إلى عناصر القصص المتداخلة الغنية بالأحداث والتى تتميز بها حكايات السير الشعبية : الأمير وابنه السلطان من ناحية والخادم دندش والوصيف مرجانة من ناحية يؤكدهما حكاية ابن الحلاق مع من يحبها ويعجز عن الارتباط بها (أنظر النص الملحق)
أصداء رحلات البحث فى " قميص السعادة " :
وكما فى معظم الكوميديات الشعبية الرومانسية فإن الرحلة تردد أصداءها فى "قميص السعادة" :
رحلة بحث الأمير عن السعادة المفقودة.
رحلة بحث الوزير عن ابنته الهاربة من ظلمه.
رحلة بحث الشعب عن مخرج لخلاصه من اضطهاد رئيس الشرطة واستغلال القاضى.
رحلة بحث أم سعيد عن ابنها التاءه.
رحلة بحث الشركة عن الطبيب شعبان لينفذ مخطط الوزير الشرير.
المنادى كدلالة ووسيلة للبحث.
إن رحلة البحث تمثل الخيط الرئيسى الذى ينظم أحداث وعناصر "قميص السعادة" ويغدو موضوع البحث هنا سواء عن طائر أو قميص أو فتاة أو ماء الحياة رمزاً شاملاً للخير أو الرخاء أو العدالة.. يغدو رمزاً لقيمة إيجابية تتخطى الكيان المادى ويكون لذلك تأثيره العقلانى والوجدانى العميق على الطفل.
" قميص السعادة " والتربوية الهادفة :
إن "لقميص السعادة" تستوحى الكوميديا الرومانسية الشعبية فى مادتها وفى صياغتها فترتقى إلى مرتبتها الفنية وتتخطى بذلك التفسير المسطح للهدف التربوى فى مسرح الطفل. إنها تطرح تفسيراً ناضجاً يرتقى بمفهوم التربية من التلقين المباشر الذى رأيناه فى الكثير من مسرحيات الطفل المصرى، زمن الخطابة الجافة المتعالية وضرب الأمثلة الساذجة إلى إخصاب الخيال وتنمية الحس الجمالى نصاً وعرضاً.. ترتقى بمشاعر الطفل المشاهد وعقله حتى يتخذ موقفاً إيجابياً تجاه ما يشاهده من أطراف الصراع بين الخير والشر.
والقصة المحلية التى استوحاها المؤلف من ألف ليلة وليلة نجد لها أصداء مشابهة فى الأساطير العالمية وقد أعاد المؤلف تشكيل خيوطها فى نسيج جديد ممتع أثرى الإخراج المسرحى وذلك بالجمع ما بين الألفة والطرافة.
القصة تدور حول رحلة بحث أمير البلاد "حسان" وقد أصابه الشعور بالكآبة عن علاج ودواء يشفيه من علته.. ولما كان يعى جيداً أساليب طبيبه المغرضة فإنه يجد طريق السعادة والذى لا يملكه إلا أسعد سعداء البلاد.. ولأن شعبه يرزح تحت وطأة الفقر والعور واضطهاد الوزير وأعوانه.. فإن أسعد سعيد هذا سيكون نادر الوجود.. أو هو غير موجود بالمرة!!
إن الأمير المدرك للحقيقة يجد أن سعادته الحقيقية لا تكمن إلا فى حب شعبه.. وهو عندما يمتحنه.. مستنكراً فى ملابس صياد غريب – يجده مخلصاً، بل يساعده على كشف المزيفين من موظفيه وأعوانه والمحيطين به من الذين أولاهم ثقته فى الحكم والتحكم فى مقدرات الناس.. ولقد وجد أن السعادة الحقه لا يحصل عليها الإنسان فى قميص أو سروال ولكن فى العمل والإخلاص ومحاسبة المخطئين والأشرار. وتجمع الرحلة بطريق المصادفة بين عدة حكايات.. أهمها لقاءه مع فتاه فى السوق هى فى الأصل أبنة الوزير الذى يريد أن يزوجها ممن لا تحب. من ذات الأمير الحزين الكئيب.. ولكنها تكتشف فيه وهو الصياد الفقير المُجد المناض فتى أحلامها الحقيقى!..
نظم الإخراج هذه الخيوط البسيطة مع مثيلاتها فى نسق مسرحى بسيط ومشوق ويتسم بالغرابة التى أساسها الكوميديا والمواقف الرومانسية والمتناقضات.. نسق مسرحى يقوم على مبدأ تجسيد الصراع بين الخير والشر، الخاص والعام مستغلاً كل امكانات المسرح الاستعراضى من أداء حركى وغنائى وتمثيلى واستعراضى راقص وإبهار محبب فى الموتيفات التشكيلية الثابتة والمتحركة فى الديكور وفى أداء الممثل الرشيق، والغالب عليه الكاريكاتورية من ناحية وصدق العواطف الرومانسية من ناحية أخرى.
ولقد طعم الغرض بنماذج منوعة من ألعاب وأغانى الأطفال الشعبية، تلك التى صاغها فنياً الشاعر " مصطفى الشندويلى" فعمق البعد الفولكلورى من ناحية والمعاصر التربوى من ناحية أخرى: "يظهر السلطان بسوق المدينة فى ملابس صياد فقير.. دندش فى ملابس المعلم مختار.. الباعة فى السوق يغنون" :
المنادى : قرب .. قرب.. قرب جرب.. جرب .. جرب
بائع 1 : بلح الشام يا حلاه بالسكر متشرب
المنادى : ياللا يا مرزوق خشى على السوق
قولوا هيه.. هيه.. هيه
بائع 2 : شربات برقوق.. اتفضل دوق
قولوا هيه.. هيه.. هيه
الحاوى : توت توت .. حاوى توت
اسمى حسين احمد شلتوت
توت .. حاوى توت
من ودنى باطلع كتكوت
توت توت.. حاوى توت
أكل العيش مر يا أستاذ.. لما نجوع نتعش قزاز
اوأما بنعطش نشرب جاز.. لا بنتعور ولا نموت (الخ)
توت.. توت.. توت (أنظر النص وشريط العرض)
ومن الأهمية فى هذا العرض، فإن الصياغة الشعرية تميزت بالدرامية وأصبحت جزءاً من الحوار المغنى والذى يمثل جزءاً من النسيج الدرامى الأساسى ولم تعد مجرد غنائيات تحشر فى الفواصل المسرحية. ومن عنا تكاملت عناصر الكوميديا الرومانسية الموسيقية فى هذا العمل. وقد تكاتفت جهود الشاعر مع جهود الملحن الذى قدم للطفل صوراً موسيقية بسيطة تتناسب مع احساسه الخاص البسيط بالإيقاع والنغمة وأيضاً فى رشاقة وسرعة تتناسب والإيقاع الطبيعى الخفيف لحركة الطفل وأيضاً الكوميديا الخفيف فى هذا العمل.
لغة الصورة المسرحية فى قميص السعادة :
إن اللغة الشعرية النثرية على بساطتها.. منغمة وموقعة دون دون رتابة.. قد جانبها لغة الصورة المسرحية المرئية فى الفراغ المسرحى وهى تنأى عن التجريد والتعقيد.. ولقد سعيت كمخرج أن أوصلها إلى الطفل فى سلاسة وطرافة بحيث تتفتح من ناحية على الشعر الراقى ومن ناحية أخرى على الهزل الشعبى الفكه وعلى سبيل المثال فإن افتتاحية المسرحية تبدأ بمجموعة شعبية تضم اطفالاً وكباراً وأقزاماً ولاعبى سيرك وحواة وتدعو المشاهدين إلى رحلة البحث عن السعادة وهنا ولأنها بداية لابد أن تكون مشوقة وطريفة فقد اشتركت فيها الأقنعة البشرية للنماذج الشعبية المألوفة وكذلك العرائس العملاقة يلبسها اللاعبون ونتحرك بحركتهم صعوداً وهبوطاً وانثناءاً مما أعطى ذلك الكثير من الطابع الهزلى والمشوق.
وتلعب صورة الديكور الشرقى الطابع فى سحره وألوانه الساخنة دوراً فعالاً فى الولوج إلى عالم الأسطورة والحدوتة الشعبية بمجسمات وأبنية لها طابع الواقع الخيالى فى المقدمة :
أما الخلفية فللمدينة بأبنيتها الفقيرة والغنية وقبابها الإسلامية الجميلة. والصورة إلى السوق .. إلى حجرة.. إلى السجن.. بينما وفى أوقات متفاوتة تتحرك فى الخلفية أقمار ونجوم تجوب المكان صعوداً وهبوطاً.. حركة سيارة تضفى الجو الشاعى الرومانسى الأخاذ على شعبية المكان.
الشخصيات :
فى كاريكاتورية واقعية رسم الإخراج أنماط الشخصيات تترجم حال الشخصية لتصل إلى الطفل سهلة وواضحة وساخرة فى نفس الوقت فاختيرت على سبيل المثال لا الحصر أنماط الجنود الكسالى ورئيسهم أنماط تتنافر أجسامها ما بين قزم وقارع ونحيف وسمين فتحقق من ناحية هزلية ومن ناحية أخرى معنى الكذب والاحتيال المرغوب توصيله من خلالهم.
ولقد حرص الاخراج على الاختيار الدقيق شخصية المهرج دندش بالذات لتحقيق صورته المألوفة فى الفولكلور المصرى العريق فى تناول مثل هذه الشخصيات.. حيث جاء سليط اللسان، نحيف جداً.. سريع الحركة.. سريع البديهة.. يملك لغة جسدية عالية ويجيد البهلوانية والأكروبات وهو خفيف الظل تماماً.. وهو فى دخوله على المسرح ينقلب دائماً كل ما هو سوى من موجودات وأفكار وحوار إلى فوضى محببة إلى المشاهد واعتقد كمخرج أن الممثل الذى اختير قد نجح إلى حد كبير فى تحقيق ذلك للعمل، وهو الممثل (علاء عوض) الممثل الهزلى الذى يجيد لغة الحركة والجسد ويجيد الرقص بشكل كبير.
وشخصية رئيس الشرطة حرص الإخراج على أن تكون شخصية مضادة لشخصية دندش شكلاً وموضوعاً وإن اجتمعا فى خفة الظل ولكنهما فى النهاية يكونان ثنائياً متنافراً.. هذا فى ذكاءه وخفته والأخر فى ثقله الجسمى وغباءه وعنجهيته.. هذا فى عطاءه وهذا فى شحه واستغلاله وتدليسه وقد لعبه الممثل "ماجد الكدوانى" بتكوينه الجسمى الهزلى بتوفيق.
تتوالى الشخصيات.. الأميرة الرقيقة ذات الصوت الطفولى ولكنه يجلجل متمرداً عندما تغضب من أبوها الوزير الذى يريد أن يظلم قلبها ويستغلها لمصالحه وقد لعبته ممثلة شابة هى "راندا" بتكوينها الشرقى الارستقراطى وحركتها التى تتسم بالطفولة والأنوثة فى وقت واحد.
ثم الوزير الجشع اختير له ممثلاً يتميز بحشركة فى صوته وحدية وعصبية فى حركته وقسوة فى أداءه ولكن فى نفس الوقت خفه فى ظله عندما يتخابث ويتآمر وينهى ويأمر والذى مثله باقتدار الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.
أما القاضى الأفاق والذى رسم الإخراج صورته أن يكون قصيراً لئيماً داهية ذو حركة قافزة بين جنوده الفارعى الطويل.. يجوب الأسواق محمولاً على محفة لا قاعدة لها فقد جسده الممثل إيمان الصيرفى فحقق هذه المعادلة بإمكانياته الجسدية المناسبة والعصبية.
تتوالى الشخصيات (انظر العرض فى الشريط المسجل) تتقدمها الأنماط الشعبية.. من تجار وحواه وبائعين جائلين ومنادين وصناع حرفيين وراكبى العصى وجمهرة الأطفال ومجاميع الأقزام.. تتقدم ممثلة أنماط هذا الشعب. وفى الوقت الذى يجسد فيه جنود الشرطة العنجهية والتسلط والتخبط فى لحن كاريكاتورى يذكرنا بألحان سيد درويش الساخرة اللاذعة،
فإننا نرى من جانب آخر اجتماع الشعب حول لحن عاطفى أمومى يسجد فقطان أن سعيد لطفلها فى زحام السوق والحياة.. لحن يحمل كل معانى الفقدان التى يعانى منها الأمير.. ويجسد لحن آخر معانى التضامن عند الشدة وآخر ثورة الناس على الطغيان ومناداتهم بالتغيير.. تغيير الشرطة والقاضى والمحتسب وأعداء الحياة.
(أنظر الصور الفوتوغرافية والشريط المسجل للعرض الحى)
أ.م.د. محمد عبد المعطى محمد