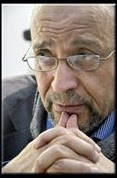دراسات من كتب د. نجاة صادق الجشعمي
(18)
شاهد من جيلنا السيد حافظ
أو التوقيع بالدم على خشبة المسرح ؟!
بقلم : محمد يوسف
دراسة من كتاب
إشكالية الحداثة والرؤي النقدية فى المسرح التجريبى
الســيد حــافظ
)نموذجاً)شاهد من جيلنا السيد حافظ
أو التوقيع بالدم على خشبة المسرح ؟!
بقلم : محمد يوسف
ينتمى السيد حافظ إلى رعيل من جيلنا شارك فى المظاهرات الطلابية التى انفجرت فى مدينة الإسكندرية عام 1968م أى بعد مرور عام على الهزيمة الفاجعة لسنة1967 م، وكان من هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا يتحدون الحكومة والنظام، ويطالبون بمحاكمة الجنرالات والضباط الكبار الذين انشغلوا بالكرة والأندية الرياضية عن الاستعداد العسكرى.
واتخذوا الممثلات والراقصات وبنات الهوى عاشقات لهم ، وتوازى هذا كله مع انهيار بريق الزعامة الناصرية ، وكان لابد أن تبذغ شمس جديدة وتخرج سنبلة قمح لامعة تنتصر على العقم والموت الفاجع. فخرجت جامعة الاسكندرية كالغزالة البرية الشادرة. تجأر وتصرخ وتنزف وخرج طلابها كالخيول العربية الجامحة يصهلون ويحولون الصهيل الى اتهام لهؤلاء الجنرالات والضباط الكبار الذين خذلوا الوطن . وخانوا القضية وارتموا تحت اقدام الغوانى ، كما تحول الصهيل الى المطالبة بمحاكمة علانية لهم لكى تعلمهم الجامعة بالمجان فى (ذروة المد الناصري) ، ثم ساقوهم الى صحراء سيناء المكشوفة كأنهم قبائل بدوية قادمة من كهوف الجاهلية ، وهناك باغتتهم المعدات الحربية الاسرائيلية. وهبطت عليهم الطائرات الاسرائيلية ولامست اكتافهم المحترقة بفعل الشمس الحارقة وهم منبطحون ارضا وألقت عليهم بالمنشورات الصغيرة وقطع الحلوى و (والشكولاته) وتجاسر بعض هؤلاء الأبناء "الجنود" وقرأ مضمون المنشور الذىكان يقولك
"قولوا لعبد الناصر عيب أن يرميكم فى الصحراء المك شوفة حتى الموت فزعا أو عطشا أو جوعا".
أى عار ، وأى هوان؟
وانفطرت القبائل البدوية فى تية صحراء سيناء المكشوفة وركض الجنود الذين تخلى "الجنرالات" وقادة الجيش عنهم لسب بسيط هوأ، معظمهم كان يدير المعركة من غرفة العمليات بالقاهرة.
وكان مشهدا فريدا لهؤلاء الذين ربطون بين "دينامية" الفعل الابداعى الذى يمكن تحقيقه وتجسيده فى الفعل الحياتي اليومى ودينامية" الوعى المشارك فى تحويل الصهيل الزلزال الى حركة حياتية يومية".
وشعر السيد حافظ " أنه واحد من المشاركين فى "كريشندو الصهيل" (أو كريشندو العناق بين وعى المثقف وحركته الحياتية بالاضافة الى تجسيد " الحلم الثورى "المتكئ على رؤية سياسية...
وكان هذا الدرس بليغا . ومقنعا وموحيا ، فقد تعلم "السيد حافظ" أن الكلمة الصادقة المسلحة بوعى ثورى، تؤتي ثمارها حين تتحولالى "فعل ثورى".
وتحويل " الوعى الثورى" إلى "فعل ثورى" هو المحضور الذى تخشى الحكومات والانظمة الديكتاتورية من وقوعه ، لنه يحمل بذرة نهايتها المأساوية؟
كانت الكلمة ثمرة يانعة ، وكان الوعى الثورى "ثمرة مرجأة" لكن وقوع " المحضور" حولها إلى ثمرة"بالفعل بالكمونية" وإلى حالة مشعة من حالات تحويل الوعى الثورى الى فعل ثورى عن طريق الشهادة بالدم؟!
بعد مظاهرات جامعة الاسكندرية فى عام 1968 ، اتخذ " الوعى الثورى " لطبقة ابناء الفلاحين والعمال الذين يتلقون تعليمهم بالمجان) مسارا أخر ، إذ بدأ اصحاب هؤلاء " الوعى " يفضلون بين عبد الناصر كزعيم وبين عبد الناصر كنظام (أى حكومة و دولة تملك من المؤسسات القمعية والاجهزة السرية ، وأمراض التسلط الادارى ، والبيوقراطية ، والقهر المعنوى وخلخلة الاستقرار الاجتماعى والاقتصادي وهيمنة هذه المؤسسات والاجهزة على الحياة فى مصر).
ومن هنا.. فإن الصدام الدموي الذى حدث فى عام 1968. لم يكن بين "عبد الناصر " (الرمز والزعيم). وتيار الوعى الثورى، وإنما كان بين الذين دفعوا الثمن الفادح للهزيمة(الصدمة المعنوية) ، والانكسار القوى ، والشعور بعبثية وفوضوية الأبنية العسكرية الفوية ، وغياب الحرية والديموقراطية بدعوى الإعداد للحب وعدم التشكيك فى صلابة الجهة الوطنية؟!) وبين عبد الناصر – النظام والدولة؟!
وقيل صدرت الأوامر بالتراجع والانسحاب ، ولا أظن أحدا يسمع مثل هذا الندءا فى يوم القيامة ، والناس من هول القارعة فى سكرة شديدة!
ولا يهمنى إذا كانت الاوامر قد صدرت أو لم تصدر ، فقد تحولت سيناء إلى "برزخ" للألم المر المالح ، ومعبر للمكابد الدموية، ومسرح لليتم الفاجع ، واتجه الابناء (الجنود) نحو "قناة السويس" ثم عربوا النقاة سباحة حتى انشلتهم القوارب، ثم واصلوا الركض على غير هدى الىأن اهتدى كل منهم الى بيت أمه.
ولا أنسى واحدا من هؤلاء الابناء (الجنود الرجال) صادفته راكضا على الطريق الزراعى لمدينة المنصورة ، و قد تورمت قدماه وتقرحتا ، وأنتفخ وجه ، فلما استوقفته فر منى مذعورا فلاحقته مهدئنا من روعه ، إذ ظن أننى أستوقفته للتبليغ عن "فراره" فلما أطمأن الى وقف وهو يلهث، وعرى جسمه المتقرح ، وذراعيه المحترقين ، وحين بدأت أحاوره أكتشفت انعقاد لسانه من أثر الصدمة ، فأدركت أنه عاد من سيناء راكضا عبر قناة السويس، ولم يجد ما يحتمى به غير بيت أمه فى قريته الصغيرة.
ورجوته أن يتمهل لتناول الشاي أو القهوة على الطريق فرفض ، فتركته لحاله ، وغيرت اتجاهي وبكيت؟!
إذن.. فهى القارعة التى لم يسمع زلزالها إلا الفلاحون الفقراء ، والعمال الفقراء وأبناؤهم الذين ساقوهم إلى صحراء سيناء المكشوفة بينما "الجنرالات" فى غرف النوم المكيفة يغطون فى نوم عميق؟!
وكان لابد أن ينهض أبناء الفقراء من الصدمة المعنوية، ويطالبون بإخراج الجنبلاات من غرف النوم المكيفة محاكمتهم.
وهكذا..خرج السيد حافظ " مع صهيل جامعة الاسكندرية لكى تتحلو الاسكندرية الى وردة من الدم والنار؟ واجتاح الصهيل الزلزال كل شئ فى المدينة العريقة ؟ وافاقت المخابرات والاجهزة القمعية على صوت الصهيل – الزلزال وأخذتها المباغتة فلم تجد بدا من إطلاق الرصاص على المتظاهريه بحجة تفرقتهم " ولسنا نجد وقتا لاضاعته".
وكانت هذه ظاهرة صحية. حرضت عبد الناصر على إسقاط دولة المخابرات" ومراكز القوى، وتفويض الجماهير له ، وتفويضه للجماهير لاسترداد "الجذوة المقدسة التى تفرق بين الاحياء والاموات من البشر ، واستعارة هيبة الجنود الذين ساءت سمعتهم بعد هزيمة 1967 والتفرقة بينهم وبين "الضباط الكبار" الذين ينامون فى الغرف المكيفة والخنادق المكيفة والجنود (أبناء الفقراء والذين لا خبز عندهم). وبناء الجبهة الداخلية ، وتطهيرها من عوامل التحلل والتفسخ والتسيب وقطع "عبد الناصر" شوطا كبيرا فى إنجاز هذا الأمر ، وأطلق على هذه الفترة مرحلة "حرب الاستئنزاف"
من الصدمة المعنوية الفادحة ، والانهيار الفاجع الى "حرب الاستنزاف " تراوح المد والجزر (فى بحر الايبداع ) بين الصعود والهبوط وبدأت السلطة فى مصر تركز على هذا الرعيل من جيلنا الذى زاوج بين الكتابة والدم ، وكان "السيد حافظ" واحدا من هذا الرعيل اذى كان التوقيع بالدم (على خشبة المسرح ) يقينا قاطعا بالنسبة له؟!
هو إذن هذا الرعيل الذى فجر التنافر فى عام 1968 (عام المظاهرات الطلابية) وأوصله الى مرحلة النفور(أى النفور من مداهنات ومداهمات السلطة)* فى عام 1971 ، عام الانقلاب الرجعي وقطع راس الحكم الثورى ، وضرب "الغزالة البرية" حتى النخاع ،" وقتل الصهيل" و"البوح" ومسخ الكتابة بالدم ، ومزج الدم بالماء؟!
5) وقوع الحلم الناصرى فى الأسر
حبيبتى.. أنا مسافر والقطار أنت والرحلة والانسان
تطرح مسرحية "السيد حافظ " الاولى حبيبتى.. أنا مسافر والقطار أنت والرحلة والانسان تجسيدا دراميا لجيل ثورة يوليو 1952. وطموحاته ، وإحباطاته ، ومكابداته ، وحلمه الثورى الذى ارتطم بصخرة الهزيمة فى يونيه 1967 حتى سال من رأسه الدم، وتناثر على الأسفلت الأسود شظايا تبوح للنصب التذكارى فى ميدان التحرير بسر العشق. وسر الشهادة الممنوعة!.
وللوهلة الأولى تأخذك الشخيات (التى تتراوح أعمارها بين 17 سنة بالنسبة لعائشة) (وأن كانت قد صرحت صفحة 89 من المسرحية أن عمرها 20 سنة تقريبا). " ويا سين" الذى يبلغ من العمر 23 سنة إلى ساحة الحلم الثوري المقطوع الرأس زمانا ومكانا ، فقد اختار الكاتب عام 1968 (وهو عام انفجار المظاهرات الطلابية التى كانت تطالب رؤوس الجنرالات والضباط الكبار الذين تخاذلوا وخذلوا الجندى والسلاح حتى وقعت الواقعة . ولحق بالحلم الثورى عار الهزيمة). وأختار المكان: أحد الملاجئ ليرمز الى انفصال "جيل يوليو 1952" عن الواقع الحياتى والواقع السياسى أيضا. واصابته بحالة من الإحباط الكامل. الشامل ، والشيزوفرانيا القاتلة بحيث فقد. هويتهم السوية، وتحول حلمه الثورى من خصوبة الفعل والانجاز الى عقد الهذيان ، والهلوثة التى تصل إلى درجة اللغو والثرثرة.
كان هذا الجيل الأخضر نقيا. شفافا يكبر مع حلمه الثورى يوما بعد يوم. وعندما وقع هذا الحلم فى الأسر(بانكسار عبد الناصر ، وهيمنة الاجهزة القمعية التى كانت تمارس الاضطهاد النفسى ، وغسل الدماغ على أصحاب الحلم) ، كسر هذا الجيل محارته الشفافة وخارج عاريا. نافيا ، يبرئ نفسه من عار الهزيمة وينتزع الخنجر القمعي من جثة فؤاده ، وكان صراخة عاليا ، وصرخته حارقة ، وشهقته نازفة تلامس لحم الحلم المتهرئ الذى يطؤه الجنرالات بالأحذية الثقيلة .
أنا لا أريد أن ألخص المسرحية ، لأن هذه العملية تفسد الإيقاع النفسي الذى يتسرب به الحوار. وتندثر به الأحداث ، بالإضافة إلى عملية إلى عملية التلخيص تسئ الى التكنيك التجريبي الذى أتبعه المؤلف الذى يتراوح بين التقطيع النفسى للجمل بحيث يوازى درجة الإحباط التى تعانى منه الشخصية ، والتفسخ الذى يجسد فساد مدينة الجنرالات ذوى الرتب العسكرية العالية . كل شئ باطل كل شئ متفسخ. كل شئ فاسد ملوث. حتى اللغة التى أصابها الإحباط والرخاوة واللزوجة والازدواجية. ومن هنا فإننى أفضل أن اقتطف لك بعض الإشرافات الداخلية والشخصيات حين تجسد خلجاتها النفسة والحوار المسرحى.
شلبى : (لحمودة) بتحب الجملة الاسمية ولا الفعلية؟
حمودة : ما بحبش الجمل
شلبى : تبقى بتحب الكلمة.
حمودة : أنا بحب الأرقام كلها وأحب الجملة الفعلية والاسمية!
"صفحة12"
ومن الواضح ان هذه الإشراقة النفسية لهذا الجيل المحبط تصور نفوره من الكلمة السالبة. ألم تهزمنا الخطب العنترية ، والبلاغات العسكرية الكاذبة ، والأناشيد الحماسية الجوفاء!
فى الملجأ الذى يعيش فيه جيل ثورة يوليو ومعه الحلم الثوري المحيط . تحاصر السلطة التى يمثلها المشرف "طه" – 45 سنة – والمشرفة "خديجة" – 45 سنة – الجيل والحلم معا ، بدأت تهشم رأس الحلم المقطوع ، وتفتت الكيان الإنسانى على مستوى "الفرد" (لا على مستوى المواطن لأن " المواطن" ليس له وجود وبالتالى فإن "السلطة" أخذت تحشد أجهزتها القمعية فى طمث ومحو ملامح ، وسمات الفرد!).
وهكذا أصبح الكل محاصرا داخل الوطن الفرد – الفرد ، والفرد المواطن ، ثم الفرد- الأمة. والأمة – الفرد ! ونجحت المؤسسات القمعية فى تقزيم الفرد وتقزيم الأمة ، ولم يبق إلا الرماد المتناثر فى الأفق الرمادي الملطخ بالدم؟!
هذه هى الفكرة المحورية حصار الفرد أدى الى حصار الوطن ، وحصار الوطن أفضى الى هزيمة الفرد ، وهزيمة الوطن!.
وينفخ المؤلف فى "جذوة الشعر" التى يتفرع فى الصدر حبالاً من الضوء الشفاف و جذوع من الاشجار المنسة ، وعشبا يابسا ينعى النهر الذي يعانى من سنوات "التحريق" والجفاف ، ويتحسس "الدقة الشعراوية" المنهمرة من ضلوع شخصياته المنحرقة للتحرر من الخوف. ومقاومة الأرهاب وممارسة الحرية " كفعلط" حياتي!
(صفحة51): عائشة : أنهار من المطر ، وترعى "العطاشى" وجسور الخيانة . وقناطر المشتاقين للعبور.
هدى: الأرض هى الأرض. الهواء هو الهوا. الشمس هى الشمس. والفصول هى الفصول ، ماتحلميش بقى!
أزهار: على القلعة حيخدونا.. زى ما أخدوا أبويا . وفى سجن القلعة رموه على القلاع فى المينا . البحر بينادينا ، والسواحل فى السحر والشفق.. ضميت دراعى للى مالوش حبيب يا سواحل الدنيا يا حلمى أمتى تاخدينى لمركب حبيبى!)
(صفحة 61) : ياسين: مدى مفرشك زخرفية بصورتى ، وصور أهلى باللون الأخضر والأحمر والأبيض ، باللون الأخضر ارسمى الأرض ، باللون الأخضر ارسمى السماء ، باللون الأبيض ارسمينا وحطى الشوك على المفارش!
جاذبية الشعر تشد المنولوج الداخلى ، فينبثق دفقة دفقة من بؤرة اللاشعور غلى الشعور ، إلى "التوج الدرامى"!
وينفجر "الكريشندو" المكتوم إيقاعا إيقاعا ، وسوناتا سوناتا ، ويمتزج الشعر بدم الحلم المهضوم ، ويبلغ الموقف الدرامى ذروته ، حين يزور "الملجأ" مسئول عظيم(من إياهم)، يحترف الثرثرة الغبية وسيدة جليلة من سيدات المجتمع (البنفسجى) ويتطلف "المشرف طه". و"المشرفة خديجة مع الأولاد" لحبك الدور ، وعدم إفساد جو الحفل الذى ستنتشر صورة ووقائعه فى الصحف . ويرتدى كل منهم قناع التلطف والمجاملة.
ويبدأ المسئول العظيم فى إلقاء كلمته ، ويقاطعه "الأولاد" بطريقة "تنافر الأضداد " ويتنامى التنافر بينهم وبينه ، وتتقدم محيية لتلقى كلمة "البنات" و "ينفجر" الحلم على هيئة"منولوج" ملتاع.
مجيدة: أنت يا وطنى ، هل أنت أمامى أم خلفى ، أم بجواري ، أم أنا أنت؟! ومن أكون أنا ومن تكون أنت؟!
حنجرتى ملايين خرساء ، يخرج من ضلوعي الفقراء ، أحلامهم أعلامهم ، وانا فى بدء الأعماق والميلاد ، كنت خطأ فى خريطتك . وسطرا فى تاريخ الخفاء ، وملجأ لبحار عاشق ، الثوار كانوا ، ومازالوا ، سكون ماساة الثائرين إنهم يوصفون بالخسة والتآمر على السلطان وقالوا إنك وطنى؟! أم ان خريطتك سحابة سراب. وخرائط الدنيا أكذوبة سحب الحق ، إنى قدمت أو أنت قدمت داخلى ، الحق أنى لا أعرف يا وطنى . لا أعرف .. لا أعرف يا ... (ص84).
هدى: كان لكل منا عري.
حموده: وعروسة.
عائشة: وحصان.
مقبل: وبسمة .
شلبى: وحلم
نادية: وخاطر.
حمودة: كنا مثل القبعة.
مقبل : والسفر.
شلبى: والألحان
ياسين: والدنيا.
حنفى : والاذان.
نادية : كنا نعرف
مجيدة: قلاع العصافير الخجلى.
أزهار: واحتمالات القدر.
عائشة: وقرارات السحب
هدى: و:إشارات القمر
نادية: كنا ن درك الحذر.
حمودة : وقوانين الجدل.
الجميع
(يغنون): من فضلك يا سيد.. خدنى فى منديلك.
وألق به فى النيل
يوما سأصير أرجوحة أطفال
من فضلك يا سيد.. منى لا تخف
فأنا أصلى حبا
وأبى لا أعرفهن :ان أبى منسيا؟
ربما كان هناك
فى أرض وسماء
شلبى: فى بهوت أو كمشيش أو الاسماعيلية.
من فضلك يا سيد.. خدنى فى منديلك.
دعنى أمام النيل! (ص 110 – 111)
لم يعضم "الوعى "جيل ثورة يوليو من "معاناة" الهزيمة " و" الوقوف " على حافة الصراخ الذى يقضى إلى الصراخ ، بل إلى طبقات متراكمة من الصراخ ، ومن يصرخ يجرونه إلى ما وراء الشمس حيث لا أحد!
ويحاول المشرف "طه" والمشرفة "خديجة " تطويع " الانفجار" وتطويقه عن طريق الترغيب والترهيب لكتابة تعهد بعدم اللجوء الى "الفعل الثورى" أسوة بـ "بيرم التونسى " الذى اعتذر للملك (؟!).
ويتخذ "الأولاد" قرارهم الحاسم ، ويعتصمون فى المبنى ، ويحتلونه ، إيماء الى انتصار "الوعى الثورى" على الواقع المشبع برائحة التحلل والعفونة
وتنتهى المسرحية بدق الجرس ، ويقف "الأولاد" فى طابور ، ويذهبون فى خطوات منظمة ويغنون.
- ضع السماعة ايها الطيب على قلب شجرة واسمع قلب الاشجار.
ضع السماعة أيها الطبيب على قلب حجرة واسمع قلب الاحجار ، إن قلبى ليس مثل قلبهم.. إن قلبى ليس مثل قلوبهم..
ويمكن القول – بإيجاز – إن هذه المسرحية تدين نظام الحكم الناصرى كمؤسسات قمعية، ولا تدين عبد الناصر كزعامة ذات إشعاع وطنى وقومى ، ومعنوى واجتماعي ويحمل عام 1968 وهو العام الذى تناوله هذه المسرحية، رمزا سياسيا ، فهو العام الذى انفجرت فيه المظاهرات الطلابية ، وتمحور"الوعى الطلابى " حول "إجتياز" الهزيمة" بقطع "رؤوس" المؤسة العسكرية الناصرية، التى كانت تدير العمليات العسكرية من غرفة القيادة بالقاهرة بينما الجنود (أبناء الفلاحين الفقراء) يعانون محنة القهر بتفوق السلاح الامريكى فى الصرحاء المكشوفة.
* اللغة الدرامية:
لا أوافق كاتب المسرحية على استخدام نمطين لغويين (اللغة الفصحى ، واللهجة العامية المحلة بالتكثيف الشعرى الشفاف) لأن ذلك – في رايي – يشتت التركيز الذهنى عند المتفرج بالإضافة الى فرض نوع من الاختلاف فى التذوق الدرامى ، والمشاركة فى "إنجاز" الحدث المسرحى ، وهذا على ما أعتقد عكس ما أراده المؤلف. الذى أراد أن يطوع اللغة الفصحى. واللهجة العامية عن طريق "التفجير الشعرى" ، والحوار الخاطف ، والمونولوج المشبع بالإيماءات النفسية إذ أن "جبروت" اللغة الفصحى ، وخصوبة إشعاعها ، وهارمونية تركيبها قلل – فى رأيى- من قيمة ،وفعالية " اللهجة العامية ، المطعمة بالشحنة الشعرية الشفافة.
والتضاد اللغوى. والتاقطع التعبيري. الذى فجرته الشخصيات عند ملامسة اللهجة العامية الشفافة لأفق اللغة الفصحى اللانهائى نجح فى إبراز الفكرة المحورية ، فقد يظن المرء للوهلة الاولى أن الشخصيات محبطة لكنه حين يستجمع جزيئات الدلالات النفسية وبخاصة فى "المونولوجات" المتصاعدة الإيقاعات يدرك " أن "الحلم" هو الذى وصل إلى حافة الإحباط ، بينما "الشخصيات" تحاول استنفاذده ، والفرار به إلى مدينة جديدة تنكشم المؤسسات القمعية أو تتلائى ، ويكبر "الكيان الإنساني" وتلامس طموحاته الوطنية والقومية حافة الأفق اللانهائى.
_ هم كما هم ولكن ليس هم الزعاليك
.... والزعاليك هنا هم الصعاليك. أى هذه "العينات البشرية" التى تضج بالحيوية ، والاندماج الامل فى دائرة الصراع الحياتي ، والتدخل الفعال فى تسيير دفة الحياة وفق طموحاتها ، وأهوائها ، وؤيتها "الفلسفية" التى تتكئ على "ممارسة الحياة" والصعايك هم هؤلاء الناس السبسطاء. الظامئون لحياة خالية من الشر والظلم ، والدمامة ، لكنهم لا يملكون أجنحة للتحليق بهذا "الحلم" إلى دائرة أوسع من دائرة أهتماماتهم اليومية التى تضيق بهم. فهم اسرى"الواقع الحياتى" المحبط (بفتح وجر الباء) ولا يستطيعون منه فكاكا. الصعاليك – إذن – هؤلاء البشر العاديون. الذين يخففون عن بعضهم بعضا كثيرا من قسوة الحياة الفظة ، الخشنة ، الغليظة ، البشعة ، هم "انيسة" ولا يهمها أن يلوث الآخرون سمعتها ، فهى الحياة الخصبة ، والخصوبة المتدفقة بماء العشق والدفءالأنثوى الحار). وعم محمود (بائع البطاطا الحلوة التى تلبي نداء الجوع عند الجماهير المتشققة الأيدى). وعبد السميع (ماسح الاحذية ، فى ثيابه الرثة وذقنة الكثيفة الشعر؟ وقدمية العارتين) الصعيدي الذى عشق الاسكندرية. ووقع فى هواها. واحتمل اذى الايام والناس فيها وعم"شحاته" و "حوده" الذى ينشطر الى أثنين "حوده" رقم"1" وحودة رقم"2" و"العسكرى" الانتهازي ، الذى يمتص دم "الغلابة" لأنه جزء من "السلطة العسكرية" وأداة من أدوات القهر ، والمثقف المصاب بالازدواجية ، والعجز عند القيام بفعل ما (فعل ثورى على وجه التحديد). والانفصام فى الشخصية ، والتعالى عن حركة المجتمع. فى نفس الوقت الذى لا يستطيع فيه قضاء حاجته ، وتفريغ أمعائه " فى المرحاض إلا بعد أن ييسر له "الصعاليك" مكانا فى المرحاضَ.
- المثقف (لعم شحاته) يا راجل أنت ، طلع الراجل اللى جوه ده !
شحاته ومحمود(معا).
حوده: (للمثقف) سمعت يا سيدى!
المثقف: الراجل اللى ج وه أ،هو راجل؟
(ص185) (يقصد الرجل الذى فى المرحاض)
وهذه السخرية المبطنة تزري بموقف المثقف (استاذ الجامعة) الذى لا ينال منه الصعاليك سوى فضلات أمعائه!
الصعاليك (كطبقة) – مقابل المثقف (البرجوازي) كممثل لطبقة ، أو شاهد عيان لانتماء طبقى أكثر وعياص ، وأ،ضج رؤية رغم محاصرة "الأقنعة القمعية" لحلمهم المحبط!
وقد برزت السمات النفسية لشخصيات الصعاليك المتميزة. المنفردة فى تعاملها الحياتى. بينما ظل المثقف نمطا(لا شخصية متميزة متفردة) مندمغا فى أنماط أخرى من الشرائح البرجوازية التى تعتلى قمة الهرم الثقافى فى "الفكر السائد المعلن" وهذه النمطية أضعفت من تأثير موقف الصعاليك كطبقة على موقف المثقفين كنمط "جشتاطلي " جامد!
وهناك نقطة أخرى، وهى مسألة اللهجة العامية" فى المسرح التجريبي ، إذ أن التجريب يقتنص "تكريس" تركيبات لغوية مشعة ، تومئ وتلتف وتتشابك ، وتندمج وتندغم ثم تنفرط فى غيقاعات درامية مشتعلة ولا أظن أن إيقاع اللهجة العامية و"تركيباته" السهلة تمكن المؤلف من إشباع اتجاهه التجريبى.
على أن الأمر من وجهة نظر تاريخية ، بقى فى هذا الاطار ، إن هذه شهادة من هذا الجيل من شاهد (أدلى بشهادة كتبها بالدم ، والطمى ، والماء الحارة) ينتمى الى جيل ما وراء الشمس حيث مملكة الكلمات السرية تتسنبل فى رحم الأرض وخصوبة النهر ، وحافة الضفة التى تخفى سر العشق وسر الكلمات الخضراء!