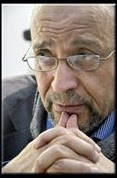دراسات من كتب د. نجاة صادق الجشعمي
( 295 )
الخبرات النفسية والأنساق الجمالية في
الموضوعات
المتمثلة برواية كل من عليها خان
النصوص المسرحية القصيرة أنموذجاً
(دراسة جماليَّة)
بقلم أ/ أحمد حنفي
دراسة من كتاب
نموذجًا
التجريب ومكونات البنـي السردية في الرواية
نموذجًا
رواية " كل من عليها خان "
للكاتب السيد حافظ
جمع وإعداد
د. نـجـاة صـادق الجشـعمى
الخبرات النفسية والأنساق الجمالية في
الموضوعات
المتمثلة برواية كل من عليها خان
النصوص المسرحية القصيرة أنموذجاً
(دراسة جماليَّة)
بقلم أ/ أحمد حنفي
الخبرات النفسية والأنساق الجمالية في الموضوعات المتمثلة برواية كل من عليها خان
النصوص المسرحية القصيرة أنموذجاً
(دراسة جماليَّة)
بقلم أ/ أحمد حنفي
في دراسةٍ سابقةٍ لي عن رواية (ليالي دبي) للكاتب الكبير/ السيد حافظ ذكرتُ أننا أمام نص روائي يؤسس وعياً جمالياً مغايراً من حيث الشكل وطرق الأداء، وهو نص يؤطِّر بذلك الوعي المغاير فكرة الغريب ومفهوم الاغتراب المكاني والنفسي والاجتماعي.
وذكرتُ أيضاً أنَّ بنية الرواية لا تتَّصف بالمرونة والانسيابية، بل نجده نصاً مرهقاً يتكون من مجموعة بنى مركبة يتعدَّد فيها الرواة وتتنوَّع فيها الأماكن وتختلفُ فيها الحقب الزمنية وتتمايزُ فيها أشكال السرد.
وهو الأمر ذاته الذي نواجهه بروايتنا التي نحن بصددها (كل من عليها خان)، والتي تُعدُّ استكمالاً لمشروعه الروائي الملحمي الذي ابتدأه برواية (قهوة سادة) ليستكمل قصة انتقال الروح الطيبة من "نفر" إلى "نور" إلى "شمس" وصولاً إلى "وجد" الروح الرابعة "لسهر".
ويستكمل أيضاً حكاية (فتحي رضوان خليل) الكاتب المثقف الذي واجه بمصرَ إحباطاتٍ دفعته للسفر إلى (دبي) مصطحباً زوجته معه، فتحي رضوان العاشق لــ (سهر) تلك الفتاة الحلم والتي تورَّط معها في علاقة غير شرعية، الحكاية في مجملها تسلط الضوء على حياة مثقف وكاتب معاصر ناقد لوطنه ومجتمعه من أجل غدٍ مختلف ومغاير.
وتقوم شخصية (شهر زاد) بالرَّبطِ بين الحكايتين وهو ما بات مألوفاً لمن يتتبع مشروع (السيد حافظ) الروائي، والنموذج الروائي (الحافظي) نموذجٌ متمردٌ، متعددُ البنى، لا يخضعُ لقالبٍ سابقٍ ويرفض قيودَ الشكلِ الروائي التقليدي ليُعلى من نبرة الحريةِ والتي هي أساس العملية الإبداعية.
تتخللُ فصول الرواية بعض الفواصل ذات عناوينَ رئيسيَّةٍ ثابتةٍ؛ وهي:
مسرحية قصيرة جدا (سبع مسرحيات)، نحن والقمر جيران (سبع حكايات)، قصة قصيرة جداً (قصة واحدة)، وبالتالي يمكننا اعتبار (كل من عليها خان) من الروايات المنتمية لتلك التي تتكئ على جماليات التشظي والتفكك، وهي جماليات تعتمد على التجاور والتوازي والتزامن كما هو الحال بسابقتها (ليالي دبي) حيث يواجه القارئُ حدثين متوازيين بزمنين مختلفين بأحداثٍ تُروى من خلال تقطيرها بوعي (الراوي/ السارد) ليصير فعل الكتابةِ تقاطعاً مع الواقعِ من جهةٍ ومن جهةٍ أخرى انتقال من حدثٍ ماضوي لحدثٍ ماضوي آخر، وبذلك يصبح للرواية زمنها النسبي الخاص ويتقاطع فعل القراءة لدى المتلقي بفعل الكتابة من أجل إعادة إنتاج المعنى والوقوف على دلالات النص وأبعاد الرؤيا التي يطرحها، وهو ما يجعلُ عمليةَ الوصولِ إلى قصد المؤلف عمليةً شاقةً.
ولأنَّ معنى النصِّ لن يتشكلَ بذاتِه مطلقاً "فلابد من عمل القارئ في المادة النصية لينتجَ معنى" على حد تعبير (رامان سلدان) في كتابِه (النظرية الأدبية المعاصرة) ص184 أي أنَّ أي تفسير لنص ما مُطالَب بأن يتحرك خارج النص من أجل أن يُشير للقارئِ "فلا معنى للنص حتى يقرأه شخص ما، ولكي يكون له معنى يجبُ أن يُفسَّرَ، بمعنى أن يُوصَّلَ بعالم القارئ" [راجع والتر ج. أونج: الشفاهية والكتابية ص282،283] ولذا فإن معنى أي نص أقوم بقراءتِهِ إنما في الحقيقة المعنى الذي أقصده لذلك النص.
ومن خلال استعراض التشكيلات البنائية لنص (كل من عليها خان) نستطيعُ التمييزَ بين نوعين أساسيين أو بالأحرى نصين أساسيين أولهما أصلياً متمثلاً في قصة (فتحي رضوان خليل) وحكاية الروح الرابعة لسهر، وثانيهما متشظياً متمثلاً في النصوص المسرحية القصيرة جداً ونحن والقمر جيران وقصة وحيدة قصيرة جداً، رأيتُ أن أتوقفَ أمام النصوص المسرحية السبعة لما تمثله -ظاهرياً- من خروجٍ عن النص الروائي؛ حيث أن حكايات نحن والقمر جيران مرتبطة بجيران (فتحي رضوان) أي أنها ذات صلة -غير مباشرة- ببطل الرواية، كما أنَّ تاريخ (السيد حافظ) المسرحي أحد أهم ملامح تجربته الإبداعية مؤلفاً وممثلاً ومخرجاً.
الموضوعات المتمثلة في النصوص المسرحية القصيرة جداً
تشترك المسرحيات السبع في عدم وجود زمانٍ محددٍ لها ولا مكان، باستثناء المسرحية الثانية والتي حدد فيها المكان بمقهى والزمان نهاراً، وهما في حقيقتهما غير محددين؛ فالمقهى غير معلوم أهو في مدينة أم قرية والنهار لا أعتبره زمناً بقدر ما هو صفة لزمن كما أنه ينطوي على فعلٍ متكرِّرٍ.
كما تشترك المسرحيات في عدم وجود بطل حقيقي يمتلك اسماً وتاريخاً وهيكلاً بنائياً (جسمانياً ونفسياً واجتماعياً) بل هي شخصيات أقربُ إلى التجريدِ تمثلُ أفكاراً خالصةً فكان منطقياً جداً ألا نجد أسماءً وأن يكون الغالب وصفهم حسب النوع (رجال - نساء) أو المهنة (جرسون- كما في المسرحية الثانية)، وقد تكون الشخصيات نصف بشرية حيث كانت بعض الأصوات لرجال ونساء هي البطل في المسرحية الخامسة ولا ظهور لأصحابها على خشبة المسرح، كما تعدت الشخصيات حاجزَها الإنسانيَّ في المسرحية السادسة لتكون مجرد بقعٍ ضوئيةٍ ملونةٍ تتصارعُ.
كما كان لخمسٍ منهن غيابٌ تامٌ للحوار والذي يُعدُّ العنصرَ الرئيسَ في أي نصٍ مسرحيٍّ، حيثُ كان الحوار في المسرحية الثالثة صرخة لرجلٍ يقول "لا"، بينما تتميزُ المسرحية الخامسة بغلبةِ الجمل الحوارية عليها وذلك تبعاً لطبيعتها حيثُ لا وجودَ لشخصياتٍ حقيقيةٍ تظهرُ على المسرحِ، وهي في رأيي أضعفهم وأقلهم قيمةً نظراً للحوار المباشر جداً والفاضح والبعيد عن الرمز والإيحاء كسمتين اتسمت بهما باقي المسرحيات.
المقدمات المنطقية للمسرحيات السبع (حسب اصطلاح لاجوس اجري في كتابه فن كتابة المسرحية، ترجمة دريني خشبة) كانت في معظمها تدور حول فكرة صراع الفرد مع السُّلطةِ؛ حيثُ بَدَت السلطةُ في المسرحية الأولى تدَّعي الديمقراطية بينما الرجل الذي ينام على سرير متواضع يقول "نعم" وحين قال "لا" ماتَ بالرَّصاصِ، و(الجرسون) في المسرحية الثانية مثالاً للمواطن المكبَّلِ بقيود وضغوط رجالِ السلطةِ ولا يَلقى جرَّاء غضبِه وثورتِه على استعباده إلا السجن في قفصٍ خشبيٍّ مكتوبٌ عليه (الوطن)، بينما بدا الصراعُ متعددَ الأطرافِ في المسرحية الثالثة حيث يقع (البطل/ الرجل) بين فريقين من النساءِ (مرتديات الملابس البيضاء يميناً ومرتديات الملابس السوداء يساراً) يجتذبنه وينتقل من يد واحدة للأخرى حتى ينهارُ فيموت ويتكرر الحدث مع رجل آخر أما الثالث الذي لا يقترب منهن يقتلنه ليظلَّ أي (الرجل/ البطل الأخير للمسرحية) ضحيةَ اختياره في البعد عن الصراع، أما في المسرحية الرابعة (فالبطل/ الرجل القصير/ الوطني) يموت دفاعاً عن عَلمِ بلده حتى لا يُسرق لتظلَّ جثته على المسرح ملقاةً لا يتم سحبها إلا بدخول رأس السلطة على خشبة المسرح محاطاً بالكاميرات والإعلاميين، والحوار الفاضح في المسرحية الخامسة يوضح فكرة صراع الفرد مع السلطة بشكل مباشر كتلك الجملة الحوارية مثلاً: "الوطن غائب والمواطن فعل ماض معتل"، وشعار (البقاء للأقوى) هو منطق القوة الحاكم والمسيطر والذي يفرض كلمته في المسرحية السادسة، بينما يشير (السيد حافظ) من طرفٍ خفي في مسرحيته السابعة عن الوطن الذي تفرَّغ من رجاله الصالحين ليكون سقوط الوطن نتيجة حتمية.
وكان لتكرار الفعل المسرحي دوره في التأكيد على ديمومة صراع الفرد مع السلطة كما أن له دلالته حيث يعكس الخبرة النفسية السلبية للمؤلف تجاه وطنه ومجتمعه.
والآن نستطيعُ طرح نفس التساؤل الذي طرحه (رومان إنجاردن) أثناء تصديه للبحث الجمالي وتعلقه بماهية العمل الفني الأدبي ونحن بصدد الحديث عن الوظيفة الفنية والجمالية لتلك النصوص السبعة وعلاقتها بالرواية (النص الأصلي)، حيث تساءل قائلاً: "تحت أي نوع من الأشياء (الظواهر) يمكننا وضع العمل الفني الأدبي، الواقعيات أم المثاليات؟
بدايةً فرَّق (إنجاردن) بين الأشياء الواقعية والأشياء المثالية؛ حيثُ رأى أن الأولى تنشأ في نقطة زمنية ما وتوجد لوقت معين ومن المحتمل كذلك أن تتغير أثناء مجرى وجودها ويمكن أيضاً أن تنسحب من الوجود، أما الموضوعات المثالية لا يسري عليها شئ من هذا فهي لا زمانية وبالتالي تبقى بلا تغيير.
[راجع: علم الجمال الأدبي عند رومان إنجاردن، سامي إسماعيل ص92 وما بعدها]
والمسرحيات السبع لا زمن لها كما استعرضنا؛ فالحدث لا ينشأ في نقطة زمنية معينة وغالباً لا ينتهي وذلك لتكرار الفعل المسرحي مع شخوص آخرين، فهي على الأحرى موضوعات مثالية قامت على الخبرات النفسية للمؤلف نفسه.
والملفت في الرواية أنها ذات نزعتين إحداهما تاريخية (حكاية البنت وجد والولد نيروزي وثورة النساء)، وثانيتهما نزعة اجتماعية (حكاية فتحي رضوان وسهر)، هاتان النزعتان تفرطان في التشديد على علاقة الفن بالواقع، ولكن حين تُختزل دلالة مضمون أي عمل أدبي إلى مجرد التعبير عن هذا الواقع فهو يُعدُّ إساءة فهمٍ لهذه العلاقة؛ فالسيد حافظ لا ينقل لنا أبداً بعض العادات الاجتماعية أو أسلوباً حضارياً معيناً ولا تطوراً تاريخياً لحقبةٍ ما، وإنما ينقل لنا خبرةً نفسيَّةً معينةً مرَّ بها، كان تجليها الأمثل ليس في النص الأصلي وإنما في تلك التشظيات المسرحية ذات الشحنات الرمزية وما تحويه من موضوعاتٍ متمثلةٍ وُضعت بوصفها نظائر قصديَّة؛ أي توجد فقط بوصفها مقصودة ولا وجود لها خارج هذا القصد، فهي ليست متأصلة في الوجود الواقعي حتى وإن بدت لنا كما لو كانت واقعية، وإنما وجودها الأصلي في خبراتِه النفسية.
وإذا كانت فكرة صراع الفرد مع السلطة هي الفكرة المسيطرة على المسرحيات السبع، وهي خبرات المؤلف النفسية كما ذكرنا، هل يجوز لنا أن نفسر من خلالها النص الأصلي (قصة فتحي رضوان وانتقال الروح الطيبة)؟
أستطيعُ القول أن محاولة تفسير وقراءة العمل الأصلي بالرواية من خلال الخبرات النفسية للكاتب ليس عبثاً كما ادعى (رومان إنجاردن) – وهو في ادعائه ليس مخطئاً أيضاً – لكنه الشكل الجديد متعدد البني الذي ابتكره (السيد حافظ) هو ما جعلنا نثبت خطأ (إنجاردن) في تلك الحالة فقط؛ فإن كان (إنجاردن) يرى أنَّ "خبرات المؤلف النفسية تنسحب من حيز الوجود في نفس اللحظة التي يدخل فيها العمل الأدبي الذي أبدعه إلى حيز الوجود" [علم الجمال الأدبي عند رومان إنجاردن ص96] فقد نُسلمُ بصحة تلك المقولة في حالة عدم تسجيل المؤلف لتلك الخبرات في نصوص متشظية تمثل خروجاً عن النص الأصلي ذاته كما في حالة المسرحيات السبع التي نحن بصددها، ولأن تلك الخبرات النفسية المحفزة لكتابة النص الأصلي تتسمُ بأنها قصيرة الأمد لا تستطيعُ البقاء في حيز الوجود بعد أن مرت فقد قبض عليها (السيد حافظ) وصاغها في هيئة نصوصه المسرحية والتي قامت مقام الكادرات الفوتوغرافية لحالته النفسية (خبراته النفسية) أثناء الكتابة.
أي – وبصيغة أخرى: مثَّلت تلك المسرحيات القصيرة خروجاً وانزياحاً خارج النص الروائي الأصلي من أجل أن تشير إلى القارئ على تلك اللحظات والخبرات النفسية التي اختلجت بصدر الكاتب وحلقت فوق رأسه أثناء تسجيل نصه الأصلي، إنها قراءة (السيد حافظ) نفسه لرؤيته التي يبثها على مدار مشروعه الروائي كله وليس (كل من عليها خان) فحسب، إنها محاولات لقراءة رؤية الذات، محاولات تفسيرية تهدف إلى الاتصال المباشر بعالم القارئ. بما يمكننا أن نقول أنَّ (السيد حافظ) هو القارئ الأول الذي فسر النص الأصلي وأوجد معناه ليس من خلال قراءة تفسيرية عادية بل من خلال تسجيل خبراته النفسية، لتتراجع لدينا معضلة (قصد المؤلف) و(استقلالية النص) والتي تثيرها دائماً النصوص المتشظية.
هل تلك النصوص المسرحية نصوصاً عبثية؟
رأينا كيف كانت تميل تلك المسرحيات لتجريد الشخصيات من محتواها البنائي وكيف أنها كانت تميل للرمز في عرض أفكارها وكيف أن موضوعاتها متمثلة غير واقعية وإن بدت لنا غير ذلك كما رأينا تقنية تكرار الفعل المسرحي والذي يؤدي إلى تكرار الأزمة والصراع، أليس ذلك كله أقرب إلى مسرح العبث؟
يقول الدكتور (عبد القادر القط) في كتابه (فن المسرحية) ص441 أثناء حديثه عن مسرح العبث:
"يعد مسرح العبث خطوة بعيدة في سبيل التجريد والبعد عن محاكاة الواقع في صوره الخارجية والبحث عن صور الواقع في دخيلة النفس الإنسانية، وفيما تنطوي عليه أشكال الحياة وسلوك الناس من حقائق كامنةٍ تحت ذلك السطح الظاهري"
كما أن اتجاه العبث في موضوعه الأساسي جاء ليعكس إحساس الكاتب بعبث الحياة العصرية وقيامها على كثير من الأوضاع غير المعقولة والمتكررة بذات الأحداث لتحل الحيرة وضرورة الانتباه واليقظة عند المشاهد محل انفعالات التعاطف والاندماج، وهو ما أراه موجوداً ومتحققاً في تلك النصوص.
الأنساق الجمالية للنصوص المسرحية السبعة
باعتبارها نصوصاً مرافقة
النَّصُ المرافق في المسرح المتمثل في الجمل الإرشادية ووصف الانفعالات المختلفة للشخصيات وحركة الممثلين على خشبة المسرح والديكور والإضاءة يُعدُّ أحد أهم جماليات الفن المسرحي، لكن النص المسرحي أساساً يكمنُ في الحوار "ذلك أن الحوار في المسرحية هو الأداة الرئيسية التي يبرهن بها الكاتب على مقدمته المنطقية، ويكشف بها عن شخصياته، ويمضي بها في الصراع" [فن كتابة المسرحية، لاجوس اجري ص416]
لكن المسرحيات السبع التي بين أيدينا تكادُ أغلبها تكون نصوصاً مرافقةً صرفاً لغياب الحوار كليَّةً باستثناء المسرحية الخامسة وكان لذلك أثره حيثُ أن الحضور الطاغي للنص المرافق يجعل المسرحيات القصيرة جداً "أكثر قرباً من مفهوم المسرح الذي يعتمد على إبانة الفعل الإنساني أكثر منه عرضاً لأفكار الشخصية"
[الفعل المسرحي في نصوص ميخائيل رومان، حازم شحاتة ص191،192]
وبالتالي لا يمكننا تقسيم تلك المسرحيات إلى نصوصِ انفعالاتٍ ونصوصِ حركةٍ بل هي الاثنينِ معاً لتعويض غياب الحوار من جهة، ولنفي فكرة اندماج المشاهد وتعاطفه من جهةٍ ثانيةٍ مما يستلزمُ الانتباه واليقظة الدائمين، فالخبرة النفسية لا يجب تلقيها بالشحن العاطفي وإلا فقدت دورها.
إن دمج الانفعالات مثل الوقوف أمام العلَم في المسرحية الرابعة والغناء بدون صوت مع حركة الرجل أثناء الدفاع عن سرقة العلم/ رمز الوطن ومن ثمَّ قتله، ثم دمج حركة دخول الرجل العملاق/ رمز السلطة وتحيته للجماهير مع انفعالات الفرح والسعادةـ أدى إلى تحويل دلالة الوطن عند كلٍّ منهما؛ وبالتالي وضعنا أمام صورتين متقابلتين من ماهية الوطن عند رجل الشارع ورجل السلطة، وكل ذلك دون حوار.
أيضاً من الأنساق الجمالية للمسرحيات السبع باعتبارها نصوصاً مرافقةً:
نسق الحضور/ الغياب
فبازدياد حضور النص المرافق تزداد سرعة الإيقاع مما يؤدي لحضور الفعل/ الحدث على حساب غياب اللغة/ الحوار
نسق اللقطة المقربة بدلاً من اللقطة العامة
ساهم طغيان النص المرافق في التركيز على فعل الشخصيات أكثر من اهتمامه بالحبكةِ، أي أن أفكار المسرحيات تنبع من حركة الشخصيات وردود أفعالها أكثر مما تنبع من أفكارها، وهو ما يشبه اللقطة المقربة للشخصية.
نسق العناصر شبه اللغوية
ظهر ذلك النسق كنتيجة مباشرة لغياب الحوار بل وبديلاً عنه أيضاً؛ فالنصوص لا تعتمدُ على الحوار في إنتاج الفعل المسرحي أو الدرامي، وهو ما سمح بإبرازِ المعاناة النفسية للشخصيات في صراعها مع السلطة، مثل صرخة الرجل في المسرحية الثالثة، وصوت الرصاص في المسرحيتين الأولى والرابعة، وصراخ وبكاء وعويل النساء والموسيقى الراقصة في المسرحية السابعة.
وختاماً:
فقد استعرضنا كيف شكَّلت تلك النصوص المسرحية خروجاً وانزياحاً عن النص الروائي الأصلي كونها خبراتٍ نفسيةً مصاغةً على هيئة كادرات فوتوغرافية، وفي الوقت ذاته لا تتم قراءة العمل الأصلي بالرواية إلا من خلالها كمحاولات تفسيرية تهدف إلى الاتصال المباشر بعالم القارئ.