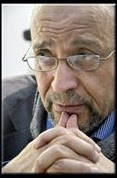المكتبة
المسرحية
مجلة فنون العراقية – بقلم زكريا عبد الجواد
حكاية الفلاح عبد المطيع
قبل
أعوام استضافت "فنون" الدكتور سعدى يونس وأعضاء فرقته لتقديم مسرحية
"حكاية الفلاح عب المطيع” للسيد حافظ. وتم عرضها أمام مبنى المجلة فى الهواء
الطلق، وعرضت فى أماكن مختلفة أخرى.
المسرحية
صدرت فى الكويت مؤخراً وهنا نقدم عرضاً للنص.
- المحرر-
- فى مجمل مسرحيات السيد حافظ يمكن ملاحظة
ذلك الإلحاح على أن الغد الأكثر إشراقاً لابد قدومه مهما اتسعت مساحة الأيام
الغائمة، لذا فإنه يوظف جميع شخوصاتها لإعطاء المتلقى انطباعاً يدين به القهر
والظلم والتسلط، ويمكن الإمساك بذلك فى المسرحية الأولى من الكتاب "حكاية
الفلاح عبدالمطيع" فهو لا يقف عند حد الوصف والشرح الفنى فقطن وإنما الإدانة
الصارخة والساحرة من بشاعة القوى القاهرة وديماجوجيتها.
فالمسرحية تحكى ببساطة، إن عين السلطان المملوكى قنصوة الغورى قد أصيبت بمرض فالتم
الاتباع والحاشية، واقترحوا إصدار فرمان بأن يرتدى الخلائق الملابس السوداء وإن
تطلى منازلهم بذات اللون وأن تمنع الأضواء والأفراح وكل ما يخالف مراسيم الحداد
العام.
لكن عبد المطيع وهو هنا شخصية كسولة سلبية،
ساذجة إلى حد البله، لا تصل إليه تلك الأوامر، فيقبض عليه ويعذب بحجة تحدى الأوامر
وعندما يخرج ويرتدى السواد ويصبغ حتى حماره به نجد عين السلطان تبرأ من مرضهات
فيصدر "الفرمان" بأن تعود الأمور طبيعية بلا سواد ويمنع تماماً الظهور
بذلك اللون الحزين.. ولا يعلم عب المطيع الساذج بهذا أيضاً، فيعاد القبض عليه
أيضاً بالتهمة السابقة.
وبين البياض والسواد بين الأمر بالحزن، تدور
أحداث المسرحية فى إسقاط بارع وإشارات لممارسات غاشمة أوصلت إنسان الشرق التعس إلى
ذروة الإحباط والخوف، وأسقطته فى سلبيلة قال أن توجد بعيداً عن تلك البقعة التى
تكالبت عليها عوامل الانحطاطات المتوالية والأطماع الاستعمارى والعنصرية من أفجاج
الأرض بينما يبعد البسطاء حتى عز ابداء الرأى فى أبسط الأشياء المؤثرة على
حياتهم.. خوفاً وقهراً ورعباً.
والمسرحية تقع فى فصلين ويمكن تصنيفها ضمن
مسرحيات الملهاة الجادة. أى تلك التى تتخذ من الكوميديا الراقية طريفاً لبناء
الحدث وتصعيده والتى تتبع جديتها من خلال المواقف المتعدد الحاملة سخرية مريرة..
يتطلبها الموقف.
وقد أجاد الكاتب تحريك شخوصه بدءاً من
الشخصية المحورية "عبد المطيع" وانتهاء بالشخصيات الثانوية، وجاء الحوار
ملائماً لطبيعة كل منها وسلوكياته وحالاته النفسية جاء اختيار اللحظة التاريخية
منسجماً مع طبيعة الأحداث وإن لم يكن هناك تركيز على الجو التاريخى لذلك العصر
وعلى أحداث المسرحية حتى أنه يمكننا حذف اسم السلطان الغورى وكلمة
"فرمان" مثلاً لنجد أننا لا نكون أمام مسرحية تاريخية بقدر ما يكون
للواقع حضور مكثف وواضح هى أفضل مسرحياته الثلاث التى احتواها الكتاب. وهى تعتبر
طيباً فى المسيرة المسرحية العربية الجادة، ولا شك أن السيد حافظ قد خظى بها خطوة
واثقة فى عالم رحب وممتع هو عالم المسرح.
وتقدم المسرحية الثانية "علمونا أن
نحيا".. الحوار الدائر بين الشخصيتين الرئيسيتين واللذين يحملان مفاهيم
وأحلاماً متباينة تماماً، اجتمعا معاً فى غرفة واحدة من غرف السجن ودار بينهما
حوار يبدأ فى الإشارة الأولى بالفصحى، ثم ينتقل إلى العامية فى الأشارة الثانية
ومن خلال ندرك أن هناك سجينين الأول يعمل صحفياً ويسجن بتهمة سياسية، والثانى تاجر
ويسجن لارتكابه جريمة قتل.
والحوار الدائر يكشف عن مدى وعى كل منهما،
لكن الذى يجمعهما معاً هو حلم الإفراج، الأول لكى يحارب الأعداء (على المستويين
الخارجى والداخلى)، والثانى لكى يعيش مع زوجته الرابعة، وبين الحلمين مسافة كبيرة
تفصل ما بينهما بحجم الوعى ومسار العاطفة، ويشتد حلم الإفراج وقت الغارة المعادية
التى تستمر طوال المسرحية وعلى مدار الإشارتين فيها، ويجسد المؤلف هنا عذبات الوعى
حيث يقف السجين الثانى (غير الواعى والسلس الانقيادن الذى يحمل العواطف المتناقضة
والمشوشة) مناقضاً للسجين الأول (الصحفى والسياسى الحالم).
غير أنه يعود ليؤمن مع السجين الأول بطلوع
وقت آخر جديد رائع، حتى نهاية المسرحية حيث ينهار حلمهم بإصدار قرار التحفظ
واستمرار الحبس بعد انتهاء الغارة... وقد كان للقطات الجانبية وتوزيع نقاط الضوء
الأثر الكبير فى إثراء الأحداث والغاء الظلال على دخائل ومكونات السلوك عند كل من
الشخصيتين المحوريتين، إلى جانب الحوار الملائم والذى لا تخفيه كثرة الأغلاط
الطباعية، وترقيم الشخصيتين.
أما المسرحية الثالثة "الخلاص"
وتدور أحداثها فى الفترة من 4 حزيران 1967 حتى 6 تشرين أول 1973، حيث يستدعى
المؤلف ثلاثة من الشهداء الأشقاء "صابر ، هادى، سلام" فى جو احتفالى
انشادى ليروى كل منهم قصة الاستشهاد ولعلنوا عن تحديهم للموت وللهزيمة، حيث تلمح
من خلال حوارهم ذلك الخيط الذى يربط مسرحيات السيد حافظ، والذى يتمثل دائماً فى
تحدى الظروف القاهرة والتبشير بالغد الواعد الرائع، الذى تخلفه سواعد الرجال وعزائمهم القوية.
والمكان : مدينة السويس، حيث تكون التضحية
الدائمة، منذ أن حفرت القناة وحتى حروب 56، 67، 73.
وحيث تكون صلابة المقاومة وشجاعة الفداء
الرجولى، سمة عظيمة تتضح بها جباه البشر فى تلك المدينة الباسلة فى لغة أقرب إلى
الشعر العامى المصرى يتبادل الأشخاص فى تدفق حماس وخطابية إحياناً انشاد أهازيج
حماسية عن الأرض التى تروى بدماء الرجال وعرق جباهم وعن الشمس المتلألئة فى العيون
والنهار الوردى والحلم الطالع.
حتى نصل إلى نهاية المسرحية ليغنى
"الكورس" :
"ازرع لا.. للهزيمة، ازرع لا، ازرع لا فى
وشط عدوك"....
و "اطلع فوق الهزيمة مقاومة واضرب..
اضرب رصاص واحصد خلاص.. احصد.. احصد.. خلاص" وهكذا تمزج المسرحية بين الرصاص
والخلاص، ومنذ الحرف الأول فيها، وحتى الأخير، يظل للمقاومة الصوت الأعلى
باعتبارها الحل الأوحد فى مواجهة عدو شرس.
زكريا عبد الجواد