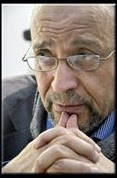عبد السلام بوسنينة
مقدمـة:
نرى أن سمة العصر هي "اختصاص" في مجالات ثقافية مختلفة و متعددة.و فيما يتعلق بالدراسات النقدية، نجدها تنحومنحى الاختصاص، حيث تختلف باختلاف أجناسية الإبداع و المتون، لأن طبيعة الإبداع سردا كان أم شعرا أم مسرحا، يتغيا من الدارس البحث في الأدوات و المناهج الملائمة لأي نوع أدبي أو فني.
انطلاقا من هذا الرأي نود في هذا المقام تناول الظاهرة المسرحية بما يوازيها من تحليل، و ما يقتضيه الاختصاص المنهجي في المسرح من ضوابط. إننا في مقاربتنا للنص المسرحي، سنحاول تطبيق المنهج الذي يحاول أن يدرس المسرحية من زاوية الكتابة الدرامية،و من زاوية الكتابة الإخراجية: إنه التحليل الدراماتورجي الذي ينظر إلى المسرحية " نظرة شمولية تسعى إلى الإحاطة بأهم العناصر السينوغرافية الموجودة في نص الحوار أو نص الإرشادات المسرحية: تحليل يركز على سائر العناصر التي
من شأنها أن تتيح نقل النص من الكتابة الدرامية إلى تصور العرض بتقنياته المختلفة "
سنحاول إذن التشبت قدر المستطاع بهذه الطريقة في التحليل، إيمانا منا بأن الممارسة المسرحية هي جمع بين لغتين، لغة سمعية و أخرى إشارية. بمعنى النص كمنطوق لفظي، و العرض كمنطوق إشاري حركي، و ما يضاف إلى العنصرين معا من عناصر تكون في غالب الأحيان ضرورية لبلورة العملية المسرحية في شكلها التكاملي و النهائي.
إن المسرح اليوم هو تقاطع كل مكوناته، و القراءة الأحادية لمكون دون آخر لاتجدي نفعا،ً لأن النص المسرحي لا يكتب إلا بمقصدية التفعيل على الركح. كما أن مؤلف النص المسرحي حينما يكتب لا يكون تصوره محصوراً فيما يكتب، بل يتسع هذا التصوركلما آمن بأن النص سينتقل بالفعل و القوة إلى متدخلين آخرين من قبيل السينوغرافي و المخرج و الممثل و غيرهم.
لقد وقع اختيارنا على مسرحية "حرب الملوخية" لصاحبها السيد حافظ التي سنقاربها بناء على العناصر التالية : البناء المعماري لنص المسرحية، التناص في المسرحية، الصراع الدرامي ، الفضاء المسرحي، اللغة المسرحية، خصائص السينوغرافيا.
المضامين:
حرب الملوخية هي حرب على الواقع و التاريخ، و كشف لمجموعة من الحقائق التي مسها التزوير و التدليس. هذه الحرب سيختزل المؤلف أطوارها عبر عشر معارك. و كل معركة تمثل مشهدا مسرحيا، تبدأ كل معركة/جولة بدخول فتيات يحملن لوحات كتب عليها عنوان المعركة. و كأن المؤلف بهذا التمهيد يعلن بداية جولة أشبه بمواجهة على حلبة ملاكمة أو مصارعة.
المعركة الأولى تبدأ بسؤال الهوية و الانتماء. فمصر التي طالما اعتبرها المصريون أماً، يراها التاريخ غير ذلك، حيث ألغى أنوثتها، و وقع عن طريق مجموعة من الحقائق على الإسم الحقيقي، و هو أن مصر تحمل دلالة الذكر بشهادة مؤرخين و مؤلفين من أمثال الجوهري و الجاحظ و الهمداني. و من بين القضايا التي كانت مصدر صراع في هذه المعركة، هوية حكام مصر، حيث أتبث التاريخ في مواجهة معارضيه أن مصر لم يحكمها إلا مصري حقيقي واحد و هو "جمال"، الذي جاء ليحكم مصر بعد طوفان نوح، و بعد جده الأول "مصريم". أما الحكام المفترضون، فهم إماأكراد أو إيرانيون أو أتراك .
تنتهي المعركة الأولى ليدخل المخرج معلنا عن بداية المسرحية، مباشرة مع بداية المعركة الثانية، ليتحول الديكور إلى قصر السلطان المستنصر. تبدأ المعركة بتنصيب المستنصر خلفا لأبيه الظاهر بالله، ثم يبدأ الحاضرون في استحضار مناقب الراحل الظاهر بالله، ليقول الوزير في حقه:
"الناس كلها حزينة عليه...كان مفرح الناس و حاسس بيهم..حشيش عطيهم افيون زراعة ليهم..بيوت دعارة سيبها تيلسهم خمارات للفقراء و الأغنياء..الله يرحمه كان مزاجتلي..كان يحافظ على مزاج الشعب."
يعمد المؤلف في هذا المشهد إلى إبراز شخصية المستنصرو هو طفل ميال للهوو اللعب. و في ظل حالته هذه، تتهيأ أمه سكينة لنسج بطانته. وأول الموالين أبو سعد النخاس اليهودي لتقول عنه رغم معارضة عمة المستنصر:" دا مستشار مولانا الخليفة المستنصر بالله". و بعد صراع بين سكينة أم المستنصر و عمته، تحسم سكينة الأمر لصالحها. و بعد إظلام المشهد، يتدخل المخرج محتجاً على مؤلف المسرحية :
" فين المؤلف..إزاي ولد عنده سبع سنين يحكم مصر و الوصي على العرش نخاس يهودي اسمه أبو سعده و أمه زنجية دا كلام حيودينا في داهية ".
و في محاولة لمنع المسرحية، يتدخل الضابط و الرقيب، لكن بعدها يتمكن المخرج من إغراء الرجلين بأكلة الملوخية، و تستمر المسرحية.
تنتهي المعركة الثانية، و تدخل البنات و هن يحملن لافتات المعركة الثالثة بعنوان "تجار مصر سرقوها". وهذه المعركة تؤسس مرحلة هامة من حياة المستنصر الذي بلغ الثلاثين من عمره. و قد وسمت بجفاف النيل و شح الأسواق من الخبز، الأمر الذي سيدفع بالأهالي إلى التظاهر و الاحتجاج، بعدما أكد الخبازون اختفاء الخبز باكراً. يقول خضر :
''خلصنا الخبز، خبز مفيش.. عيش مفيش.. عجين... النهار ده العيش خلص.. بكرة.''
يشتد الصراع لتتدخل الشرطة و تضرب الجماهير: لقد اختفى القمح عن الأسواق نتيجة احتكار التجار له. و لم يعد في مقدور الناس إلا انتظار ساعة ظهوره ليعلن التجار مقابلا خياليا لاقتنائه. فأحداث و وقائع السوق تحرج الحاكم المستنصر، لأن شح السوق من القمح لا يبرره جفاف النيل كما أكدت ذلك ست مصر :
''لا يا مولاي سوء التبرير هو سبب المجاعة و إذا غاب ماء النيل يبقى السبب غياب العدل في مصر.''
المعركة الرابعة عبارة عن رصد لوقائع غريبة تعرفها الأسواق. فندرة اللحومو اختفاؤها يدفع بالتجار إلى تسويق بديل آخر يكمن في بيع الكلاب و القطط. و قد ابتدع هؤلاء التجار كل الأساليب المقنعة لجلب الزبائن قصد استهلاك هذه اللحوم و طهيها مخلوطة بالملوخية. لقد ضاق ذرع السكان فأقبلوا على الاستهلاك، حتى أنهم اضطروا لبيع أبنائهم لضمان حفنة قمح و رطل من لحم الكلاب. يقول حاجب الخليفة :
''كل ما تمشي في السوق تلقى الناس ماشية تبيع أولادها و بناتها علشان القمح.''
أما داخل القصر، فيستمر الخلاف حول استصدار أمر بشأن ترخيص لبيع الحشيش باعتباره و سيلة للتخدير و القضاء على الأفكارالهادفة.
يتصدر المعركة الخامسة سؤال (مين يشتري مصر؟) حيث يستمر الصراع، و الخلاف عن أسباب اختفاء الخبز. فبعد ما تمرد الناس ثانية، تتدخل الشرطة لتقمع الجماهير و تسكت أصواتهم.وبعدها يتدخل الوزير في شكل حوار مع الجماهير، مقنعا إياها بحل المشكل. و يعمد إلى ممارسة الضغط على عريف الخبازين قصد تخفيض الثمن و فتح الدكان. ورغم الخسارة وعدم إشراك تجار القمح في الحل، رضخ العريف للأمر الواقع، و فتح أبواب دكانه، لتكون أميمة الزبونة الأولى المستفيدة من حل غير عادل.
في المعركة السادسة تتواصل المظاهرات بسوق الخبازين. و في القصر يحتد الصراع حول دواعي هذه الاحتجاجات و كيفية معالجتها. فالحاكم المستنصر لا يخرج عن منطق التجار لتبرير اختفاء الخبز، معتبرا شح النيل هو سبب شح الأسواق، و أنه مصيب في سياسته بإقراره حرية التجارة. ليؤكد نجاعة رأيه. يقول مخاطبا ست مصر: إننا في زمن جديد.. زمن حرية التجارة العالمية. ولترد عليه ست مصر قائلة :
''أننا في زمن رديء.. أن يتحكم ألف تاجر في ملايين البشر.''
و بوقاحة الحاكم غير العادل، يجهر المستنصر بكراهيته لشعب مصر، معتبرا نفسه العاقل الوحيد في تاريخ الفاطميين بين حكام مصر.
المعركة السابعة ترصد الصراع بين رموز الفساد في مصر، و بين أبي زيد القادم من تونس في مهمة تجارية. لم يكن أبو زيد يتوقع اتهامه بالتجسس رفقة صاحبه دياب. كمالم يكن يتوقع محاولات استقطابه لخدمة رموز العار في عهد الحاكم المستنصر. فرغم إلحاح سكينة أم الخليفة العاشقة المتهورة، واجهها أبو زيد بحزم الفارس الذي لا ينبطح لإغراءات النساء مهما كان مركزهن.
تقول سكينة راغبة في مودة أبي زيد : أنا أقدر اطلعك ... بس على شرط
أبو زيد : ايش هو الشرط ؟
سكينة : تتجوزني و أهرب معك.
والإغراء نفسه تقدمه بائعة الهوى " أم بوسة ". لكن أبو زيد يرفض مكرها خداعها. فهو يتطلع إلى الحرية دون إساءة أو تلطيخ لشرفه وسمعته، ليواصل بعد ذلك صموده أمام أمير الحشاشين الذي رغب في استغلاله و خدمته مقابل مساعدته على الهرب.
ينتهي المشهد السابع بقبول أبي زيد حلا يقترحه عليه شهاب -مقابل حريته- و ما هذا الحل غير مزاولة عمل دفن الأموات.
أبو زيد سيخوض المعركة الثامنة المليئة بالمفاجآت :
الصدمة الأولى : دفن الموتى دون اغتسال
الصدمة الثانية : الانتقال من أكل الحيوانات إلى أكل لحم الآدميين.
و أمام هول و روع ما شاهده أبو زيد، بمعية رفيقه دياب سيقبل على الفرار تاركا خلفه مأساة تعتبر استثناءً في تاريخ الشعوب.
يتوزع سوق الخبازين و قصر المستنصر فضاء المعركة التاسعة، فيعمد فرحان إلى تخفيض ثمن الخبز، الشيئ الذي أزعج باقي الخبازين، ففارت ثائرتهم، و اعتبروا الأمر إخلالا بضوابط السوق و قوانينه،وأن تخفيض ثمن الخبز هو تلاعب بالأسعار. و هو في النهاية مصدر خسارة كبرى لباقي الخبازين.
وسيحظى الخلاف بين فرحان الخباز و عريف الخبازين خضر باهتمام المستنصر وحاشيته. و سيكون هذا الاحتكام إنصافاً لفرحان و للزبائن، إذ سيلجأ فرحان إلى المحافظة على الثمن المُسَعَّر من لدن عريف الخبازين، و الزيادة في وزنه، الشيئ الذي سيرفع من عدد المقبلين عليه. كما سيدفع باقي الخبازين إلى الدخول في المنافسة بالزيادة في أوزان مبيعاتهم.
كانت المعركة العاشرة بمثابة أم المعارك. فالتسيب الذي عرفته أسواق الخبزأدى بالأهالي و السكان إلى إعلان تذمرهم، و سخطهم على الحاكمين. وكانت النساء مصدر هذا التمرد. و هو في الأصل تمرد مزدوج: تمرد على الرجال و على سكوتهم. و هو أيضا تمرد على التجار و من يحميهم من الحكام. وقد عبرت النساء عبرن عن موقفهن هذا من خلال أغانيهن: "يغنون لما الرجالة نامت ستات مصر قامت.. و لما الرجالة سكتت ستات مصر قالت"
(وتنتهي المعارك بمعاقبة التجار، و عودة الخبز إلى الأسواق)
البناء المعماري
تتضمن مسرحية حرب الملوخية عشرة مشاهد، نعرض عناوينها كما يلي:
مصر مصر أبونا
جتها نيله اللي عايزة خلف
تجار مصر سرقوها
تشتري كلب
مين يشتري مصر ؟
الزمن الرديء
بني آدم يوم طالع و يوم نازل
أبو زيد حانوتي يا رجالة
المصري الجدع
تجار مصر سرقوها و خانوها ثاني و ثالث و رابع.
إن المعاينة لهذا الترتيب على مستوى مضامين كل مشهد من المشاهد، يجعلنا نقر بداية أنه ترتيب يخضع لمنطق صراع تصاعدي من مشهد لأخر، لأن هذه المعارك -حتى و إن انتهت في المشاهد التسعة لصالح الأقوياء، فإن المشهد العاشر سيكون حاسماً، إذ تنقلب الكفة لصالح المستضعفين بإحقاق الحق لأصحابه، و باللعنة على الأزمنة الرديئة التي عرفها المجتمع المصري طيلة قرون اتسمت بالظلم و التجويع.
إن أهم ما يستوقفنا و نحن نساير أحداث هذه المسرحية هو العدد عشرة. فالأمر قد يبدو منطقيا إذا اعتبرنا الحرب بدلالتها العامة عبارة عن مجموعة معارك. و كل معركة هي مرحلة من مراحل الحرب. قد تكون قصيرة، فتقل معاركها. و قد تكون طويلة فتزداد.
إن الحرب التي صورها المؤلف كانت طويلة، انسجاما مع مرحلة تاريخية عرفت فيها مصر صراعا بين مجتمع غارق في وحل الاستعباد و المجاعة، و بين حكام استبدوا و عاثوا في البلاد فساداً طال أمده. إذن فتحديد العدد في عشرة يعود بالأساس إلى طول أمد الحرب. أما المسوغ الثاني الذي يكون قد أوحى للمؤلف باختيار هذا العدد، فهو ما كون رؤيته في معارك تعد نبيلة،و تنعت إما مبارزة وإما ملاكمة وإما مصارعة. و غالباً ما تحدد بالجولات بدل المعارك.و الأمر الذي يؤكد فكرة انتقال الحقل الدلالي لكلمة جولة إلى كلمة معركة، هو ما عمد إليه المؤلف حينما أقحم على رأس كل مشهد مجموعة فتيات في زي رياضي، يحملن لافتات إيذاناً ببداية المعركة و عددها. و هذا مألوف في حلبات الرياضة النبيلة، التي غالبا ما تكون فيها الجولة العاشرة حاسمة بالضربة القاضية. و هي الضربة القاضية نفسها التي عرفتها نهاية أحداث المسرحية.
أكدنا في البداية أن أحداث المسرحية كانت محكومة بالتسلسل ومنطق الصراع التصاعدي من مشهد لآخر. والسيد حافظ لم يعتمد التقسيم الكلاسيكي لأطوار المسرحية، إذ ألغى العناوين التقليدية على غرار الفصول أو المشاهد أو اللوحات. لقد كان مباشرا في اختياره و تصنيفه لكل طور من أطوار المسرحية. فالمعارك أضحت بديلا للتصنيفات المعروفة. و لتمييز كل معركة عن الأخرى، سعى المؤلف إلى وضع عنوان مواز لكل معركة؛ بالإضافة إلى الترتيب الرقمي أو العددي لهذه المشاهد. وكانت الحدة تزداد كلما ازدادت المعارك، لأن الهاجس الذي سكن المؤلف هو إبراز تجربة الشعوب التاريخية من أجل تحقيق الانعتاق و الكرامة.
التناص في المسرحية
لقد كان التاريخ هو الإطار العام الذي سعى من خلاله المؤلف إلى تسييج نصه المسرحي، إذ انطلق من الموثق التاريخي قصد التوظيف تارة، و النبش في حقائق أغفلها التاريخ أو تم تدليسها تارة أخرى. و لعل حضور التاريخ بصفته شخصية من شخوص المسرحية خير شاهد على إثبات الحقائق و نفي الزائف منها. و لعل موقفه من ذكورية مصر أحسن دليل على أن التاريخ لم يكن دائماً يعكس حقيقة ما وقع في الماضي. وسندرك ذلك من خلال الحوار التالي :
المعارض : اسم مصر مؤنث و مش مذكر أنا متأكد ..
التاريخ : 'يفتح كتابا و الجوهري في كتاب الصحاح.. مصر اسم مذكر - و دا كتاب 'يفتح كتابا آخر' الجاحظ اسم مصر اسم مذكر.. و دا الهمداني 'يفتح كتابا آخر' مصر اسم أعجمي..و هي نسبة إلى مصر بن بنصر بن حام و هو مصريم...
فما سبق يؤكد حرص الكاتب على توظيف التاريخ مرتين :
1. التاريخ كأحداث و وقائع، وتم إبرازها من خلال توظيف شخصية المستنصر الفاطمي الذي حكم مصر في فترة من الفترات التاريخية، و ما عرفته هذه المرحلة من فساد سياسي انعكس سلباً على المجتمع المصري. ثم التاريخ كشخصية من شخوص المسرحية، يسعى للقيام بدور المراقبة الذاتية.
2. التاريخ كشخصية. و يهدف إلى تنبيه الجمهور للتاريخ يمكن أن يتعرض للزيف حتى في وقتنا الحاضر من لدن أقلام و مؤلفين مأجورين. كما أن شخصية المستنصر التاريخية تجمع بين تجليات الماضي و الحاضر في ممارسة الحكم و السلطة.فالحاكم العربي حاكم مستنسخ من الماضي، لأن أحداث اليوم لا تختلف عن أحداث الأمس. والمؤلف تأسيسا على هذه المزاوجة يحقق لنصه المسرحي و لو ذهنيا تناصا بين تجاوزات الماضي و الحاضر الراهن
الصراع الدرامي:
إن الصراع الدرامي كما بينته مجموعة من الدراسات يأخد صوراً و أشكالاً مختلفة. فقد ينزع إلى الذاتي،و الأمر هنا ينطوي على مجموعة من العوامل السيكولوجية المتفاعلة. وقد ينزع إلىالخارجي .و يمكن تقسيمه كما يلي :
العمودي/الميتافيزيقي الذي سجل حضوره بكثافة في المسرح اليوناني. و هذا النوع تحكمه علاقة الفرد بالسماء، كالإلاه أو القدر.
. الأفقي وهو الذي يواجه فيه الفرد "قوانين المجموعة و الكيان الاجتماعي المفروض". و هذا النوع من الصراع هو الذي تحكم في طبيعة العلاقة في مسرحية "حرب الملوخية". فالصراع كان واضحاً بين فئتين متناقضتين : فئة الحاكم و حاشيته من وزراء و تجار محتكرين و أمراء فساد الأمة. و فئة عامة الناس التي تتطلع إلى لقمة عيش، و تبحث عن الخبز الذي اختفى من السوق. إن الصراع اجتماعي بالأساس. فكبار التجار احتكروا منتوج القمح بإخفائه، و تحكموا في أثمنته. و طبقة الحكام باركت نزواتهم التجارية بتقمص أدوارهم في تبرير أسباب ندرة القمح، و اعتبار الكارثة طبيعية مصدرها شح النيل، و جفاف الطبيعية،و أن الأمر لا يقتصر على مصر، بل إن الأزمة عالمية :
الرجـــــــــــل1 : القمح بقى أغلى من الذهب يا مولاي الوزير،
الوزير اليازوري : مشكلة القمح مشكلة عالمية..مش مشكلة مصر لوحدها.
رجــــــــــــــــل2 : القمح اختفى يا وزير،
اليــــــــــازوري : لا القمح موجود،
رجــــــــــــــل3 : أيوه بس سعره زاد ثلاثين مرة.
إن الصراع كما أكدنا هو صراع اجتماعي، طرفا النزاع فيه : مجتمع يعاني الجوع،و فئة التجار و الحكام التي أتقنت أسلوب المراوغة و الكذب لخداع المجتمع.
الفضاء المسرحي
نتعامل مع الفضاء المسرحي على أساس أنه يتضمن "بنيتي الزمان و المكان". ففيما يخص الزمن،فإن المرجعية التاريخية ساهمت بقدر كبير في صياغة موضوع المسرحية. بل كانت أساساً انطلق منها المؤلف لبناء أحداث النص المسرحي و بلورة أفكاره. إن المؤلف لم يكن يسعى لإخبارنا بأحداث تاريخية ما دامت الأحداث التاريخية هي من اختصاص المؤرخ. بل كانت غايته من توظيف الأحداث التاريخية -التي لازمت مرحلة حكم المستنصر الحاكم الفاطمي في مصر-، هي رصد لوقائع، و إسقاط تاريخي للفساد السياسي الذي أضحى قاعدة، و ليس استثناء في حياة الشعوب العربية و حكامها.فالمؤلف و هو يستحضر مرحلة قاتمة من تاريخ الشعب المصري، إنما يسعى إلى تمرير خطابات تخص الراهن الاجتماعي و السياسي الذي تعرفه الشعوب العربية برمتها، و بخاصة ما يتعلق بحرية الشعوب و حقها في الكرامة و الديمقراطية.و نلمس ذلك بوضوع في الحوار التالي :
المستنصر : (يدخل) كفاية بقى عراك ما شبعتوش عراك عشرين سنة،
ست مصر : سمعت عن المظاهرات..يا مولاي...مظاهرات في سوق الخبازين،
المستنصر: سمعت يا عمتي سمعت،
سكيــــــة: و نزلت العسكر تضرب الناس علشان تفض المظاهرات فيها ايه،
ست مصر:الناس جيعانة و تنضرب كمان يا سكينة..يا سكينة شعب مصر مش عبيد عند الناس .
فبالإضافة إلى الزمنالأساسي في المسرحية،هناك أزمنة يمكن اعتبارها ثانوية. و هي أزمنة ارتبطت بأحداث النص .فمنها ما ارتبط بالليل، و منها ما ارتبط بالنهار. و قد عمد المؤلف إلى تحديدها ببعض الرموز الدالة.
الفضاء المكاني. و توزع بين عام و خاص. فالعام هو مصر أو القاهرة. لقد ارتبطت الأحداث بحاكم عرفه التاريخ المصري في بلاد مصر. أما الأمكنة الخاصة، فيمكن تقسيمها إلى مكانين أساسيين كانا مجرى أحداث المسرحية : قصر المستنصر، و سوق الخبازين الذي كان في الغالب مصدر صراع و اضطرابات اجتماعية. يقول المؤلف في تمهيده للمعركة الثانية :
(يتحول الديكور إلى قصر السلطان المستنصر..الديوان.)
و يقول منبهاً إلى تغيير في الديكور:
(يتغير الديكور إلى حي الخبازين..محلات متجاورة و دكان مغلق كتب عليه خان مشتاق..دكان كتب غليه خضر عريف الخبازين.)
لقد تحكم العامل السينوغرافي في الانتقال من مكان إلى آخر، بتغيير التأثيث و توزيع الإنارة. و أهم ما يمكن ملاحظته على " المكان " هو تعدده. و هذا مؤشر على وعي المؤلف بالتنظيرات التي تجاوزت التصور الأرسطي الداعي إلى وحدة المكان
اللغة المسرحية:
تعتبر اللغة من بين أهم عناصر التواصل في العمل المسرحي. وهنا سنركز على لغة النص تفاديا للحديث عن لغات أخرى قد نكتشفها بعد تفعيل النص المسرحي رُكْحِياً: أي بعد انتقاله إلى العرض، لأن عناصر التعبير في العرض تختلف عنه في النص. فهناك التعبير الملفوظ لغة،و التعبير الإيمائي الذي تجسده الملامح،إضافة إلى لغة الجسد التي لا تقل أهمية عن اللغات الأخرى وهكذا.. إذن تركيزنا على النص سيجعلنا نركز على الملفوظ اللغوي الذي اعتمده المؤلف في مسرحية "حرب الملوخية".
إن لغة النص في مجملها هي العامية المصرية. و لا نقصد باللغة، ما هو مكتوب في النص، لأن المكتوب قد يقرأ في بعض الأحيان فصيحا. و هذا ما لمسناه من خلال مجموعة من المقاطع الحوارية. و لكن الأمر قد يختلف حين ننتقل بهذا المكتوب الفصيح إلى ملفوظ عامي مصري، تحكمه مخارج الحروف و الحركات الوسطية أو النهائية .و كنموذج على ذلك، نورد بعض المقاطع الواردة في النص :
* المستنصر : (مقاطعا) كل الناس تمدحني و تمدح عصري.. اسألي كتب التاريخ
* ست مصر : كتاب أجرتهم يكتبون ما تهوى و يمنعون ما يغضبك.
كان الغرض من اعتماد العامية المصرية في هذا النص،هو تقريب الشخوص إلى الجمهور المصري، إضافة إلى تحقيق تواصل واسع مع هذا الجمهور بمختلف فئاته و مستوياته. فاعتماد المؤلف العامية لا ينفي العمق الفكري في النص، لأن التعامل مع النص من حيث اللغة يختلف من متلق إلى آخر، كل حسب العوامل الثقافية و الإدراكية التي تميزه، و التأويل الذي يمكن أن يصل إليه.
السينوغرافيا:
بداية لا ندعي أننا سوف نحقق إلماماً كلياً بالجانب السينوغرافي في هذا العمل، رغم الدعم الذي قدمه لنا المؤلف عَبْرَ إرشاداته المسرحية . فالإلمام بالجانب السينوغرافي يقتضيه الانتقال من النص الأدبي إلى نص يتحول عرضا . لذا نجد أنفسنا مضطرين إلى ركوب فكرة التوقع بدل اليقين. و نؤكد في سياق هذه التوطئة أننا نعرض هنا لعينات من التصور السينوغرافي، و لا ندعي أننا نتناولها في كل تجلياتها.
إن النص الذي نحن بصدده لم يكتب بمقصدية القراءة فقط، بل كُتب لِمَسْرَحَتِهِ وتفعيله إلى عرض قابل للمشاهدة. و دليلنا في ذلك هو حضور مجموعة من الإرشادات المسرحية التي تفيدنا في بلورة تصور للجانب السينوغرافي في هذا العمل. لقد وجهنا المؤلف منذ البداية ببعض مقترحاته التي من خلالها يمكننا وضع تمهيد للعرض المسرحي.
يرشدنا المؤلف قائلاً :
(تظهرعلىالمسرح شاشة تلفزيونية كبيرة) (موسيقى نشرة الأخبار) (في حالة عدم وجود شاشة تظهر مُذيعة "ممثلة" في إطار خشبي).
هكذا إذن نتلمس الجانب السينوغرافي منذ البداية. فالمؤلف انطلاقاً من هذا التوجيه يجعلنا نتوقع،أهم المكونات السينوغرافية التي تخص المشهد الأول ،سواء تعلق الأمر بالصوت أم الموسيقى أم الإنارة التي نتوقعها دائريةو موجهة، إضافة إلى التأثيث الذي هو عبارة عن شاشة تلفزيونية كبيرة أو إطار خشبي.
إذن الصوت هو صوت امرأة يعتمد طريقة إلقاء تحددها طبيعة الإلقاء الإذاعى.و الموسيقى لا تخرج عمَّا يلزم النشرات الإخبارية. أمَّا الإنارة فنتوقعها كما أسلفنا مركزة على الشاشة أو الإطار.وهي غالبا ما يتوسطا الخشبة. أما باقي المواقع على الخشبة فسيغمرها الإظلام.
ومن بين الإرشادات الأخرى التي لا تخلو من أهمية على المستوى السينوغرافي، حديث المؤلف عن تغيير في الديكور :
(يتحول الديكور إلى قصر السلطان المستنصر.. الديوان).
وهنا سنركز على كلمة ''يتحول'' التي تعني بالأساس وقوع تغير و انتقال من مشهد إلى آخر. و تُفضي كلمة ''يتحول'' أيضا إلى أمرين اثنين: الأول يكون إظلاما سبق المشهد، أوإغلاقا للستار قبل تغيير الديكور. و في الحالتين معا تتاح الفرصة للمخرج و الممثلين للتصرف في هذا الفضاء.
إن التحولات السينوغرافية في هذا العمل لم تكن معقدة، لأن المؤلف عمد في أكثر من مقام إلى بعض الاختيارات التي تسهل على المخرج ضبط كل الجوانب السينوغرافية المعتمدة. فالكورال مثلا يعتبر من المداخل المهمة لبعض المشاهد. و حضوره يقتضي الحضور السينوغرافي، لأن الاستعراض الغنائي الراقص يحتاج إلى مؤثرات جمالية إضافية كالإيقاع الموسيقي و الإنارة المناسبة.
ويمكن كذلك تقسيم الإرشادات المسرحية المرتبطة بالجانب السينوغرافية في مسرحية ''حرب الملوخية'' إلى نوعين :
1. نوع اتسع حجمه و تصدر في الغالب بداية كل مشهد أو معركة و قد سعى المؤلف من خلاله إلى تأطير المشهد على مستوى الإنارة و التأثيث، يقول :
يفتح الستار أو تضيء الأنوار و تدخل الفتيات تحملن في أيديهن لوحات كتب عليها ''المعركة العاشرة ...' و لوحات كتب عليها عنوان ''تجار مصر سرقوها ثاني و ثالث و رابع''
ديكور ساحة المدينة : ستار بيضاء في الخلفي .. و يقف التجار الثلاثة برهومة و الشو و سنارة.. و يدخل منادي المزاد، و يقف عامة الناس يحملون في أيديهم صكوك تثبت ملكيتهم لبيوتهم و أراضيهم
2. و هناك نوع ثان من الإرشادات. و يمكن اعتباره جزئيا. و غالبا ما تخلل بعض الحوارات داخل المشهد الواحد. و من ذلك قول المخرج :
"يالا يا ابني انت وهو" (ضوء و عمال و استعراض.
كل هذه المؤشرات الجمالية تترجم إلى حد معين ولع الكاتب بالبعد المشهدي للنص الذي كتبه. إنه يمارس عملية اختراق اللغة باللغة ليؤسس المشهدومن ثم يقحم القارئ في عملية تلق جمالية لا فكرية محددة فقط .
خلاصــــــة
تعتبر مسرحية "حرب الملوخية" من بين الأعمال التي تعتبر رائدة و جريئة. و هي تفصح عن الموقع الذي يحتله السيد حافظ في مجال المسرح تنظيراً و إبداعاً. و نحن بتحليلنا لبعض جوانب هذه المسرحية لا ندعي المقاربة الشاملة لها، لأن ثراء هذا النص يستدعي مزيداً من البحث و التحليل.و لقد فضلنا تفادي المجازفة بتحليل كل مكوناتها. و لكننا بالمقابل نؤكد أن قراءة نصوص السيد حافظ لا بد و أن تتم في سياق مقاربة شاملة .
إن قراءة نص واحد من جملة مجموعة من النصوص هي عملية بتر غير ممنهج للتجربة الإبداعية عند هذا الكاتب.و عذرنا في هذا أننا عملنا بالأساس على استجلاء بعض مكونات الخطاب المسرحي. ويبقى النص بحاجة إلى الكثير من الإضاءات النقدية نظرا لما يتوفر عليه من غنى و إيحاء .