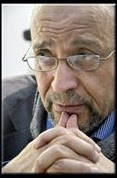السيد حافظ ومرآة جيلى
أحمد غانـم – الكويت
ملحق البيان الثقافى
عرفت السيد حافظ عندما توهجت رؤوسنا وهى تصطدم – بمستطيل – النكسة وهو مستطيل أسود مستن يخالف فى الشكل والمضمون مستطيل كيوبرسك (أوديسا الفضاء) لقد دشن ميلادنا فى لحظة الذبح، والتقينا فى ابهاء وأزوقة دار العلوم الخشبية، كطيور النورس المذبوحة، كان السيد حافظ طالباً يتمتع بتمرده ، وكان الوقت – بالنسبة إليه – هو الفصل الختامى فى رحلة قلقة الجامعى بين كليات التربية اسكندرية و... و... وكنت فى العام 1969 مشرفاً فنياً للنشاط التشكيلى بالكلية. وكان اللقاء حميماً بين خريج كلية فنية ممثلى – الطلاب أقرب إليه من حبل الوريد – وبعد أن مارسوا – الذبح الوظيفى – عليه ، يتمرد ع لى طقوس الوظيفة فى مدينة النكسة التى ينخرها السوس. كنت هذا الذى هو إنسان أولاً وفنان ثانياً ولا موظف ثلثاً.
فقد كنت أقول – إننى موظف فى اللاوظيفة أو – إنها وظائف اعتمدت فى الوقت الضائع البوار من الأمة – كان السيد حافظ ابناً لمدينة ونبتاً للأسكندرية وشقيقاً لقاص سريالى رائع – محمد حافظ رجب – اصطدم رأسه – الكرة – بالجدار المسنن ، وصار رأسه رأسين وثلاثة وزيادة. وكنت ابناً للريف (مسقط رأسى البحيرة ) وزرعاً لمدينة ريفية صناعية (المحلة الكبرى) .
كانت المدينة الكوزموبولاتانية بالنسبة إلى متاهة تحتاج حلاً. وكانت المدينة بالنسبة إليه أوراقاً كرتونية بل أوراق – نرجسية - بائسة سافرة كان تمردى تمرداً استيطانياً طويلا، ومحاورات مع صديق اختزلت فيه العمر والأمة (فاروق عبد العزيز) وكان تمرده صراخاً ومبالغة محببة. وكان – وكأنه – لابد وأن نلتقى النفى جيلنا على مقولة شهيرة – نحن جيل بلا أساتذة – وبدأ جيلنا يكتب وهو أعجب الأجيال فى تاريخ الأمة المصرية (وهذا ما أوكد أن الأيام يتثبته) فجيلنا ليس ابناً محضاً لثورة 23 يوليو. لقد تشمم جيلنا رائحة أساتذة الأربعينات كان أحدنا أو الأخر قد تأثر بعمق بالآثار الأدبية الرائعة لطه حسين أو توفيق الحكيم أو عباس محمود العقاد أو سلامة موسى.
غير أن التيار وهو يجذر بنا ويمد ويجزر قد أخذنا إلى بعيد،، كانت التحديات الفوارة أكثر ضراوة من ضراوة طروادة هذه الذكرى.
ولقد ولد جيلنا فى عاصفة فصرخته الأولى كانت قنبلة هيروشيما، وقسمة كان – النكبة – وحجلة كان ثورة 23 يوليو وفى لحظة الميلاد الحقيقة لأى جيل (التخرج) اكتشفنا أننا أوراق خريف تخرقها البرودة وتذروها الرياح.
نحن الأحلام الطائلة لجيلين (الرواد / وجيل الوسط) وقالوا : صرح بدون صوت، فالحبل والمشنقة فى رقبتك، احكمت دائرة الحبل على العنق باسم الثورة والنكسة والمعتقلات ونضال الأمة، وامتد الحبل طويلاً باسم – النفط – وبدأ المسلسل الأوسد : مسلسل الكآبة: نفط بطعم الحنظل، ومدائن يحكمها العسكر ويتركون أبوابها ومرانعها ورمالها تحت نجمة اسرائيل التى تتسيد النجوم الأمريكية.
وبدأنا نكتب ونرسم، وكأننا نمارس الطقوس الوثنية للحرية، وجاءت كتابتنا – شفرية – الأدب والخيال والتاريخ البعيد واللاوعى. تقرأ فيصيبك الدوار أو الخبال. المهم أن تكتب لغة لا يدركها قلم الرقيب ومقصه. وهكذا ولد الغموض شرعياًتحت مقارع النكسة.
كان كل شئ فضفاضاً واسعاً، غامضاً ووهمياً : التاريخ والذكر والفاجعة والأنا والمستقبل : ما تعلمناه وما لم نتعلمه. وما لن نتعلمه. كان السيد حافظ يملك تلك الجرأة التى يملكها ابن المدن الكبيرة، والذى تعلم مع الحجل كيف يتشعبط على أبواب الترام والتروللى والباص. يلج مكاتب – الكبار – بركلة من قدمه. وكنت كريفى يحيا ليلته الأولى فى مدينة لا تحسن استقبال أحد.. ويتساءل: لماذا ؟ وكيف؟ والى أين؟؟ وتشكل جيلنا بين جزئيتى ذرته (السالب/ والموجب) بين جبال الاستبطان الشامخة وبين قعقعة الأحجار المتصايحة وهى تدك أشياء المدن. بين الحزن والسخرية. وكانت الدائرة، وبدأ الجوهر واحداً وواعداً. والنقطة المركيزة للحدث واضحة. والتقى الفريقان على لغة رومانسية ثورية : لغة هياج مصطرخ كان يكتب إلينا السيد حافظ اسم أوزوريس اهداءات كتبه هكذا : إلى الأخضر، إلى النورس ، إلى ضياء الماء، وماء الضوء، إلى البنفسج، إلى الطاقة .
واقتحم السيد حافظ مع الطلب والطالبات مخزناً مغلقاً به الكراسى والمناضد والدواليب التى نريدها لمرسمنا، وأقمناه فى الدور الأول الذى قيل أنه آيل للسقوط ولم يخش – أحدنا – شيئاً من سقوط المبانى، كانت ألفتنا عجيبة لهذا المبنى وكنا حجرة وحيدة، تطل على صحن دار العلوم حيث يلمع تمثال نصفى أبيض لمؤسسها – على مبارك – باشا وكنا نشعر بالألفة العميقة مع هذه الأعمد من الأخشاب النابتة من قلب قرن مضى، وحيث يتساقط دهانها وكأنه لحاء لأشجار عجوز – مع الأطلال – أن نستمع إلى ترددات أصوات المحاضرين عبر مائة عام والى سكون الليل، والى شقشق الضوء فى رواق إسلامى والى جابة الطلاب بين الأعمد، والى مرائى المظاهرات الوطنية التى خرجت من دار العلوم إلى قلب القاهرة عبر السنين.
وحاول السيد حافظ أن يمارس الرسم، ولجأت إلى الرسم به. فلوحتى – الخوذة والشهيد – تحمل بصمات قدمه وبيده كنا رمزيين وتجريديين ، رافضين وباحثين عن واقع آخر، وكنا تعبيريين وحوشيين ووحشيين ومجربين. وكنا نمضى الوقت فى هذه الأنحاء إلى منتصف الليل. وكانوا فى الصباح يسألوننى عن تأخير خمس دقائق من الحضور الوظيفى.
كنت أمارس فى قلب الدوام رحلتين مقدستين إحداها باتجاه الجنوب – عابراً الحى الراقى جاردن سيتى النيل ، اسكب العيون فى أبها، أمواهه وأصواءه، ثانيها إننى أعتلى ظهر مقعد حجرى رطب وثانيتهما باتجاه الشمال إلى قلب ميدان التحرير إلى شارع شمبليون اسمع الموسيقى الكلاسيكية مع رفقة أخرى منهيا العرض دائماً – بالدانوب الأزرق.
وكان السيد حافظ يختفى فى نفس الوقت باتجاه الجنوب إلى روز اليوسف وباتجاه الشمال إلى دار الهلال يقرع أذان- الأسماء 0 بصراخه المشروخ روعة.
وبدأت رحلتى مع مسرحية – حدث كما لم يحدث أى حدث – ولم يكن هناك أوضح – فى لغتنا – من هذا العنوان، فالذى حدث هو أنه لم يحدث أى حدث ، وهذا وحده يكفى تبيانا لموقف .. كنت فى هذه السنوات قادراً على أن اتناول هذه اللامعقولية فى الفن كصرخة احتجاج جيل. وكان فى هذا السيد حافظ لا يبارى. ولقد اتممنا دراسة هذا العمل واحتشدنا لديكور مسرحى فيه لوحة مصممة فى أن نرسم بالقلم الجاف الأسود على مساحة 2,5متر. (ولك أن تقدر حجم هذه الطاقة الانفعالية التى كنت نمتلكها)
فلم نكن نلعب . ووقت البيروقراطية كانت نكبة فى جيل كامل بكل فرقة (الموظفين والعسكر والبيروقراطية والدكاترة ضدنا) وكلهم ينظر إلينا وكأننا نتاج كوكب منفصل لا أحد يريد لنا المشاركة بشئ.
تحول السيد حافظ إلى الاسكندرية وبدأت مراسلاتنا ما بين – عزبة دومور – التى بالكاد أدركت فيها شقة متواضعة من ثلاث غرف فى حجم علبة السردين (الغرفة 2,5 × 2,5 متر)وكان الحصول عليها معجزة بمقدم ومؤخر وصداق ونفقة متع ونفقة حضانة وفى النهاية دخلنا فى طاعتها، وما بين مكسنه الذى لم أراه حتى اليوم ، وكان عنوان، أيضاً بالنسبة إلينا عنوناً شفوياً : محرم بك خلف نمره 16.
أخذتنا سفينة الرخ إلى مدينة الكويت وحتى تكون القاهرة ومصر كبيضة فى راحة اليد على استقامتها. وكانت البيضة ما تزال تفرخ أفراخها المذبوحين. وانقطعت أخبار السيد حافظ عنا. واكتشفت المرء عند لحظة الاصطدام الأولى: كم هى وهمية تلك المدن الذهبية. وأننا أخطأنا العنوان : خلف نمرة مدينة الذهب – لقد غلبتنا شقاوتنا وبدأ فى الكويت لنا تحصيل ثقافى فذ وكبير، ونعتز به تلك كانت طبيعتنا: أن نفرخ ثقافة ولا نفرخ دنانير.. وتذكرت أننى فى مشاهداتى الضحاوية (نسبة إلى الضحى) قد امتلأت بدنانير النيل، وحيث تلمع أضواء الأسماء الفضية على سطحه الأزلى. وكان فضل الكويت علينا أن أدركنا الإدراك الكلى صحوباً بإدراك جزئى. هنا كانت رحلة تطبيق الدنانير. لماذا ؟ والتعليم : لماذا؟ والطباعة : لماذا ؟ ومصر : لماذا ؟ والفلسطينيون: لماذا ؟ وعرب النفط: لماذا؟ والسينما : لماذا ؟ والتصميم : لماذا ؟ والسياسة : لماذا ؟ والعسكر : لماذا ؟ والفرد : لماذا ؟ والجماع : لماذا ؟ وآه من هذه اللماذا ؟
بدأنا رحلة التخصص والتطبيق الميدانى الشاق ، الوعر، هنا.. هنا إمكانية ما لتطبيق ما. ومعمل اختبار للأمة العربية كلها. وفى مصر إذا كانوا قد استولدوك ابناً لهم بخساً، فإنهم هنا قد اشتروك بخساً وتظل قيمتك حائرة. هذا الجيل الراحل بلا نظرية ابداً لن يعود إلى ثكناته الريفية إلا بنظري . والنظرية معرفة بالأصول والفروع ، بالكليات والتفاصيل . والفلاح يعرف لا يكف يزرع الطين بل كيف يزرع الرمل والماء بل الأفكار والأحلام والمشاعر. الفلاح الحقيقى هو المثقف الذى عاد يدرك أن الأرض كلها ليست سوى تربته الداخلية: قلبه. وفى قلبك يتكون العالم – خلال رحلة المتاهة العربية – لا لا هالة وهمية بل جداراً جداراً ولبنة فلبنة.
وفى ذات ضحى صيفى صحراوى قائظ، قابلنا (أنا وفاروق) السيد حافظ فى مدينة الذهب. كان فى أعناقنا طوق عمل لـ22 ساعة يومياً. وفاءاً بوعد لصاحب شركة اعلانية. لكنه خلع بعد تمام العمل صوت الرجل إلى صوت الذئاب وكان للسيد حافظ يبحث ظامئاً عن قطرة ماء. كان كلانا مقيداً – وما يزال – إلى عجلة النار والتجربة. ولم نملك أن نعطيه سوى أعمق الأمنية والسلام.. كان القلب منا يتقطع وهو يسكن فى حرجة 6 × 6 متر بها اثنتى عشر سريراً صعيدياً . وكان قد أتى ومعه لفائف نشرة ورسائله وبعض أعماله ، وفى لحظة إنسانية – أقدرها – لحظة امتعاض مزق خطابات – منطقة دولار – إلى منطقة خلف نمرة 16 – وبهدوء سحبت منه عدة خطابات كان آسفاً وكنت مشرفاً على هذا الأسف بعشق لاضحياتنا القاهرية والنفطية.
ومن مجلة – صوت الخليج – إلى المجلس الوطنى للأداب والفنون – بدأ السيد حافظ يتعيث طريقه ويتوازن وكنت فى هذه الفترة أحمل ما بين القاهرة – الكويت وبالعكس الكتب والرسوم الثقيلة، لا أدرى كيف أو أين تسكن، وبدأ عذاباً كعذاب سيزيف وصرحته. قمة الجبل تنكر عليك الصعود . وبطنه ينكر عليك النزول والعود ليس بأحمد. وامتلأ جسدنا، وتضخم الصوت وعرفنا طعم الفاليوم، واتخذ السيد حافظ ثمة المهاجم فى حديثه يا أولاد كذا وكان فى هذا الصراخ – السبعينى أنقى قلباً وأصفى من الأطفال. هنا بدأ يتعلم الهجوم.. ليس على كتاب أرصفة القاهرة، بل على الجنس العربى كله.
وبدأنا – ننجح – والعارف لا يعرف . وظلت للسيد حافظ لغته المسرحية الفضفاة واكتشفت إننى صرت صاحب ذوق محافظ خاصة فى غير الفن الذى امتهته هل هى المعرفة بالتخصص والتفاصيل أم أن المعارك صارت على جبهات تخصصية شتى ؟
وفى العام 1983 طلبنى السيد حافظ لأصمم له ديكور أول مسرحية يكتبها للأطفال – سندريلا – والتى تعاقد عليها مع مؤسسة البدر . قرأت المسرحية فأسعدنى جمالها وإشراقها ، بساطتها ومغزاها.
وبدت النهاية فيها فى قوة وجمال – لحظة التنوير – فى القصر القصيرة . هل يأس ا لسيد حافظ من عالم الكبار فلجأ إلى الأطفال ؟ ! واكتشفت فيها أن ذلك الشاب الذى مازال يتحدث بلغة المطلقات والرموز. وهذا القلب الغوار بالمحبة قد وجد فى نهاية المطاف أين يضع موهبته؟ ولمن يقدمها ؟!
كنت سعيداً بهذا الاكتشاف واكراماً للسيد حافظ اعددت تصوراً للديكور. واعدت تدارك ما انكمش فى الذاكرة من المنظور المسرحى الخ... التقيت المخرج والمنتج وعرضت عليهم تصورى. وكنت ألمس فى شبح السيد حافظ حزناً لم أره فيه من قبل قط.. بلى وبأساً من المواجهة. لقد اختفى أمام ناظرى.. ولم أعد ألقاه.. وكانت مفاجأة لى أن المخرج والمنتج قد استبدلا – لحظة التنوير – بلحظة تعتيم لا تضفى على المسرحية ناراً بل تجعلها هشيماً . لقد أبدلا النهاية إبدالاً.. تحت دعوى إنها نهاية.. تراجيدية ، وأنهم قدموا من قبل ثلاث مسرحيات أو أربع بنهايات حزينة..!!!
فى نهاية مسرحية – سندريلا – السيد حافظ جعل الشرطى الذى يقيش حذاء سندريلا يصرخ : الحذاء ليس حذاؤها.
وسندريلا تصرخ : إنه حذائى . ومن يصدق سندريلا ؟! وبهذه النهاية – وهى إضافة لها قيمة – يكون هنالك مبرر درامى لفهم موقف الوزير الذى يرفض من البداية هذا الزواج ويكون هنالك إثارة حقيقية للأطفال نحو فهم العلاقات الاجتماعية فى عصرهم وصراعاتهم.
وبتغيير هذه النهاية إلى النهاية التقليدية صارت مسرحية السيد حافظ بلا معنى. ولقد حملت تصوراً رمزياً وتجريدياً وعملياً للديكور يخالف تصورات المخرج. فانسحبت من العمل.. ولم يكن السيد حافظ بقادر فى كآبة نفسه المفاجئة أن يصرخ.. ولأول مرة أرى السيد حافظ استبطانياً..
وفوجئت بالهجوم المنظم والمخطط والذى يستعدى العامة على السيد حافظ محملاً إياه ما قاله كاتب فى مصر أن السيد حافظ يطور مسرح الأطفال فى الكويت – وكأنها سبة أو جريمة يقتضى عقابها؟! وهذا السيد المحرر الذى كتب واستكتب غيره طعناً فى السيد حافظ ومسرحه لم يعتنى أن يشير إليه .. هذا الذى يأكل كلمة ابداعات أمثال السيد حافظ.. ويفرد ضد مسرحه الأعمد الطوال العراض لا يشير إلى من يطعنه ...
وهكذا تمت الدائرة، تولد فى أنظمة العروبة فى غفلة من التاريخ والزمن. تنسانا عند المواقف، تبتزنا بكل اسم، وتطعننا دون أن تشير إلى اسمنا.
المهزلة كاملة، هى رحلة السيد حافظ ولأن الناقد، والنقاد تخلوا عن دورهم الرشيد البناء. فقد تمزعت فى أنفس كآبة السيد حافظ الظلال كلها، فاتخذ من الأطفال فى مسرحيته التالية – الشاطر حسن – حفل اختبار للغته الفضفاضة الواسعة التائهة.. وكانت تلك جريمة النقاد بأكثر مما هى مسؤوليته. لقد خالفت تصوره المعذب المشتت .. المشتت هذا.. وارباً به أن يعود إلى سندريلا قاموساً له.. بكلام الأطفال بهذه اللغة البسيطة المشرقة ويعيد سرد حكاوينا القديمة بمرآته العصري البسيطة. لا استعراض فى الفن. ولا لغة فضفاضة ومتشتتة ستعيش للزمن. أملنا فى السيد حافظ أن يخاطب الطفل بحنو قلبه ببساطة الكلمة، وعمق مراييه وشروخات عصره. ستبرز من بين يديه كإشراقة يوم جديد.
ليس حديثى حديث ناقد.. فلست بناقد مسرحى.. إنما هو حديث نتاج رحلة واحدة. ركب فيها السيد حافظ بساط المسرح الذى هو ساحر وأنا مسحور به (هذا البساط) وركبت متون جبال المستحيل بين الضوء والطمى. ولا استطيع الحديث عن السيد حافظ دون أن اتحدث عن نفسى، فهذا الحوار بين أفراد جيلنا صلة لا نستطيه منها فكاكاً، نحن المقيدون فى عجلة النار العربية، نستطيه أن نتخاطب.. أن نتهاتف ، أن نتحاور، حتى ولو عددت الكلمات فى عصرنا العربى كل معانيها حتى ولو كان الصمت حبلاً وطرقاً وأنشوطة عذت.
احمد غانم
الكويت 5 مارس 1985